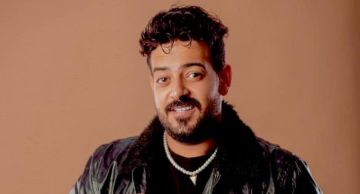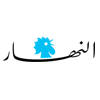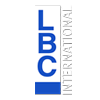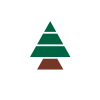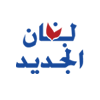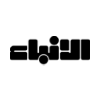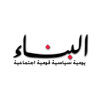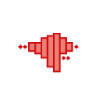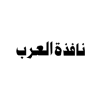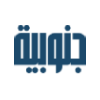اخبار لبنان
موقع كل يوم -جنوبية
نشر بتاريخ: ٨ شباط ٢٠٢٥
أن نعتبر عهد جوزاف عون جديداً ومختلفاً، وفق ما عبَّر عنه في قسَمِه، يعني منطقياً أن هذا العهد ليس استمرارية لما سبق من عهود، ولا تكراراً لتشكيلات حكومية سابقة، كانت تتعثر في مسارها وصناعتها للقرار، ومرتهنة لحسابات خاصة ملوثة في أكثر صورها بالفساد. أي أن يكون عهداً، يقطع مع ما سبقه من عهود وممارسات سياسية، وتوزيع موارد سلطة، ويكون قادراً على رسم مشهد سياسي جديد ومبتكر، ونمط حكم يبث الروح في الدولة، ويمنحها الاقتدار على استعادة مهامها، ووظائفها المنسية حيناً، والمنتهكة حينا آخر، فضلا عن قدرة وقوة دفع ذاتيتين لتحقيق الإصلاح والنهضة المأمولة، لوطن مدمر ومنهار.
هذا ما توقعناه كلبنانيين، وما نزال من العهد الجديد. فبصمته الجديدة والمختلفة التي نترقبها، ليست في ممارسة الحكم والسياسة، وفق قواعد اللعبة السابقة، التي ترسخت لعقود، وتحولت إلى عرف راسخ، وعادة مستقرة في ممارسة السلطة، بات من المستحيل تجاوزها أو الخروج عليها. وإنما تكون الجدّة في وضع قواعد لعبة مختلفة: تستعيد الحياة الديمقراطية المفتقدة، تخلق حيوية سياسية منتجة، لا سياسة تقوم على التعطيل، تضخ دماء وطاقات جديدة في المشهد العام، بديلا عن المشهد الحالي المحنط والعفن، تمارس سياسيات تحكمها اعتبارات المصلحة العامة، لا لعبة الحصص والحسابات الشخصية، والأهم من ذلك، العودة الصارمة إلى الدستور، مرجعية حصرية وفعلية في إدارة الحياة العامة.
موانع العودة للدستور
لا نبالغ القول هنا، أن أهم موانع العودة إلى الدستور، هو ترسخ عرف سياسي ملتوٍّ، شكّل على مدى عقود دستوراً رديفاً، يعكس قوى الامر الواقع، ويتناقض مع أبسط شروط الحكم السويّ. هذ العرف، استند إلى تفسيرات استنسابية ومشوّهة للدستور، وتتنافى مع روحه وثوابته، وبات مع تكرار ممارسته، بمثابة قاعدة أصلية بعدما كانت ثانوية، وثابتة بعدما كانت مؤقتة، ليصبح هو المرجعية في ممارسة السلطة وتوزيع الموارد، بدلا من النص الدستوري نفسه. وهو ما حصل زمن الوصاية السورية، وحصل أيضاً حين فرضت قوى الأمر الواقع، فائض قوتها على ترسيخ عرف سياسي يكون بمثابة دستور رديف غير مكتوب، وغايته ترسيخ قواعد، لعبة تعكس موازين القوى وسلطات الأمر الواقع.
أهم موانع العودة إلى الدستور، هو ترسخ عرف سياسي ملتوٍّ، شكّل على مدى عقود دستوراً رديفاً، يعكس قوى الامر الواقع، ويتناقض مع أبسط شروط الحكم السويّ.
ولعل أردأ تفسيرات الدستور وأخطرها، هو تلبيس الميثاقية التي نصّ عليها الدستور بالطائفة، ما يمنح الأحزاب السياسية سلطة الوصاية على طوائفها، وفق النص الوارد في مقدمة الدستور: “لا شرعية لأية سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”. هذا التفسير سوّغ للكتل النيابية من لون طائفي واحد، حق تسمية وزراء الطائفة التي ينتمون إليها داخل الحكومة، وكان ذريعة للمحاصصة والزبائنية والحسابات الشخصية والحزبية، ومثار توتير عصبوي وطائفي.
في حين أن ميثاقية العيش المشترك وردت في مقدمة الدستور، بصفتها مبدأ أساسياً لتماسك المجتمع واستقراره، ويحيل إلى مبدئي المساواة والعدالة في إدارة الحكم واتخاذ القرار. وهذا لا يقتصر على مراعاة المكونات الطائفية في المجتمع اللبناني، بل يشمل إنصاف جميع المناطق، ذات التواجد المختلط بين الطوائف، ويشمل أيضاً الطبقات والتصنيفات الاجتماعية. بالتالي هو نصٌّ يعبر عن مبدأ جوهري، في النظام اللبناني لممارسة الحكم والسلطة، غرضه خلق واقع اجتماعي مستقرّ، على قاعدة من المساواة والعدالة. وهما مبدآن لا يعنيان ولا يستلزمان إدارة الحياة السياسية، بذهنية واعتبارات طائفية خالصة.
وصاية الطوائف
يمكن القول، أن ادعاء تمثيل سياسي أو قانوني أو رسمي، لطائفة معينة من أية جهة، هو نوع وصاية مبطنة عليها من جهة، ونقض لميثاقية العيش المشترك من جهة أخرى. كونه سلوك يتعامل مع المصلحة العامة، حصصاً قابلة للتوزيع، وإلى سلطة دولة منقسمة على نفسها، وإلى إرادة مجتمعية مجزأة غير موحدة، وإلى مجتمع مؤلف من مكونات مقفلة، وغير متجانسة في ثقافتها وعاداتها وقيمها، لكل منها مصالحها الخاصة ومصائرها المنفصلة والمستقلة وغير المتداخلة.
يؤيد ما ذكرناه أمران: أولهما أن الدستور اللبناني، نصّ على أن 'عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه'. ما يعني أن النائب لا يعود يحمل صفته الدينية أو الطائفية بعد انتخابه، بل يحمل صفة سياسية خالصة وتمثيل شعبي خال من أي اعتبار طائفي أو ديني. بالتالي لا يمكنه التكلم إلا بالنيابة عن المجتمع اللبناني كله لا طائفة معينة، أو شريحة من هذا المجتمع بصفتهم لبنانيين فقط.
ثانيهما، أن النائب هو نائب عن منطقة تضم طوائف متعددة لا طائفة معينة، وأن الأصوات التي جاءت به إلى المجلس النيابي، هي مزيج من أصوات جميع الطوائف، أو أكثرها في هذه المنطقة. بل قد تجد مقترعين من طائفة معينة، لا يوجد مقعد نيابي من طائفتهم في منطقة معينة، فينتخبون نواباً من طائفة أخرى يمثلونهم. مثلما هو حال الشيعة في منطقة جزين ومنطقة صيدا، وحال المسيحيين في منطقتي صيدا وصور وبنت جبيل والنبطية. ما يعني أن الذي يمثل شيعة قضاء جزين هم مسيحيون، وأن الذي يمثل مسيحيي صور وصيدا هم مسلمون، وهكذا. ما يدل على أن الكتل النيابية لا تمثل طوائفها، بل تمثل حجماً تمثيلياً لعدد مختلط من مقترعين، ينتمون إلى طوائف متعددة.
الشرط الوحيد الذي يخوّل نائب أو حزب أو كتلة نيابية تمثيل طوائفها والتحدث بإسمها، هو حين يُعتمد قانون انتخاب ينتخب فيه أفراد كل طائفة مرشحين من طائفتهم حصراً، وهو ما عرف بالقانون الارثوذكسي. وهو قانون تم اقتراحه ورُفِض بالإجماع من جميع مكونات المجتمع اللبناني، كونه يرسّخ الذهنية الطائفية وينميها. ومع رفض هكذا قانون، فإن ادعاء النطق بإسم طائفة، أو احتكار النطق بإسمها، يكون مناف لنص الدستور وروحيته.
هذا يفسر تمييز الدستور بين خلفية النائب الطائفية وبين صفته التمثيلية. الأولى تحددها شروط الولادة، والثانية تحددها أصوات المقترعين التي تكون عادة، مزيج أصوات من عدة طوائف. بالتالي لا يملك النائب صلاحية تمثيل طائفته، لكونه حصَّل نيابته بأصوات مقترعين، من طوائف متعددة في منطقة معينة. ما يعني أن توزيع المقاعد هو طائفي لغرض إنصاف مكونات المجتمع وترسيخ العدالة الاجتماعية، أما التمثيل فمناطقي وسياسي خالص. الأمر الذي يسمح بتشكل كتل نيابية، مكونة من نواب ينتمون إلى طوائف متعددة، تكون قوتها في حجم تمثيلها الشعبي لا الطائفي، بل تكون الكتل ذات التكوين الطائفي الخالص، أمراً شاذاً ومنافٍ لحقيقة التمثيل النيابي وأصول الحياة الديمقراطية.
نص الدستور على حصر الاستشارة في تأليف الحكومة بالنواب، بصفتهم ممثلي الأمة اللبنانية، لا بصفتهم ممثلي طوائفهم، أي بصفتهم ذوي أوزان شعبية لا أوزان طائفية
لذلك، فقد نص الدستور على حصر الاستشارة في تأليف الحكومة بالنواب، بصفتهم ممثلي الأمة اللبنانية، لا بصفتهم ممثلي طوائفهم، أي بصفتهم ذوي أوزان شعبية لا أوزان طائفية. ولم يذكر أو يُلزِم بأية استشارة لممثلي أية طائفة. ما يدل على أن مسار الحكومة وتأليفها يجب أن يكون على قاعدة سياسية، تراعي إلى جانب الاعتبارات الفنية والعملية، من كفاءة وتجانس وتناغم، حجم التمثيل الشعبي للكتل النيابية، لا بصفتها ممثلة لطائفة أو ملة معينة.
بين الطائفة والشعب
هذا يجعلنا نفهم، الفارق الذي نصّ عليه الدستور بين الطائفة وبين الشعب. الطائفة حقيقة اجتماعية لا تتسم بالعموم، بل هي مكوّن جزئي، داخل كيان اجتماعي أوسع، يقبل في داخله التعدد والتنوع والتبعثر، وهي ذات تضامن عضوي أو إرادي خاص، تعبر عن مساحة الفرد الخاصة، في حريته وخياراته الحياتية الخاصة، يتوقع من النظام السياسي احترامها، طالما أنها لا تضر بالغير أو بالصالح العام. أما الشعب فهو ليس مجموع الطوائف بل كيان عابر للطوائف، ووحدة سياسية لا تقبل التجزئة وغير قابلة للقسمة، ولا تكون إرادة هذا الشعب مجموع إرادات الطوائف، بل الإرادة العامة التي تكشف عنها عملية الإنتخاب الديمقراطي. أي يكشف عنها الموقف والميول والتحالفات السياسية لا الطائفية. ولهذا منح الدستور الطائفة، حق احترام خصوصياتها الثقافية وممارساتها الدينية، من معتقدات وشعائر، لكنه لم يمنحها أية صفة سياسية، أو سيادة خاصة بها مستقلة عن الدولة. أما الشعب الذي هو حقيقة تضامنية وسياسية خالصة، فقد منحه الدستور سيادة كاملة، وجعله مصدر السلطات كلها، وفق مقدمة الدستور: 'الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية'.
منح الدستور الطائفة، حق احترام خصوصياتها الثقافية وممارساتها الدينية، من معتقدات وشعائر، لكنه لم يمنحها أية صفة سياسية، أو سيادة خاصة بها مستقلة عن الدولة
هذا ما جعل الدستور اللبناني، يراعي أمرين مختلفين في الوظيفة والطبيعة، لكنهما يتكاملان في تحقيق غرض موحد: أولهما التوزيع العادل للمجالس النيابية بين الطوائف، والثاني تسيير الحياة العامة على قاعدة سياسية كليّة لا تتجزأ. الأمر الأول غرضه تحقيق عدالة تمثيل، ورفع كل أنواع الغبن عن كل مكونات المجتمع، إضافة إلى تحقيق الشراكة الكاملة لجميع هذه المكونات. هو مبدأ ذو طبيعة اجتماعية، لترسيخ العدالة الإجتماعية وحرية الضمير، اللذين يضمنان الانسجام والتناغم والاستقرار في المجتمع. أما الثاني فهو ذو طبيعة سياسية خالصة تحكمه اعتبارات المصلحة العامة وسيادة الشعب (لا الطوائف)، وشمولية الدولة وعمومية قراراتها، التي لا يمكن أن تتخذ صفة خاصة أو عنوانا طائفياً، بل صفة كلية شاملة، تعبر عن سيادة واحدة لا تقبل التجزئة، وعن شعب واحد وراء الخصوصيات الاجتماعية المتعددة، وعن مواطنين ينتمون إلى وطن، لا أفراد ينتمون إلى طوائف. من هنا فإن تطلعنا إلى العهد الجديد، ليس في إستحداث بدع سياسية جديدة، تضاف إلى البدع القائمة، وإنما في العودة إلى الاصول التأسيسية للكيان اللبناني الذي نص عليه الدستور. وهذا لا يكون إلا بردم الفجوة بين مؤديات الدستور، وبين الواقع السياسي الحالي المحكوم لمعايير ومبادىء، مناقضة لروح الدستور نفسه. فالنص الدستوري مشروع منجز لكنه نصف الطريق، أما الواقع السياسي الذي يتناغم مع روحيته وبنوده، فهو نصف الطريق الآخر، وهو مشروع لم ينجز بعد، تقع مسؤولية تحقيقه على العهد الجديد.