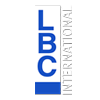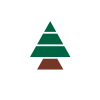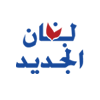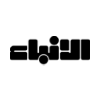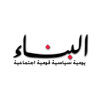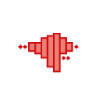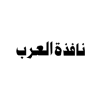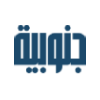اخبار لبنان
موقع كل يوم -جريدة اللواء
نشر بتاريخ: ٤ حزيران ٢٠٢٥
حنّا عبود*
في ذهن الكثيرين ارتبط التقديس بالدّين، سواء بسواء، تقديس الآلهة أو الأبطال. ولا أظنّ أنّ هذا الأمر لا يتّسع لكثيرٍ من الأمثلة الأخرى، في المَيادين المتعدّدة التي تَخرج عن نطاق الدّين، فهناك أقوام تقدِّس حتّى الأجداد، في أفريقيا وآسيا وأميركا والإسكيمو...
في المُقابل يرتبط التقديس بالتدنيس، فالمكان المقدَّس، يقابله مكانٌ مُدنَّس، وكذلك باقي الموضوعات، ولو تابعنا ذلك لكان علينا تكرار ما نقله لنا العلّامة مارسيا إلياد. ولكنْ نَكتفي بما لم يأتِ على ذِكره في كُتُبِه، وهو أنّ هناك فنوناً للمُقدَّس ظهرتْ ظهوراً عفويّاً، تلبيةً لرؤية الفنّان، أو لرغبةٍ عارمة في تجمُّعٍ من التجمّعات البشريّة، من غير أن نُحاسب الرؤيا بالموازين الأخلاقيّة التي تَفرضها العقائد.
وفي المقابل، ثمّة فنونٌ يُمكن القول إنّها فنونٌ قسريّة، بناءً على أمرٍ أعلى من رغبة الفنّان، فينصاع للأمر، وربّما دفعته الرغبة الماديّة، وليس الرؤية الفنيّة، إلى الإبداع في عمله. بيد أنّ هذا لا يطيل لها عُمراً. لا بدّ من تقديسٍ جمعيّ، حتّى تَشتهر اختياراً لا إجباراً.
لا نَرمي إلى عرْضِ هذه الفنون للتعرّف إليها، بل نعرضها للتعرّف إلى ما تخفيه من مشاعر ومواقف للشعور الجمعي. وربّما يساعد هذا في النَّظر إلى التاريخ، فلا نَقف عند فنيّة الأثر، بل يَبرز أمامنا ما انكشف من تيّاراتٍ كانت خافية أو مكبوتة. وربّما كانت هناك صعوبة كبيرة في رصْد الموقف، لأنّه في العادة لا يُمكن أن يكون موقفاً واحداً موحّداً لا خلاف فيه. ونضرب مثالاً على ذلك ما حدثَ في فلورنسا في القرن الرّابع عشر، حيث طلبَ كهنةُ المسيحيّة تغييرَ شفيع المدينة القديم، وهو مارس، إله الحرب، واختيار قدّيسٍ من قدّيسي الكنيسة، واقترحوا عليهم القدّيس يوحنّا، فاستبدلَ المواطنون تمثالَ مارس بتمثالِ يوحنّا، الشفيع الجديد للمدينة، وأَعلن المؤمنون فرحتَهم، لاعتقادهم أنّ المدينة باتت في حراسةِ هذا الشفيع، فلا يُصيبها ضير، ولا ضَرر.... ولكنْ للأسف، بعد قليلٍ من الزمن حدثَ زلزالٌ هزَّ أركانَ المدينة، وحطَّمَ تمثالَ القدّيس يوحنّا.... هل يُمكن لكاتبٍ أن يصفَ مواقف السكّان بعد هذا الزلزال؟ هل يُمكن لعالِمِ نَفْسٍ أن يَرسمَ المشاعر لهؤلاء السكّان؟ فقد تعدَّدتِ المواقف، وتكاثَرتِ المشاعر إلى درجةٍ كبيرة، ولولا سلطة الكنيسة الصارمة في ذلك الوقت، لاتَّخَذَ الكثيرون الموقفَ الساخر الذي اتَّخذه دانتي.
ومن المثال الحديث الذي سنُقدّمه سوف نرى أنّ المقدَّس هذه المرّة لا يَرتبط بالموقف العقائدي فقط، بل يمسّ مباشرةً الحياةَ الاجتماعيّة، وما حصلَ فيها من سوءِ توزيع الثروة، واستثارة الكوامن الاستفزازيّة، كإهانة الكرامات، وما سوى ذلك، ما أضاف الكثير على نظريّة الثورة الاجتماعيّة.
مِثالٌ حديث
في ليلة الثامن من آخر شهر 2024 هّبَّتِ الجموعُ الغاضبة في كلّ المُدن السوريّة، وحطَّمتْ تماثيلَ النظام السابق، من أقصى البلاد إلى أقصاها. لم ينتظروا حتّى مطلع الفجر، بل وقفَ بعضُهم على أكتافِ بعض إلى أن طالوا رقبةَ التمثال، فعلّقوا الأمراس في العُنق، وهي أمراسٌ طويلة جدّاً ليسهّلوا إسقاط التمثال، من غير أن يؤدّي ذلك إلى إلحاق الأذى بأيّ فردٍ من الجماهير الغاضبة، التي تذكّرنا بجماهير الثورة الفرنسيّة، بل إنّ ما قرأنا عن غضب الثورة الفرنسيّة لا يوازي شيئاً من غضب جماهير المُدن السوريّة، ثمّ إنّ الجماهير في شوارع باريس لم تُحطِّم تمثالاً، ولا قارَبت مزاراً، بل توجَّهت إلى سجن الباستيل، الذي لم يكُن فيه سوى ستّة مساجين، أحدهم تهرَّب من دفْع الضرائب، وآخر مُتّهم بالسرقة، والبقيّة من السكارى، أو المُسيئين إلى الزوجة... تحرَّروا جميعاً، بعدما قضتِ الجماهير على الحامية، التي يَبلغ تعدادُها أضعاف المساجين.
لكن لا بدّ من أن نُعلن صراحةً أنّ اندلاع الربيع السوري خيَّبَ آمال المفكّرين الثوريّين المُتشدّدين، وشدّ من أزرِ الفلاسفة العقلانيّين. فإذا تَركنا الهبّةَ الكبرى وتحطيمَ التماثيل، التي خلقتها الذكرياتُ المريرة للاقترافات الآثمة في العَهد السابق، فإنّ هذه الثورة، بحسب موازين المفكّرين الجُدد فريدة من نَوعها من بين ثورات العالَم جميعاً: فهي لم تَنشأ في المصانع بسبب الاستغلال، مع الاعتذار من ماركس ولينين، ولا في الحقول بسبب القحط، أو استيلاء الإقطاع على المحاصيل، مع الاعتذار من ماوتسي تونغ، وإنّما أَوْلَعَ فتيلَها المثقّفون والفنّانون من كلّ الألوان، وقد أَعلنت مسيرةُ الشموع بدايتَها، بعدما فشلَ «إعلان دمشق» في إقناع السلطة بضرورة الإصلاح العاجل، والفوريّ، وتقديم بعض أنفاس الحريّة. وهذا لم يَحدث في كلّ ثورات «الربيع العربيّ»، وفي كلّ ثورات العالَم، إلّا بعضها، حيث قدّمت بعض النصائح مُعظمها شَفَهي.
وهنا لا بدّ من أن نُشير إلى موقف المفكّر الأميركي هربرت ماركوزي (في كتابه «العقل والثورة») الذي أَصرّ، على غير المألوف في الفكر الماركسي، أنّ الثورة تبدأ في العقل، فأعاد بهذا المكانةَ المرموقة للفكر الهيغلي، ومقولته الشهيرة: «كلّ ما هو عقليّ واقعيّ، وكلّ ما هو واقعيّ عقليّ».
ويَرى بعضُهم أنّ الميزة التي لا مثيل لها في أيّ ثورة أخرى، وهي مفخرة المُتحّمسين، هي أنّ الثورة خلقتْ لِجاناً للدفاع عن حقوق الإنسان في كلّ أصقاع العالَم الغربي تقريباً، حتّى إذا سافرَ أو هرب أحد المُرتكبين إلى الخارج، علّقته تلك اللّجان، وبالحجج والبراهين والوثائق الدامغة تُدخله السجن، كما جرى لأحد الأطبّاء، فعوقِب بالسجن المؤبَّد لاقترافه جرائم إنسانيّة في أحد المشافي العسكريّة بحقّ العديد من المُتظاهرين المُصابين الذين نُقلوا للعلاج. ويرى بعضُ المُتحمّسين للثورة احتكارها للسِمة العالميّة، فيرون أنّ الثورة الفرنسيّة، لم تَنتشر عالَميّاً إلّا بعد أكثر من مئة عام، و«ثورة أكتوبر» الروسيّة لم يَسمع بها المغول إلّا بعد سنة أو سنتَيْن، ولم تَنتشر عالَميّاً، كما كان مُخطَّطاً لها، بل إنّ ثورة روزا لوكسمبورغ أُجهِضت في مكانها. ولم يَستطع تروتسكي أن يُشعلَ نارَ الثورة العالميّة، وإن كانت أفكاره تنادي بها، وأولتِ المُثقّفين دَوراً أكثر ممّا أولاه لينين بما لا يقاس، لكنّ ذلك لم يَصل إلى ما وصلَ إليه هيغل.
كما يَعتذر مفكّرو هذه الثورة من كرين برنتون لأنّ المُتطرّفين لم يشعلوا الثورة، بل أَشعلها المُعتدلون، الذين طالَبوا بأقلّ ما يُمكن من الإصلاح، الذي رأت فيه الأُسرة الحاكمة تهديداً لمصالحها. ربّما قَصَدَ برنتون أنّ «الاستيلاء» على السلطة يكون من حظّ المُتطرّفين في بداية الأمور، ثمّ يأتي دَور المُعتدلين، ولكنّ الثورة الفيتناميّة والثورة الكوبيّة - على سبيل المثل - لا تُثبتان ذلك.
وممّا يؤكّد تمايُزَ هذه الثورة، من بين ثورات «الربيع العربي»، تقديمُها مصطلحاتٍ جديدة صارت شائعة عالَميّاً، من أمثال «التشبيح» و«الشبّيح» و«الشبّيحة» و«التعفيش» و«المُعفِّشفين» و«البراميل المتفجرّة» و«فكاك الخطف» و«الصاروخ الصديق» إذا سقط بالخطأ في الجهة الموالية و«المكوِّع» و«المكوِّعين» و«التكويع» و«المدسوس» و«المدسوسين» و«أبو ناضور» للقنّاص فوق السطوح... كما لم تَعرف أيّ ثورة أخرى جمعيّاتٍ خيريّة في القارّات كلّها، سوى الثورة السوريّة، حتّى قال أحدهم: إنّنا نحصي القليل المذكور، ونَجهل الكثير المستور.
ويؤمن الثوّار أنّ ثورتهم أوّل ثورة في الشرق تحمل القيَم الجديدة، كحقوق الفرد والمرأة والأمّ والطفل... إلى حقوق الفكر والجماعات والمكوّنات العرقيّة والدّينيّة وكلّ المُعتقدات، وقد خلَّفت وراءها القيَم التي سادت في العصور الوسطى من إيمان ورجاء ومحبّة، وغير ذلك من الموروثات الدّينيّة.
إنّنا مع المفكّرين الذين يرون أنّ الثورة تَنطلق من مرفأ، ولكنّها تذهب باحثةً عن مرفأ آخر مريح لها، قد تتخيّله وقت انطلاقها، ولكنّها لا تعرفه إلّا حين ترسو فيه. إنّ هذا يُعيد إلى الذاكرة كتاب ستيباستيان برانت «سفينة الحمقى» في أواخر القرن الخامس عشر، حيث انطلقتِ السفينةُ بكلّ قوّة... ثمّ راحتْ تبحث عن مرسىً آمنٍ لها. وقد خلَّدها الرسّامُ هيرونيموس بوش في لوحةٍ شهيرة. ومع أنّ التصفيات في ثورات فيتنام وكوريا وكوبا، لم تَحدث بالصورة الكلاسيكيّة، إلّا أنّ العادة أن تعقب الثوراتِ تصفياتٌ، قد تكون في الأغلب دمويّة. وهنا يكون كرين برنتون محقّاً في تشريحه للثورة. لكنّ ما نؤكّد عليه في مِثالنا هنا هو «الحقد الجارف»... لماذا لم يَظهر في أيّ عصر إلّا في العصر الحديث، وفي الثورة السوريّة بالذّات؟... إنّ الحماسة للخلاص بلغت الحدّ الأعلى. بيد أنّنا نخشى أن تتعالى الحماسةُ فتُستبدَل القداسةُ بقداسةٍ أخرى إجباراً لا اختياراً. ألَم يَحدث هذا في أمثلةٍ سابقة؟ بلى، ومن هنا الخِشية أن تتحوّل المناديل البيض، إلى مناديل حمر، وتبدأ رحلةٌ جديدة لسفينة الحمقى، أو تدور معركة «الركبة الدامية» المصيريّة.
من مصر والرافدين والإغريق
في دائرتنا المتوسّطيّة تَبرز بابل ومصر، لتُقدِّما أقدم الأمثلة لفنّ النَّحت والنَّقش. وقد وصلتْ إلينا تماثيل ومنحوتات وآثار جمّة من حُكّام هذَيْن البلدَيْن، بل في مصر وصلتنا مومياءات لبعض حكّامها، من ذكور وإناث. وقرأنا في بعض كُتب التاريخ عن المظالم التي كانت في هذَيْن الإقليمَيْن، مع أنّ بعض النظرات لا ترى هذا الرأي (كما نُلاحظ لدى المُقارَنة بين قصيدة خليل مطران في أبي الهول، ومُعارَضة إسماعيل صبري لها) لوجود نصوص في قوانين تلك الأيّام كانت متَّبعة بدقّة، بل كان المرشَّح للتاج في الرافدين يَخضع لاختبار الشعب قَبل اعتلائه، حتّى يُعرف مدى اصطباره على الإهانات التي قد تَصدر من بعض أبناء الشعب، فإذا تأفَّفَ نُحّي، وجيءَ بغيره ليخضع لاختبارٍ جديد.
ومن اليونان وصلتنا تماثيل، لم يُشوِّه شكلَها إلّا الزلازل، ورمايات المنجنيق، فما زلنا نرى تماثيل فينوس وديانا وزيوس (جوبتير) ولاؤوكون وأوديسيوس وأخيل وأغاممنون ويوليوس قيصر وأوغسطس قيصر... والكثير من الشخصيّات الأخرى التي كانت حاكمة، في العروش أو في العقول.
والسؤال الآن: أيُعقل أن يكون الظلم في سورية الحديثة أشدّ من الظلم في بابل ومصر واليونان بأضعاف المرّات، حتّى حُطّمت التماثيل وأُزيلت قَبل بزوغ الفجر؟
تُحدِّثنا إديت هاملتون عن الظلم الفارسي... لا بأس، ولكنّ المنحوتات الفارسيّة لا تزال تشهد على أنّ هناك مِن الناس القدامى مَن كان راضياً كلّ الرضى عن حكّامه، وكان يرى أنّ ما يقومون به صحيح، فهم مُحقّون في ما يَفعلون... ربّما لأنّ القيَم القديمة كانت تَمنح الحاكِم من الحقوق (المقدَّسة) أكثر بكثير ممّا تَمنحه (أو يَمنح لنفسه) اليوم، ولذلك حافظوا على بعض التماثيل والمنحوتات. لكن على أيّ حال، هناك منحوتات دالّة دلالة واضحة أنّ الغضب لم يكُن بعنفِ غَضَبِ الجماهير السوريّة، إلى درجة أنّها اقتلعتْ من التداوُل حتّى اسم الأسرة الحاكمة، وغيَّرت أسماءَ الشوارع والمَكتبات والمحلّات والساحات والبِرك والمُنتديات والغابات والأماكن المَحميّة... التي كانت تحمل كنيةَ الأسرة، أو اسمَ أحد أبنائها، واحتكَرت من الكراهية لهم أكثر ممّا احتكَرت هضبةُ «بابا عمرو» من المعارك الدمويّة العنيفة.
العبرة بالخواتيم
يبدو أنّنا سنَنتهي إلى قانونٍ عامّ يَنطبق على الآثار التي ظلَّت باقية حتّى اليوم، وهو أنّ ما بقي إنّما بقيَ بسبب الاختيار وليس الإجبار. لا نشكّ في أنّ كاليغولا أَكْرَهَ الفنّانين على تشخيصه، ومع ذلك لم يبقَ له تمثالٌ أصليّ. إنّ كلّ إجبار يؤدّي إلى دمار، بينما كلّ ما يُبقيه الاختيار يستمرّ في النماء والعمار، فما زالت أطيافُ سقراط وأفلاطون وديكارت وهيغل... وكثير غيرهم، مع صورهم وتماثيلهم تُلْهِم الفكر والفنّ.
والمشكلة أنّ أحداً من الحكّام المُتنمّرين، منذ النمرود وحتّى اليوم، لم يتّعظوا من التاريخ، ولا من الآثار السليمة والمُحطَّمة. إذن... لا عجب إذا رأينا هذه الدروس تتكرَّر في مسرحيّات شكسبير التاريخيّة، عن ملوك إنكلترا وغير إنكلترا. إنّ جنون السلطة، في شرقِنا، يعمي الأبصار، في معظم الأقطار.
----------------
* باحث وكاتب من سوريا
(يُنشر هذا المقال بالتزامن مع دورية «أفق» الإلكترونيّة الصادرة عن مؤسّسة الفكر العربيّ)