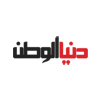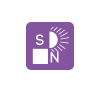اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ١١ أيار ٢٠٢٥
منذ بدء العدوان الشامل على غزة في أكتوبر 2023، كثّفت 'إسرائيل' محاولاتها لتطبيق ما يمكن تسميته بـ”برمجة الاحتلال” للواقع الفلسطيني؛ وهي عملية ممنهجة تهدف إلى إعادة تشكيل المجتمع، والخارطة السكانية، والبنية النفسية للفلسطينيين بما يخدم مشاريع السيطرة والتفكيك.
لكن، وعلى الرغم من حجم العنف المستخدم ووسائل القمع المتعددة، نجح الشعب الفلسطيني، بمقاومته المسلحة وبصموده الشعبي، في تعطيل هذه البرمجة وخلخلتها.
تُحلل الكاتبة في هذا المقال أبرز هذه المخططات الصهيونية، وتستعرض كيف كسرت غزة معادلة الإخضاع عبر مواجهة أدوات البرمجة على الأرض، وفي الوعي، وفي السردية السياسية.
في قلب المشروع الاستعماري الصهيوني تجاه قطاع غزة، تتجاوز السياسات الميدانية حدود العمليات العسكرية المباشرة لتدخل في ما يمكن تسميته بـ”برمجة الاحتلال” للواقع الفلسطيني، هذه البرمجة ليست مجرد تكتيك طارئ، بل هي نهج طويل الأمد يسعى إلى إعادة تشكيل المجتمع الفلسطيني نفسياً وسلوكياً وجغرافياً، من أجل تطويعه وإعادة إنتاجه بما يخدم مصالح الاحتلال وبنيته الأمنية والسياسية.
تقوم “برمجة الاحتلال” على فرض أن الفلسطينيين يمكن إخضاعهم عبر إدارة مكثفة للبيئة الحياتية والذهنية التي يعيشون فيها، بحيث يُعاد ضبط سلوكهم الجمعي ووعيهم السياسي والاجتماعي، إنها محاولة لترويض الكتلة الشعبية وتحويلها من كيان مقاوم إلى كيان مُراقَب، قابل للتفكك والانقسام والاحتواء.
ولتحقيق ذلك، اعتمدت 'إسرائيل' جملة من الأدوات المتداخلة والمتكاملة، التهجير أولها، وقد ظهر ذلك بوضوح في محاولات إفراغ شمال غزة من سكانه، وتحويله إلى مساحة عازلة أو مفرغة، ضمن مخطط أكبر يسعى إلى إعادة رسم الخريطة الديموغرافية للقطاع، أما التجويع، فكان أداة ضغط مركزيّة، طُبّقت بشكل ممنهج عبر الحصار وقطع الإمدادات، بهدف تركيع المجتمع ودفعه للاحتجاج أو التمرد على المقاومة.
إلى جانب ذلك، سعت 'إسرائيل' إلى إنتاج فوضى داخلية مصطنعة عبر دعم عصابات أو محاولات لتأليب العشائر ضد البنية المقاومة، على أمل خلق واقع من الانهيار الأمني والاجتماعي يُسهل اختراقه وإدارته، كما استخدمت أدوات الإعلام -المحلي والدولي-، لتضخيم بعض المشاهد وتغييب أخرى، في مسعى لتشكيل وعي زائف لدى الفلسطينيين والعالم، يبرر عملياتها ويدين المقاومة.
واحدة من أخطر أدوات هذه البرمجة تمثلت في ما سمّته إسرائيل بـ”المناطق الآمنة” أو “الفقاعات الإنسانية”، وهي فكرة تقوم على تجميع المدنيين في بقع ضيقة تحت سيطرة كاملة، بما يشبه السجن الكبير، بذريعة حمايتهم، لكنها في الواقع تعيد إنتاجهم ككتلة غير فاعلة سياسياً أو مجتمعياً.
بهذه الأدوات مجتمعة، سعت إسرائيل إلى برمجة الفلسطيني: أن يُفكر تحت الضغط، أن يتحرك ضمن حدود مرسومة، وأن يعيش في حالة من التهديد الدائم، لا تسمح له بالتنفس أو بالتفكير في المستقبل، لكن ما لم يُحسب له حساب، هو أن الفلسطيني في غزة أعاد – بوعي جماعي ومقاومة عنيدة – تعطيل هذه البرمجة وتفكيك أدواتها الواحدة تلو الأخرى.
أحد أبرز هذه المشاريع تمثّل في خطة الرصيف العائم، التي ظهرت في أبريل 2024، بزعم إدخال مساعدات بحرية إلى غزة عبر ميناء مؤقت تشرف عليه القوات الأمريكية والإسرائيلية، وعلى الرغم من الغلاف الإنساني الظاهري، سرعان ما انكشفت نوايا هذه الخطة؛ إذ رأت فيها المقاومة والمجتمع الفلسطيني محاولة للتحايل على السيادة الفلسطينية، وتكريس نمط من “الوصاية الميدانية” على القطاع، ومع تصاعد التهديدات الأمنية والهجمات التي استهدفت آليات الإنشاء، تعطّلت الخطة، ولم تتحقق أهدافها.
قبلها، في أكتوبر 2023، أطلقت إسرائيل خطة تهجير الشمال، التي هدفت إلى تفريغ شمال قطاع غزة من سكانه بالكامل، مستخدمةً القصف الكثيف والإنذارات الجماعية وسيناريوهات الرعب، لكن ما لم تتوقعه هو أن آلاف العائلات رفضت الخروج، أو عادت لاحقًا متحدّية ظروف الحرب وانعدام الخدمات، وكانت هذه لحظة مفصلية؛ إذ كُسرت فيها فكرة أن الجغرافيا يمكن إعادة تشكيلها بسهولة عبر الضغط العسكري فقط.
ثم جاءت خطة الجنرالات في سبتمبر 2024، والتي اقترحها الجنرال غيورا آيلاند، وتضمنت تصوراً أكثر وضوحاً: تحويل شمال غزة إلى منطقة مغلقة، خالية من السكان، ضمن مشروع تهجير كامل، ورغم الضغوط الهائلة والآلة العسكرية المسلطة، فشلت هذه الخطة بفعل صمود المقاومة، وضغط الرأي العام العالمي الذي بدأ يدرك حجم الجريمة الممنهجة.
وما يُظهر عمق المشروع الإسرائيلي في غزة، هو أنه لم يقتصر على إعادة تشكيل الأرض والسكان عبر الإزاحة أو العزل، بل حاول أيضاً اختراق البنية الداخلية للمجتمع الفلسطيني، ولأجل ذلك، لجأ الاحتلال إلى أدوات أقل مباشرة، وأكثر دهاءً، ضمن ما يمكن تسميته بـ”مشاريع التفكيك الداخلي”، وفي هذا السياق، ظهرت خطة العشائر، وهي محاولة مكشوفة لإعادة تدوير أساليب الاستعمار القديم، الذي لطالما اعتمد على تحفيز الانقسامات القبلية لإضعاف الحركات الوطنية، حيث حاولت 'إسرائيل' – عبر قنوات مباشرة وغير مباشرة – الترويج لتفعيل دور بعض العشائر في إدارة الشؤون المحلية، أو تشكيل ما يُشبه البنى الأمنية “الأهلية” في وجه المقاومة، وكان الرهان على تفكيك وحدة القرار الشعبي، واستبدال التمثيل المقاوم بتمثيل مناطقي عشائري يمكن احتواؤه أو التفاوض معه، ولكن هذه الخطة سرعان ما تهاوت، لأن العشائر نفسها – في معظمها – رفضت أن تُستعمل أداة ضد المشروع الوطني، واعتبرت الخطة طعنًا في الظهر، وخيانة للدم الفلسطيني المسفوك.
إلى جانب ذلك، أُطلقت خطة العصابات، التي تمثّلت في محاولات لدعم مجموعات مسلحة صغيرة، غير منضبطة، تُمارس العنف تحت ذرائع متعددة، بهدف خلق فوضى أمنية تُضعف هيبة المقاومة، وتُربك الناس في معيشتهم اليومية، وكانت الخطة تستهدف إشعال فتيل الاحتراب الداخلي أو على الأقل تآكل الثقة بين الناس والمقاومة. غير أن وعي المجتمع، وتدخل المقاومة في الوقت المناسب، أفشل هذه الخطة قبل أن تنضج، ولم تنجح 'إسرائيل' في اختراق الجبهة الداخلية، بل على العكس، زاد الفشل من تماسك الناس، ومن تقديرهم لأي قوة تحفظ أمنهم تحت القصف والجوع.
أما خطة رفح، فهي أحدث هذه المشاريع وأكثرها دموية وتعقيداً، فبعد أن ضاقت الخيارات أمام الاحتلال، تحوّل إلى الجنوب، محاولًا السيطرة على رفح باعتبارها “الزاوية الأخيرة” في قطاع غزة، لكن ما وجده هناك كان مقاومة شرسة، وتجذراً شعبياً رافضاً للتطويع، جعل من الخطة مأزقاً عسكرياً وأخلاقياً جديداً في سجل الفشل المتراكم.
هكذا، من مشروع إلى آخر، حاول الاحتلال إعادة إنتاج غزة على طريقته، لكنه وجد أمامه جداراً من الوعي والمقاومة لم تنفع معه لا الخدع الإنسانية ولا الوحشية العسكرية،وكل فشل جديد كان يراكم في وعي الفلسطيني قناعة أعمق: أن هذه الأرض لا تعيد تشكيلها إلا إرادة أبنائها.
في قلب كل هذا الزخم من المخططات الصهيونية، كان الصمود الشعبي الفلسطيني هو العامل الحاسم الذي أربك حسابات الاحتلال وبدّد رهاناته على الإخضاع، ولم يكن هذا الصمود مجرد حالة عاطفية أو رد فعل لحظي، بل تحوّل إلى عقبة استراتيجية في وجه “برمجة الاحتلال”، بفعل وعي جمعي ناضج، وثقافة متراكمة من التحدي والبقاء، فرغم المجاعة، والقصف المتواصل، وغياب الحد الأدنى من مقومات الحياة، تمسك الناس بأرضهم وبيوتهم، ورفضوا أن يُعاد تشكيلهم كلاجئين أو موضوعات إغاثية، وقد لعب الإعلام الفلسطيني دوراً محورياً في تثبيت هذا الوعي، فيما أسهمت التغطيات الدولية المتزايدة في نقل صورة الصمود إلى العالم، وكشف زيف الرواية الصهيونية.
بالموازاة، كانت المقاومة تمارس دورها على الأرض، ليس فقط في الرد على الهجمات، بل في تعطيل جوهر المخطط الصهيوني: تفريغ الأرض وفرض وقائع جديدة، فعلى مدار الأشهر، فشلت 'إسرائيل' في تثبيت وجود دائم في المناطق التي اجتاحتْها، لأن المقاومة حوّلت كل محور اقتحام إلى مستنقع استنزاف، وفي معركة رفح الجارية، ظهر هذا التكتيك بوضوح: قتال شرس، أنفاق مفخخة، عمليات تسلل، وإصرار على المواجهة مهما بلغ الثمن، لقد أثبتت المقاومة أن الاحتلال مهما بلغ من القوة، لا يستطيع أن يُبرمج شعباً يُقاتل من أجل بقاءه، ولا أن يُعيد تشكيل أرض تنبت المقاومة كما تنبت الزهر تحت الركام.
لم يقف الفلسطينيون عند حدود تعطيل برمجة الاحتلال، بل تجاوزوا ذلك إلى ما هو أعمق: إعادة تعريف الواقع بشروطهم هم، لا بشروط القوة المفروضة عليهم، فعبر التماسك الشعبي، والابتكار المقاوم، والانخراط الواسع في سردية النضال، أعاد الفلسطيني في غزة إنتاج المشهد من موقع الفاعل لا الضحية، ولم تعد غزة مجرد مساحة محاصرة، بل باتت رمزاً عالمياً للصمود، ومختبراً أخلاقياً يكشف من يقف مع القيم ومن يتواطأ مع الإبادة، لقد تغيّرت صورة القطاع في الوعي الدولي، وبات الاحتلال في موضع المساءلة لا التبرير، فيما ارتفعت كلفة العدوان سياسياً وأخلاقياً، وتعمّقت معادلة الردع رغم اختلال ميزان القوة، لأن الإرادة لا تُقاس بعدد الطائرات بل بقدرة الشعب على البقاء والتحدي.
ختاماً.. في مواجهة واحدة من أكثر محاولات الإخضاع تعقيداً وشراسة في التاريخ المعاصر، أثبت الفلسطينيون في غزة أن الاحتلال لا يستطيع برمجة شعبٍ يحمل وعيه وتاريخه وألمه في يده، كما يحمل البندقية والخبز، لقد تعطلت مشاريع السيطرة الواحدة تلو الأخرى، لا لأن الاحتلال أخطأ في الحسابات فحسب، بل لأن غزة تمتلك معادلة مضادة: معادلة الحياة تحت القصف، والثبات في وجه التفكيك، والإيمان بأن الواقع لا يُصاغ في غرف العمليات بل في أزقة المخيمات ودماء الشهداء، نعم.. إنها ليست مجرد مقاومة، إنها إعادة كتابة للزمن الفلسطيني بلغة لا يفهمها الاحتلال: لغة الإرادة والصمود