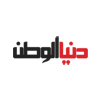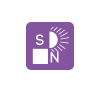اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥
في أزمنة الضعف والترف والانكسارات الاجتماعية، تكثر الأصوات المنادية بالرعاية: رعاية الأطفال، رعاية الشباب، رعاية الضعفاء، رعاية المرأة... كأننا نعيش في مصحةٍ اجتماعية لا في أمةٍ تحمل رسالة. ولكن لو تأملنا قليلاً، لوجدنا أن ما نحتاجه ليس “الرعاية” بقدر ما هو “التربية”. فالرعاية تُبقي الإنسان حيًّا، أما التربية فتنفخ فيه روح المعنى.
الرعاية تُبقي الجسد، والتربية تُقيم الإنسان
الرعاية تُعنى بالطعام واللباس والمأوى، بينما التربية تصنع الإنسان من الداخل؛ توجه فكره، وتهذب عاطفته، وتضبط سلوكه بالميزان. قد يعيش المرء في رعاية فائقة، محاطًا بكل وسائل الراحة، لكنه إذا لم يُربَّ على الصبر، والمسؤولية، وضبط النفس، فإنه ينهار عند أول محنة. إن الرعاية وحدها تُنتج “مدللين”، أما التربية فتصنع “رجالاً”.
التربية: مشروع التغيير العميق
التربية ليست مجرد عناية بالأبناء، بل هي مشروع تغيير شامل في الإنسان:
تغيير القناعات: لأن كل سلوكٍ ينطلق من فكرةٍ سكنت في القلب والعقل، فإذا لم نُصحّح القناعة، فلن يتغير الفعل. التربية الحقيقية تبدأ من الجذور الفكرية، من تصحيح نظرتنا إلى الله، وإلى الحياة، وإلى الناس.
تغيير الاهتمامات: فالشاب الذي يملأ يومه بالتفاهات لا يحتاج إلى من يرعاه بل إلى من يوجّه اهتمامه نحو ما يُغذّي عقله وروحه.
تغيير المهارات: فالتربية ليست وعظًا فقط، بل تدريب عملي على مهارات الحياة: الصبر، الحوار، الانضباط، إدارة الوقت، العطاء، والإتقان.
قواعد العلاقات: فالتربية تصنع إنسانًا يعرف كيف يحب بلا ذل، ويختلف بلا كراهية، ويتعاون بلا مصلحة.
تغيير القدوات: إذ لا تربية بلا قدوة، ولا قدوة بلا صلاح. فحين يصبح الممثل أو المؤثر قدوة الجيل، تنهار المعايير، وتضيع البوصلة.
أخطر ما في المجتمعات اليوم
أنها تهتم بأن يعيش الناس مرتاحين، أكثر مما تهتم بأن يعيشوا مستقيمين. فالمدارس تركز على “التعليم”، لا على “التهذيب”، والأسر تنشغل بتوفير “الرفاهية”، لا بتقويم “النفوس”، والإعلام يسعى إلى “الإمتاع”، لا إلى “الإصلاح”. وحين تتراجع التربية، تتحول الرعاية إلى نوعٍ من “التخدير” الاجتماعي، يُسكّن الألم لكنه لا يُعالج المرض.
التربية ليست قسوة، بل مسؤولية
يظن البعض أن التربية تعني الصرامة أو الحرمان، ولكن التربية في جوهرها تحمّل مسؤولية إعداد الإنسان للحق والخير والجمال. التربية هي أن تقول “لا” حين يجب أن تُقال، وأن تترك الابن يواجه نتيجة خطئه ليتعلم، لا لتنتقم منه. الراعي الحقيقي ليس من يحمي قطيعه من المطر، بل من يُعدّه للسير في العاصفة.
شاهد من التاريخ: عمر بن عبد العزيز
حين تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة، كانت الأمة منهكة بالترف والظلم. ظن الناس أنه سيبدأ بإصلاح الاقتصاد أو بتخفيف الأعباء المعيشية، لكنه بدأ بإحياء التربية الإيمانية والأخلاقية. كان يقول: 'إنما أنا أُصلح الناس بالعدل، فإن استقاموا فذلك مرادي، وإن لم يستقيموا استعملت فيهم السوط.' لم يكن يريد أن “يرعى” الناس فقط، بل أن “يربّيهم” على المسؤولية والحق. ولذلك أعاد بناء مفهوم الدولة لا كـ'مؤسسة عطاء' بل كـ'مدرسة قيم'. حتى أن ابنه عبد الملك – وكان شابًا زاهدًا – قال له يومًا: 'يا أبتِ، ما يمنعك أن تمضي في الأمر؟ فوالله ما أبالي أن تغلي بي وبك القدور في سبيل الله.' فقال عمر: 'رحمك الله يا بني، إن الله لا يُعذِّب العامة بذنب الخاصة، ولكني أريد أن أطفئ الشر بالخير.' هكذا تكون التربية: نقل الإيمان من القلب إلى السلوك، ومن القناعة إلى العمل.
أزمة الجيل ليست في الفقر بل في الفقد
جيل اليوم لا يفتقر إلى الرعاية، بل يعيش في وفرتها: الطعام جاهز، التعليم متاح، الترفيه في كل زاوية. لكن ما الذي نفتقده؟ نفتقد ذلك “الصوت الداخلي” الذي يقول: “افعل الخير لأنه خير”. نفتقد المعلمين الذين يربّون قبل أن يدرّسوا، والآباء الذين يُلهمون قبل أن يُطعموا، والمجتمعات التي تُربي أبناءها على الصبر، لا على الشكوى.
الرعاية بلا تربية تُفسد
حين تُقدَّم الرعاية بلا تربية، يصبح الإنسان أسيرًا لما يُقدَّم له. يعتمد على الآخرين في كل شيء، ويخاف من مواجهة الواقع. يصبح المواطن محتاجًا دائمًا إلى “من يرعاه”، لا “من يربّيه على أن يكون راعيًا لغيره”. ولذلك كانت كلمة النبي ﷺ جامعة حين قال: 'كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته.' فهو لم يقل: “كلكم مرعًى” بل قال: “كلكم راعٍ” — أي مسؤول، ومؤتمن، ومكلّف بالتربية قبل أن يطلب الرعاية. نحن اليوم بحاجة إلى ثورة تربوية قبل أي إصلاح اقتصادي أو سياسي. نحتاج إلى مدارس تُخرّج أحرارًا لا متعلمين فقط، وإلى أسر تُخرج قلوبًا تعرف الله لا بطونًا ممتلئة. نحتاج إلى قادة يربّون الناس على العدل قبل أن يُغدقوا عليهم من الخيرات. فالتاريخ يعلّمنا أن الأمم لا تنهض حين تُرعى، بل حين تُربّى. ولذلك نقول بثقة: إنّ الرعاية تصنع أجيالًا مريحة، أما التربية فتصنع أجيالًا مبدعة.