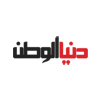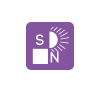اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ٣١ أيار ٢٠٢٥
لا نذيع سرّاً، ولا نضيف جديداً، إذا ما وصّفنا حال المشروع الوطني الفلسطيني بالكارثي. نحن أمام مفصل تاريخي لا يقلّ خطورةً عن الاحتلال البريطاني لفلسطين ووعد بلفور عام 1917، ثمّ نكبة 1948 وقيام إسرائيل في 78% من أرض فلسطين وتهجير مئات آلاف من شعبها، وبعد ذلك نكسة 1967، واحتلال ما تبقّى من فلسطين التاريخية وتهجير مئات آلاف آخرين. ليس الحال الكارثي محصوراً في قطاع غزّة، الذي يتعرّض أهله لحرب إبادة وحشية ويراد تهجيرهم بالجملة، ولا حتى في الضفة الغربية كذلك، التي تتعرّض مخيّماتها لتطهير عرقي ممنهج وتُصادر أراضيها خدمةً للاستيطان اليهودي، بل إنه يشمل كلّ مستويات القضية الفلسطينية وأبعادها ونطاقاتها، وكذلك الشعب الفلسطيني في كلّ أماكن وجوده. يكفي أن نُذكِّر هنا باللهاث العربي على التطبيع مع إسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية، والعربية كذلك، ومحاولات قمع أيّ نشاط متعاطف مع فلسطين في دول عربية وغربية كثيرة. حتى في المناطق الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لا يقلّ الحال سوءاً وقتامةً، إذ ثمّة قيادة رسمية مُختطِفة لأحد ضلعَين أساسَين في الحركة الوطنية الفلسطينية (حركة فتح)، ومصدر شرعيتها عربي رسمي وغربي ودولي، والأكثر أهميةً إسرائيلي، وهي لا تملك مقاربةً وطنيةً للقضية التي تزعم تمثيلها، بل هي عبء عليها وكارثة محيقة بها، وهي صغيرة قيمةً وقامةً، وضيّقة أفقاً وخيالاً، ومحدودة رؤيةً وهدفاً، كما تحرّكها نوازع انتقامية ضدّ جزء من شعبها، ولو كان في ذلك تعاون مع إسرائيل نفسها. أمّا الضلع الأساس الثاني في الحركة الوطنية الفلسطينية، أي حركة حماس، فهي محاصرة في قطاع غزّة، وتخوض حرباً وجوديةً لا يُعلَم بعد إلى ماذا سينتهي حالها، بعد أن يضع العدوان الصهيوني أوزاره.
ما سبق غيضٌ من فيض، بل هو توصيف مخلّ لكارثة وطنية يجد الشعب الفلسطيني نفسه إزاءها. وللأسف، ينبغي أن نعترف أنه لا يوجد مشروع وطني فلسطيني، ولو في الحدود الدنيا، ولا يوجد قيادة وطنية فلسطينية (حتى غير رسمية) قادرة بعد على ملء فراغ القيادة الرسمية التي قادتنا إلى كارثة 'أوسلو'، وكلّ ما ترتب عليها بعد ذلك. ينطبق الأمر نفسه على عدم وجود قيادة وطنية فلسطينية قادرة على توفير حاضنة سياسية للخطّ المقاوم الفلسطيني، الذي انتهج خطّاً انفلتت كوابحه في لحظة لم تُحسب تداعياتها بعمق (تحت وطأة العدوان الإسرائيلي الوحشي والخذلان الفلسطيني والعربي الرسميَّين والتواطؤ الدولي)، فكان أن خرج الأمر عن سيطرته، ويكاد يجرفه ويُغرِق الكلّ الفلسطيني. لكن هذه السطور لا تهدف إلى العويل والتنديد بواقع الحال.
هي دعوة (بل رجاء ومناشدة) إلى أن يتحرّر الفلسطينيون الفاعلون في ساحات العالم كلّها من منطق المحاصصات الفصائلية والتباينات الأيديولوجية والحساسيات السياسية والمصالح الشخصية والتمحور حول الذات. فلسطين وشعبها اليوم في خضمّ معركة وجود حقيقية، وينبغي أن يكون قاسمنا المشترك (وجوهر معاييرنا) وطنياً ننصهر جميعاً فيه، فيكون تنوّعنا مصدرَ تكامل وقوة، لا تناقض وضعف. هذا حقّ الشعب الفلسطيني علينا. هذا أقلّ مستويات الوفاء للتضحيات العظام التي يقدّمها أهل غزّة.
لا ينبغي أن تذهب تضحياتهم عبثاً، بل هو غدرٌ وخيانة أن نضيّع هذه التضحيات، وهذا الصمود الأسطوري لشعبٍ خذله القريب قبل البعيد. أعلم أن قتامة المشهد تفوق الوصف، وأن أسباب الإحباط تتجاوز أسباب التفاؤل، لكن من يزعمون إنهم قيادات ونُخب مطالبون بأن يكونوا على قدر الزعم، أو أن يتنحّوا جانباً ويفسحوا المجال لغيرهم. القائد الحقيقي هو من يرى الفرص، حتى وإن كانت خافتةً مُلبَّدةً بغيوم سوداء ثقيلة، ويكون قادراً على التقاطها، ومن ثمّ السعيّ إلى تجسيدها واقعاً، أو على الأقلّ؛ الهلاك دونها. هذا هو التحدّي الحقيقي، وليس الاستغراق في التوصيفات المُحبِطة، والانشغال في التلاوم وتصدير المسؤوليات إلى الغير.
جمعني قبل أسبوع حوار مع أصدقاء منشغلين بالهمّ الوطني الفلسطيني، ممن يعملون على تأسيس إطار وطني فلسطيني جامع، ويسعون إلى تقديم بعض إجابات وحلول للمأزق الفلسطيني الراهن المشار إلى بعض تعبيراته آنفاً. بعيداً من التفاصيل الكثيرة، كان بعض ما قلته في سياق الفرص التي أراها من واقع خبرتي ونشاطي من أجل فلسطين في الساحة الأميركية، هي تلك التحوّلات الجوهرية في الرأي العام الأميركي نحو إسرائيل سالباً (طبعاً التحوّلات على مستوى الرأي العالمي في هذا السياق أكثر عمقاً واتساعاً).
وكان استطلاع للرأي أجرته مؤسّسة بيو، في 8 إبريل/ نيسان الماضي، أشار إلى ارتفاع مطرد في نسبة الأميركيين الذين ينظرون إلى إسرائيل سالباً خلال السنوات الثلاث الماضية، بحيث وصلت النسبة الآن إلى 53%. لكنّ أهمية هذه النسبة تتضاعف إذا نظرنا لها من زوايا مختلفة. مثلاً 69% من الديمقراطيين ينظرون إلى إسرائيل بسلبية، مقابل 37% من الجمهوريين (في 2022 كانت هذه النسبة 27%). النسبة المتعلّقة بالجمهوريين لافتة، ذلك أن الحزب الجمهوري هو خزّان الدعم السياسي الحزبي الأساس لإسرائيل في الولايات المتحدة في العقدَين الماضيَين. ومعلومٌ، حسب استطلاعات رأي أخرى، أن الشباب الأميركي أكثر تعاطفاً مع الفلسطينيين من كبار السنّ، لكن استطلاع 'بيو' يشير إلى تحوّل آخر لافت.
ففي حين أن النسبة الساحقة من الديمقراطيين الشباب ينظرون بسلبيةٍ إلى إسرائيل، يشير الوضع الراهن داخل الحزب الجمهوري إلى أن 48% ممّن هم تحت سنِّ الخمسين ينظرون بسلبية إلى إسرائيل مقابل 50% ينظرون إليها بإيجابية. أيضاً، يشير استطلاع 'بيو' إلى جوانب أخرى مهمة في تحوّل المزاج الأميركي العام من إسرائيل. من ذلك، الموقف منها على أساس الانتماء الديني والمذهبي. 40% من البروتستانت المسيحيين ينظرون إلى إسرائيل بسلبية، مقارنةً بـ57% ينظرون إليها بإيجابية. داخل هذا المذهب المسيحي، 26% من 'الإنجيليين' (Evangelicals) ينظرون إلى إسرائيل سالباً مقارنة بـ72% ينظرون إليها بإيجابية. و50% من البروتستانت البيض ينظرون إلى إسرائيل بسلبية مقابل 47%. أهمية معطى التحوّل داخل التيّار البروتستانتي في الموقف من إسرائيل تنبع من أن هذا التيّار هو الداعم لها تاريخياً لأسباب دينية، وتحديداً التيّار الإنجيلي منه، المشبَّع بنبوءات آخر الزمان وعودة المسيح الثانية، ولذلك نرى التحوّل داخله أكثر بطءاً مقارنةً بالتيّار البروتستانتي العام. أمّا الكاثوليك الأميركيون، حسب هذا الاستطلاع، فإن 53% منهم ينظرون إلى إسرائيل بسلبية مقابل 45%، في حين ينظر 69%، ممّن ليس لهم انتماء ديني محدّد لإسرائيل، بسلبية مقابل 28%. أيضاً، 81% من المسلمين الأميركيين لديهم موقف سلبي من إسرائيل مقابل 19%. وداخل اليهود الأميركيين هناك 27% ينظرون بسلبية لإسرائيل، مقابل 73%.
أعود إلى حواري مع الأصدقاء. قلت نحن الناشطين لفلسطين في أميركا ندرك تماماً أن ثمَّة فارقاً بين التحوّل في المزاج الشعبي الأميركي، أو داخل الحزبَين الديمقراطي والجمهوري، وبين انعكاس ذلك في سياسات الولايات المتحدة أو مؤسّستي الحزب، والتي تبقى كلّها منحازةً كليّاً لإسرائيل. لكن، من ناحية، نحن نرى أن ثمّة خدوشاً وتشقّقات تتراكم على (وفي) جدار التواطؤ الحديدي هذا، وهذا معطى هام جدّاً. ومن ناحية ثانية، فإن هذه الحقيقة تضعنا أمام تحدٍّ أكثر أهميةً، وهو أن نبحث عن فرص تحويل التغيّر في المزاج الشعبي والحزبي والديني في أميركا لصالح فلسطين، إلى ضغط سياسي ينجم عنه تعديل في ميزان التواطؤ الأميركي الرسمي المطلق مع إسرائيل. طبعاً، هذا يستلزم استراتيجيات وأدوات كثيرة، نعمل عليها ضمن حدود الإمكان، لا أريد أن أرهق القارئ بها هنا.
أمر آخر أشرت إليه، ويتعلّق بضرورة أن نعيد النظر في مفهومنا لمكوّنات الحركة الوطنية الفلسطينية. من زاوية نشاطي في أميركا لفلسطين، أنا لا أعتبر اليهودي الأميركي، أو المسيحي، أو الأبيض، أو الأسود، أو اللاتيني، أو أيّ مكوّن أميركي آخر، منافح عن الحقّ الفلسطيني، حليفاً فحسب، بل هو جزء من مشروعي وحركتي الوطنية. هذا أمر ينبغي أن نستوعبه جيّداً. تلك الروح التي تسري اليوم في الشباب الفلسطيني والعربي والمسلم وغيرهم في كلّ أصقاع الأرض، ينبغي أن تُستوعَب في الحركة الوطنية الفلسطينية. ثمّة غير فلسطينيين أكثر فلسطينيةً ممّن ولد وترعرع فلسطينياً، حتى في فلسطين نفسها. وأضيف، إن الحقيقة المُرّة المتمثّلة في غياب قيادة وطنية فلسطينية مؤهّلة يحرمنا من الاستفادة من طاقات هائلة مؤيّدة للحقّ الفلسطيني. مثلاً هناك العشرات ممّن طُردوا من وظائفهم في شركات تكنولوجية عالمية، مثل مايكروسفت وغوغل وأمازون، بسبب موقفهم الأخلاقي المعارض لتواطؤ شركات التكنولوجيا الغربية والعالمية مع الجيش الإسرائيلي في جرائم الإبادة في قطاع غزّة، عبر برامج الذكاء الاصطناعي وتقنيات التجسّس والسحب الافتراضية clouds... وغير ذلك.
خلفيات هؤلاء الذين تخلّوا عن وظائف راقية وتدفع رواتب عالية جدّاً متنوّعة، منهم يهود ومسيحيون ومسلمون وعرب وفلسطينيون وبيض وملوّنون وآسيويون. ترى، لو كان عندنا قيادة وطنية فلسطينية مؤهلة، ألم تكن لتستفيد من تلك الطاقات التكنولوجية الجبّارة لتعزيز مشروعنا الوطني في فضاءات ومجالات نحن إمّا غائبون عنها، أو إننا نحبو فيها حبواً؟ قس ذلك أيضاً، على صحافيين ومسؤولين حكوميين وخبراء.. إلخ، إمّا استقالوا أو أُقيلوا لنصرتهم غزّة والحقّ الفلسطيني. نحن، بوصفنا حركة تضامن مع فلسطين في الولايات المتحدة، نحاول قدر الإمكان استيعاب تلك الطاقات في عملنا، ولكن شحّ الإمكانات عائق أساس. الأمر ذاته ينطبق على الطلاب في أرقى الجامعات الأميركية، الذين ساهموا في تركيز الضوء في جرائم إسرائيل في قطاع غزّة ومعاناة الفلسطينيين.
مرّة أخرى، تواجه فلسطين والشعب الفلسطيني حرب اجتثاث وإلغاء، ومن حقّ هذا الشعب الذي يضحّي بما يفوق الوصف ويتجاوز قدرة الإنسان على الاحتمال أن نكون أوفياء لتضحياته، وأن نرتقي إلى مسؤولية اللحظة التاريخية الراهنة. بغير ذلك، فلنتنح جانباً ونفسح المجال لمن هو أكفأ وأكثر التزاماً بقضيتنا. رغم كلّ الألم وقتامة المشهد، خصوصاً في قطاع غزّة، فإن هذه الكارثة أحيت جيلاً فلسطينياً في كامل جغرافيا وجوده، مضافاً إليه جيل من المناصرين في العالم كلّه.