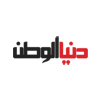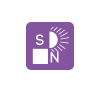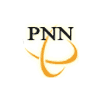اخبار فلسطين
موقع كل يوم -وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
نشر بتاريخ: ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٥
الكاتب: د. ياســر العموري
يعتبر الاعتراف الدولي إحدى الركائز الأساسية في تنظيم العلاقات الدولية، إذ يتجاوز البعد القانوني ليشمل أبعادا سياسية ودبلوماسية واقتصادية ترتبط بمصالح الدول المعترفة. وينظر إليه القانون الدولي باعتباره عملاً سياديا تمارسه الدول في إطار حقها بتحديد طبيعة علاقاتها الخارجية، وهو في الوقت ذاته يحمل دلالات قانونية لارتباطه بحق الشعوب في تقرير المصير وبمكانة الدولة المعترف بها وإرساء شخصيتها القانونية في النظام الدولي.
في هذا السياق، لا يمكن النظر إلى موضوع الاعتراف الدولي والاوروبي تحديدا بدولة فلسطين، بمعزل عن المحطات التاريخية المتعاقبة التي بدأت منذ إعلان المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 قيام دولة فلسطين، وهو الإعلان الذي شكل نقلة نوعية في مسار القضية الفلسطينية، حيث انتقل الخطاب من التركيز على حقوق الشعب الفلسطيني كقضية تحرر وطني إلى محاولة ترسيخ الشخصية القانونية للدولة الفلسطينية في النظام الدولي.
وقد تزامن هذا الإعلان مع موجة من الاعترافات الفورية من أكثر من مئة دولة، معظمها من دول عدم الانحياز والدول الاشتراكية آنذاك، ما أعطى دفعة رمزية وسياسية كبيرة للقضية الفلسطينية. إلا أن هذه الاعترافات، رغم أهميتها، لم تكن كافية لتجاوز معضلة غياب الاعتراف من القوى الغربية المؤثرة، ولا سيما الدول الأوروبية الغربية والولايات المتحدة الامريكية، وهو ما أبقى الاعتراف بالدولة الفلسطينية قضية مفتوحة بين الشرعية القانونية الدولية من جهة، والحسابات السياسية للدول الكبرى من جهة أخرى.
بقي الأمر على هذا الحال الى حين صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67، في تشرين ثاني/نوفمبر 2012، والذي شكّل محطة مفصلية في مسار الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، إذ منح فلسطين صفة 'دولة مراقب غير عضو' في الأمم المتحدة، مؤكّدًا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967. وقد فتح هذا القرار الباب أمام فلسطين للانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية.
في السياق الأوروبي، كانت دول أوروبا الشرقية -مثل بولندا والمجر ورومانيا وبلغاريا وغيرها- من أوائل المعترفين بدولة فلسطين بعيد إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988، بينما التزمت دول أوروبا الغربية خطابا مغايرا يربط الاعتراف بالتوصل إلى تسوية نهائية عبر المفاوضات. وقد ظل الموقف الأوروبي الغربي مترددا غير واضح المعالم حتى أعلنت دولة السويد اعترافها الرسمي بدولة فلسطين عام 2014، لتصبح أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذه الخطوة، وهو ما شكّل كسرا للنمط التقليدي الأوروبي الغربي في التعامل مع القضية الفلسطينية.
في السنوات الأخيرة، وتحديدا بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أواخر عام 2023 وما رافقة من جرائم الإبادة الجماعة بحق الفلسطيني، ازداد التفاعل الأوروبي وبشكل إيجابيتجاه الاعتراف بفلسطين. ففي عام 2024، أعلنت كل من إسبانيا، وإيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة جماعية مثّلت مؤشرا على تحوّل نوعي في الموقف الأوروبي، لا سيما أنها صدرت عن دول كانت مواقفها التاريخية مترددة وغير حاسمة اتجاه القضايا الفلسطينية.
تباعا لذلك وبشكل متزامن مع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة خلالالأيام الماضية،ازداد الترقب ومتابعة الأوساط السياسية والقانونية لما أُعلن عنه من اعترافات جديدة بدولة فلسطين، حيث أعلنت إحدى عشرة دولة أوروبية وغربية اعترافها الرسمي بدولة فلسطين (المملكة المتحدة، كندا، أستراليا، البرتغال، فرنسا، بلجيكا، لوكسمبورغ، مالطا، أندورا، موناكو، وسان مارينو).والذي يمكن ان ينظر إلية كخطوةنوعية تعكس تحولا متسارعا في المواقف الدولية، وأنه يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى مكانة هذه الدول في النظام الدولي، وما يمكن أن يترتب على مواقفها من تأثيرات سياسية وقانونية على مسار القضية الفلسطينية، وعلى إعادة تشكيل الموقف الدولي من الاحتلال الإسرائيلي.
على ضوء ذلك، ومن اجل فهم دقيق للاعتراف الدولي، وتحديدا الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين، لا يجب ان تبقى محاكاة هذه الاعترافات في إطار المقاربة التاريخية او رصد الوقائع. فالاعتراف لا يمثل غاية بحد ذاته، بل يجب أن يكون مدخلا لمجموعة من الالتزامات القانونية والسياسية التي تترجم إلى واقع ملموس. كون الاعتراف دون إجراءات عملية كفيل بتحويله إلى موقف رمزي لا أثر له في تغيير الوضع غير المشروع المخالف لأحكام وقواعد القانون الدولي، بل قد يُفسر على انه شكل من اشكال التماهي الضمني مع سياسات الاحتلال.
الاعتراف الأوروبي بين الحالة الرمزية والفاعلية العملية
من أجل فهم دقيق لطبيعة الاعتراف الدولي، وتحديدا الأوروبي بدولة فلسطين، ومن أجل الإجابة على السؤال الجوهري، حول التداعيات القانونية والسياسية لهذا الاعتراف، وهل يمكن ان يشكل تحولا استراتيجيا في موقف الدول المعترفة من القضية الفلسطينية، أم أنه سيبقى محصورا في إطار الرمزية السياسية دون أثر عملي حقيقي من النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، لا بد من التوضيح ان الاعتراف الدولي في التطبيق العملي غالبا ما يتجاوز الوظيفة القانونية له، ليشكل أداة ضغط ذات طابع دبلوماسي في إطار التجاذبات السياسة الإقليمية والدولية، من خلال التضامن أو الاعتراض مع الدولة المعترف بها. وهذا ما يجعل من الضروري التمييز بين الاعتراف الرمزي، الذي يقتصر أثره على الإعلان السياسي دون أن يتبعه تغيير في السياسات أو مواقف الدول المعترفة، وبين الاعتراف العملي/ الفاعل، الذي يقترن بإجراءات عملية من شأنها تعزيز مكانة الدولة المعترف بها وضمان حقوقها على الساحة الدولية. في هذا السياق، يثير الاعتراف الدولي، وتحديدا الأوروبي بفلسطين، إشكالية أساسية تتمثل في تحديد موقعه بين هذين النموذجين.
من المؤكد ان الاعتراف الاوروبي بدولة فلسطين، يحمل دلالات سياسية وقانونية مهمة، كونه يمثل تحولا في الرأي العام الأوروبي وضغوطا متزايدة من البرلمانات الوطنية الأوروبية ومؤسسات المجتمع المدني على حكوماتها، خاصة في ضوء جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة التي تقترفها إسرائيل منذ أواخر عام 2023، كما أن هذا الاعتراف يسهم في إعادة توازن السردية الدولية حول القضية الفلسطينية، بعد عقود من هيمنة الرواية الإسرائيلية على الساحة الدولية، ويشكل رسالة واضحة مفادها أن استمرار الاحتلال والاستيطان لم يعد مقبولا من الناحية القانونية أو الأخلاقية. مع ذلك فان الطابع الرمزي للاعتراف الأوروبي يظل محدود الأثر إذا لم يترجم إلى خطوات عملية، فالتجارب التاريخية تشير إلى أن الاعتراف، مهما كان نطاقه، لا يكفي بمفرده لإنهاء الاحتلال او إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة.
تأسيسا على ما سبق، وكي لا يُعتبر اعتراف الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين مجرد إعلان سياسي رمزي أو خطوة معنوية، يتعين على هذه الدول اتخاذ سلسلة من الإجراءات العملية التي تنسجم مع التزاماتها القانونية الواضحة بموجب الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي، وتتماشى مع مرجعياته القانونية، مثل معاهدة الاتحاد الأوروبي، ومعاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، إلى جانب المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد، وعلى رأسها احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والامتثال للقانون الدولي.وتُشكّل هذه الإجراءات ما يمكن تسميته بـ 'محددات الفاعلية القانونية والعملية للاعتراف'، والتي تتجسد في:
أولا: مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية في ضوء الالتزامات الأوروبية
حيث تنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يعد عنصرا جوهريا في استمرار الاتفاق، وبناءً عليه، وكون هذا النص لا يعد مجرد بند شكلي، بل يرتب التزاما قانونيا على الدول الأعضاء بضرورة مراجعة الاتفاق إذا ثبت أن الطرف الآخر، أي إسرائيل، ينتهك هذه المبادئ، يصبح من الضروري، في ظل الانتهاكات الجسيمة التي تقترفها إسرائيل بحق الفلسطينيين، اعتبار استمرار العمل بالاتفاق دون مراجعة أمرا غير مقبول قانونيا. وعليه، فإن الدول الأوروبية التي تعترف بدولة فلسطين مطالبة، ليس فقط أخلاقيا، بل قانونيا، بإعادة تقييم الاتفاق، بما في ذلك تعليق بعض بنوده أو إعادة النظر في الامتيازات التجارية الممنوحة لإسرائيل.
ثانيا:تطبيق مبدأ عدم الاعتراف بالوضع غير المشروع في المجال التجاري مع إسرائيل
استنادا لما أقرته محكمة العدل الأوروبية في حكمها الصادر عام 2019 بإلزامية تمييز المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة أن تُوسم بوضوح، وعدم تسويقها باعتبارها منتجات إسرائيلية. وكون هذا الحكم يُعد ترجمة قانونية لمبدأ عدم الاعتراف بالوضع غير المشروع ويُجسد مبدأ قانونيا راسخا في القانون الدولي، فإن الدول الأوروبية التي تعترف بدولة فلسطين، تجد نفسها أمام واجب مضاعف في تطبيق هذا الحكم، كونه ليس مجرد إجراء إداري يتعلق بالملصقات التجارية، بل هو موقف قانوني يعكس رفضهم التطبيع مع الاستيطان، مما يستدعي فرض رقابة صارمة على الأسواق الأوروبية، ومنع دخول منتجات المستوطنات، انسجاما مع قواعد السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، ومع الاعتراف بسيادة دولة فلسطين على أراضيها المحتلة.إن هذا الالتزام يُعد اختبارا حقيقيا لمدى جدية الاعتراف الأوروبي، إذ لا يمكن أن يُعترف بدولة فلسطين من جهة، وتُعامل منتجات المستوطنات على أنها شرعية من جهة أخرى.
ثالثا: ضبط صادرات الأسلحة والتعاون العسكري مع إسرائيل وفقا للمعايير القانونية والإنسانية
على ضوء الموقف المشترك الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي عام 2008 بشأن صادرات الأسلحة، فإن الدول الأعضاء ملزمة بعدم منح تراخيص التصدير إذا كان هناك خطر واضح من استخدام هذه الأسلحة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني. ويُعد هذا الموقف ترجمة قانونية لمبدأ أساسي في سياسة الاتحاد، ويُشكّل إحدى أدواته لضمان عدم استخدام منتجاته العسكرية في سياقات تتعارض مع المبادئ التي يُفترض أنه يدافع عنها.
وعليه واستنادا لما وثقته المنظمات الحقوقية الدولية بارتكاب إسرائيل انتهاكات جسيمة ترقى لمصاف الجرائم الدولية، فإنه يكون لازما على الدول المعترفة بدولة فلسطين التزاما إضافيا وواجبا قانونيا بمراجعة التعاون العسكري مع إسرائيل وضبط صادرات الأسلحة بما يشمل تعليق أو رفض تراخيص تصدير الأسلحة التي يتم تصديرها لإسرائيل، وخاصة إذا ثبت استخدامها في مجالات تنتهك القانون الدولي الإنساني.
انطلاقا مما تقدم، يمكن القول إن الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين، رغم أهميته الرمزية، لا يمكن ان يُحدث أثرا حقيقيا ما لم يُترجم إلى التزامات قانونية وسياسات عملية. فجوهر الفاعلية لا يكمن فقط في توفر الأدوات، بل في الإرادة السياسية لتفعيلها، وفي القدرة على تجاوز الحسابات الضيقة التي تحتكم اليها الدول في علاقاتها الدولية.
الالتزامات القانونية بالتزامن مع الاعتراف بدولة فلسطين
بالإضافة إلى ما تم تفصيله من إجراءات عملية، يتعين على الدول الأوروبية التي تعترف بدولة فلسطين العمل على تطبيقها والأخذ بها، كي تنسجم مع التزاماتها القانونية بموجب الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي. يترتب على كافة الدول المعترفة بدولة فلسطين واجب قانوني دولي واضح، يُلزمها باحترام قواعد القانون الدولي المتعلقة بالاحتلال، وضمان حماية حقوق الشعوب المحتلة، وعدم التواطؤ مع الانتهاكات التي تقترفها دولة الاحتلال، فضلاً عن التعاون مع الآليات القضائية الدولية المختصة. ومن أبرز هذه الالتزامات القانونية التي ينبغي على الدول المعترفة مراعاتها وتفعيلها في هذا السياق:
أولا: الالتزام بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال وضم الأراضي بالقوة
يُعد مبدأ عدم الاعتراف بالاحتلال أو ضم الأراضي بالقوة من المبادئ الراسخة في القانون الدولي، ويستند إلى المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي. وقد أكدت الجمعية العامة هذا المبدأ في قرارها رقم 2625 لسنة 1970، الذي شدد على أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة لا ينتج أي آثار قانونية مشروعة، وأن على جميع الدول الامتناع عن الاعتراف أو تقديم الدعم لاستمرار مثل هذا الوضع.وبما ان هذا المبدأ لا يُعد مجرد قاعدة تنظيمية للعلاقات بين الدول، بل يُكرّس قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، تُلزم المجتمع الدولي بأسره، وتمنع إضفاء أي شرعية على أوضاع فُرضت بالقوة، فإنه يتوجب على الدول المعترفة بدولة فلسطين عدم قبول أو إقرار أي واقع مفروض بالقوة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد عززت محكمة العدل الدولية هذا الالتزام في رأييها الاستشاريين بشأن الجدار العازل في الأرض الفلسطينية المحتلة (2004) وبشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي (2024)، عند تأكيدها أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وضم الأراضي بالقوة يشكل خرقا جسيما للقانون الدولي، خاصة لمبدأي تقرير المصير وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وكلاهما من القواعد الآمرة. واعتبرت المحكمة أن التزامات عدم الاعتراف وعدم تقديم العون تسري على جميع الدول، وتُرتب واجبا جماعيا بالتعاون لإنهاء الوضع غير المشروع.
بناءً على ذلك، وكي لا يعتبر الاعتراف بدولة فلسطين مجرد خطوة سياسية رمزيه، بل التزام قانوني، يجب على الدول المعترفة أن تؤكد أن هذا الاعتراف لا يشمل أي تغييرات إقليمية أو قانونية نتجت عن سياسات الاحتلال أو الضم، وأن تترجم ذلك في ممارسات عملية، مثل رفض التعامل مع المستوطنات ودعم الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال.
ثانيا: الالتزام بمواجهة الاستيطان الإسرائيلي باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي
يُرتب الاعتراف بدولة فلسطين على الدول المعترفة التزاما قانونيا بضرورة اتخاذ موقف واضح من سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بوصفها انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وذلك بموجب المادة (49/6) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، ما يجعل من المشروع الاستيطاني الإسرائيلي ممارسة غير مشروعة تُخالف قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي التي لا يجوز تجاوزها.
وقد أكد مجلس الأمن هذا التوصيف في قراراته، ومنها القرار 465 لسنة 1980 والقرار 2334 لسنة 2016، اللذان شددا على عدم شرعية الاستيطان، ورفض أي تغييرات تفرضها إسرائيل على الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما رسخت محكمة العدل الدولية هذا الفهم في رأييها الاستشاريين بشأن الجدار العازل (2004) والعواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي (2024)، حيث اعتبرت أن الاستيطان يُقوّض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويُشكل خرقا لمبدأ حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، مما يُرتب على جميع الدول واجبا جماعيا يتمثل في عدم الاعتراف بشرعية المستوطنات أو التعامل معها، وعدم تقديم أي دعم يسهم في استمرارها، إلى جانب التعاون الفعال لإنهائها.
وبناءً عليه، فإن الدول المعترفة بدولة فلسطين مطالبة بأن تُظهر التزامها القانوني من خلال سياسات عملية، تشمل رفض التعامل مع أي آثار اقتصادية أو قانونية للاستيطان، وتقييد أنشطة الشركات المرتبطة به، ومنع تداول منتجاته داخل أسواقها، فضلا عن دعم الآليات القضائية الدولية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، لضمان مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها.
ثالثا: التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتفعيل الولاية القضائية العالمية في مواجهة الجرائم الإسرائيلية
تتحمل الدول المعترفة بدولة فلسطين التزاما قانونيا واضحا بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، بخصوص القضايا المنظورة أمام المحكمة بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين يُشتبه في ارتكابهم جرائم دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك استنادا إلى ما جاء في المادة (86) من نظام روما الأساسي، التي تلزم الدول الأطراف بتقديم جميع أشكال الدعم للمحكمة في التحقيقات والملاحقات القضائية. ويشمل ذلك تزويد المحكمة بالمعلومات، وتنفيذ أوامر القبض، وتسليم المتهمين. إن هذا التعاون لا يُعد خيارا سياسيا، بل واجبا قانونيا يهدف إلى ضمان فعالية النظام الجنائي الدولي، وتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، يُعد تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية من قبل الدول المعترفة بدولة فلسطين أداة قانونية فعالة في مكافحة الإفلات من العقاب. إذ يُتيح للدول ممارسة اختصاصها القضائي على مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الجاني أو الضحية. ويُعد تفعيل هذا المبدأ من خلال التشريعات الوطنية للدول المعترفة بدولة فلسطين خطوة ضرورية لسد الفجوات القانونية، وضمان عدم إفلات المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني من العقاب، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها تقديمهم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي ضوء ما تقدم، فإن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لا يمثلان فقط التزاما قانونيا، بل يشكلان اختبارا حقيقيا لجدية الاعتراف، ويعكسان إرادة سياسية في مواجهة الجرائم الإسرائيلية، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي الجنائي والتزامات المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان.
في الختام، يمكن القول إن الاعتراف بدولة فلسطين ليس نهاية المطاف، بل هو بداية لمرحلة جديدة من العمل والتنسيق تتطلب إرادة سياسية حقيقية، ومتابعة مستمرة، والتزاما فعليا بالمعايير القانونية الدولية، لضمان ترجمة هذا الاعتراف إلى واقع ملموس يعزز من فرص السلام والاستقرار، ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.