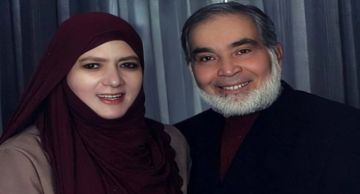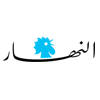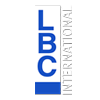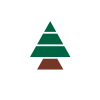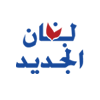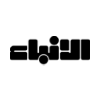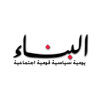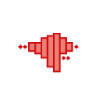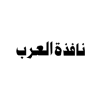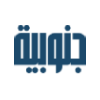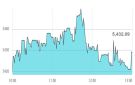اخبار لبنان
موقع كل يوم -جريدة اللواء
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٥
د. صاحب عالم الأعظمي الندوي(*)
كانت السيّدة هستر لوسي ستانهوب من أوائل الرحّالات الأوروبيّات اللّواتي خضْنَ غمار الاستكشاف في بلاد الشام، وتفرَّدَت بجرأتها واستقلالها في زمنٍ لم يكُن فيه للمرأة الدَّور الكبير في الاستكشاف، ما أَكسبها شهرةً واسعة، بعدما خلَّفَت إرثاً راسخاً في ميدان البحث التاريخيّ وأدب الرحلات، تجلّى في رسائلها ومذكّراتها. كان لرحلتها إلى عسقلان أثرها البارز في نشْأة عِلم الآثار الحديث في الأراضي المقدَّسة، حيث يُنظر إلى التنقيبات التي أشرفَت عليها على أنّها أوّل أعمال الحَفْرِ الأَثريّة الموثَّقة في المنطقة.
جسَّدَت السيّدة هستر لوسي ستانهوب روحَ المغامرة والتحدّي، وعاشتْ حياتَها وفقَ قناعاتها من دون الالتفات إلى أعراف مُجتمعها وقوانين بلادها. وعلى الرّغم من نهايتها المأساويّة، تظلُّ سيرتها حاضرةً في كُتب الرحلات والمُغامرات، شاهدةً على امرأة متفرّدة سبقَت عصرها.
وُلِدت السيّدة لوسي في الثاني عشر من آذار/ مارس 1776، ونَشأت في كنفِ أسرةٍ أرستقراطيّة بريطانيّة، فهي الابنة الكبرى لتشارلز ستانهوب، من زوجته الأولى، السيّدة هستر بيت. عاشت في قصر تشيفنينغ حتّى مطلع القرن التّاسع عشر، ثمَّ انتقلَت للعيش مع جدَّتها السيّدة هستر بيت، كونتيسّة تشاتام. برزَت في أروقة السياسة البريطانيّة عندما أصبحت مديرة منزل خالها، رئيس الوزراء البريطاني ويليام بيت الأصغر، في آب/ أغسطس 1803، وأدَّت دَوراً مُهمّاً في استقبال ضيوف خالها، حيث أظهرَت حُسن حديثها وجمال حضورها.
عقب وفاة بيت في العام 1806، منحتْها الحكومة البريطانيّة معاشاً سنويّاً قدره 1200 جنيه إسترليني يُدفع لها مدى الحياة. وبعد إقامتها لبعض الوقت في لندن، انتقلَت إلى ويلز، لكنّها قرَّرَت مغادرة إنكلترا نهائيّاً في العام 1810م بعد وفاة شقيقها. اتَّجهَت هستر مع قافلتها إلى القسطنطينيّة ومنها إلى القاهرة ثمّ سافرَت إلى العديد من المناطق في الشرق. ولدى وصولها إلى القدس، أُخليَت كنيسة القيامة بالكامل وأُعيد افتتاحها تكريماً لها. وذاعَ صيتُها في هذه البلاد عند القدوم إليها والإقامة فيها.
استقرَّت هستر قرب مدينة صيدا، حيث عاشتْ أوّلاً في دَير مار إلياس في قرية عبرا، ثمّ في دَير سيّدة مشموشة جنوب جزّين. رافقَها في البداية طبيبُها ميريون والآنسةُ آن فري، التي تُوفّيَت في العام 1828 بداء الرئة، ثمّ غادرَ ميريون في العام 1831، ليعود لاحقاً في زيارةٍ قصيرة للمنطقة بين 1837 و1838. ثمّ انتقلَت هستر إلى دَيرٍ مهجور في قرية جون في جبل لبنان، حيث أقامت حتّى وفاتها. كان منزلها، المعروف باسم «دير السِّتّ»، يقع على قمّة تلّة تطلُّ على المنطقة.
أصبحت سُلطتُها في صيدا وجبل لبنان شبه مُطلَقة، حيث اعتمدَت على شخصيّتها القويّة واعتقاد الناس بقدرتها على قراءة الطّالع. وقد أوردَت صُحفُ ذلك الزمان أنَّ نفوذها كان عظيماً، إذ عُرفت بملِكة الصحراء، وزينوبيا العصر، والملِكة غير المتوَّجَة على لبنان. ومع تدهوُر أحوالها الماليّة، اضطرّت إلى استخدام معاشها البريطاني لسداد ديونها، حتّى بدأ خدَمُها في نَهْبِ مُمتلكاتها لعدم قدرتها على دفْع رواتبهم. ومع مرور الزمن، أصبحت ناسكةً منعزلةً، لا تستقبل الزوّار إلّا بعد غروب الشمس، وكانت تغطّي رأسها بعمامةٍ لإخفاء شعرها المحلوق.
لمّا قدِمَت هستر إلى الآستانة والتقَت بالسفير البريطاني ستراتفورد كانن في العام 1827، بَذل الأخير جهداً بائساً لإقناعها بمُغادرة تركيا، غير أنَّ الوثائق المُتاحة لا توضِح الأسباب التي دفعتْه إلى ذلك. ومع ذلك، يبدو أنَّ وجودَها كان مصدر إزعاج للسلطات البريطانيّة. ومنذ ذلك الحين، انقطعَت سُبل التواصُل بينها وبين تلك السلطات، حتّى تَبيَّن لاحقاً أنّها قد أثقلَت كاهلَها بديونٍ باهظة؛ الأمر الذي دَفَعَ السلطاتِ البريطانيّة إلى التدخُّل في شؤونها الخاصّة، ولاسيّما عندما تصاعدَت مُطالباتُ الدّائنين لها بسداد مستحقّاتهم. وعلى الرّغم من الضغوط المتزايدة، لم تكُن هستر تُبالي بمَطالبهم، ما اضطرّهم للّجوء إلى السلطات البريطانيّة لإيجاد حلٍّ يَضمن استرداد حقوقهم.
يتبيَّن من مراسلاتِ هستر أنّها اقترضَتْ أموالاً من أشخاصٍ وجِهاتٍ عدّة. ويَظهر من هذه الوثائق أنّها استمرَّت في الاستدانة لفتراتٍ طويلة، بما يُشير إلى تعقيداتِ وضعِها المالي واعتمادها على القروض في تدبير أمورها وشؤونها. ولعلَّ ما يُذكر هنا أنّه في ظِلِّ نظام الامتيازات، كانت الدولةُ العثمانيّة قد تنازلَت عن سلطتها القضائيّة على الرعايا البريطانيّين لمصلحة القناصل البريطانيّين، غير أنّها احتفظَت بصلاحيّاتها متى كان أحد رعاياها طَرفاً في الأمر. ولذا، حينما بلغَت ديون السيّدة هستر مَبلغاً كبيراً بحلول سنة 1834، حملَ ذلك السلطاتِ المصريّة على مُخاطَبة المندوب البريطاني في القاهرة، الكولونيل كامبل، «لإنصاف الدائنين». ولكنّ كامبل، وقد وعى مكانتَها، رفعَ الأمر إلى الحكومة، فجاءه الجواب بأن «لا سلطانَ لحكومة جلالة الملِك على السيّدة هستر ستانهوب»؛ ومن ثَمَّ لا سبيل إلى التدخُّل في شأنها.
ومع توالي مُطالبات السلطات المصريّة بحلول سنة 1837، باتت وزارة الخارجيّة في حَرَجٍ من أمرها. فقد أَشار الوزيرُ المصري إلى أنَّ الشكاوى التي يرفعها الرعايا البريطانيّون «ضدّ الأتراك أو غيرهم من أهالي هذا البلد، يُنظر فيها على الفَور ويُقضى فيها بالعدل دونما إبطاء». وكان من الجليِّ أنّه إذا لم تُسدَّد الديون، فقد تَجِد السيّدة هستر نفسَها ماثلةً أمام محكمةٍ عثمانيّة. وعليه، أُحيط شقيقُها، اللّورد ستانهوب، علماً بالأمر، وبحسب مذكّرة مؤرَّخة في 1 أيّار/ مايو 1838 حول قضيّتها، فقد اقترحَ أنْ تُسدِّد ديونها إذا أُبلغَت بأنَّ القنصل البريطاني لن يوقِّع على الشهادة التي تحتاجها لاستلام معاشها إلّا بعد قيامها بذلك.
إهانتها لقناصل بريطانيا
وكان كامبل، الذي أُوكلت إليه مهمّة إبلاغ السيّدة هستر بهذا القرار، يَشعر بأنّه وُضع في موقفٍ حَرِج. وإدراكاً تامّاً لمكانتها، كَتَبَ يقول: «... ثِقْ تماماً أنّني لن أنسى للحظة مكانةَ السيّدة هيستر وجنسها، أو أنّها ابنة شقيقة بيت». حين أُبلغَت السيّدة هستر بالخطّة عبر الكولونيل كامبل من طريق مور، القنصل البريطاني في بيروت، شنَّت حربَ مُراسلاتٍ، وانهالتْ برسائل لاذعة، وأحياناً شديدة اللّهجة. وفي الرّابع من شباط/ فبراير 1838، كتبتْ إلى كامبل قائلة: «لن أجيب عن رسالتك». وبعد نحو أسبوع، وجَّهت رسالةً شديدة اللّهجة إلى الملِكة فيكتوريا، مُحتجّة بشدَّة. وأكَّدت أنَّ أسرتها كانت وفيّة لبريطانيا، وكانت تتوقَّع معاملةً أكثرَ إنصافاً. وأضافت أنَّ أحداً لم يُكلِّف نفسَه عناء السؤال عن سبب تراكُم الديون عليها، ولعلَّ من المُفيد أنْ نورد هنا النصَّ الكامل لرسالتها: «سيّدتي، يجب أنْ تأذني لي، يا جلالتك، بأنْ أقول إنَّ مِن أكثر الأمور إهانةً ومَضرَّة بالملَكيّة إصدارَ الأوامر من دون فحْص جميع أبعادها المُختلفة، والتصرُّف من دون سبب، أو مُمارَسة الضغط على نزاهة أيِّ فرعٍ من العائلة، خَدَمَ بلادَه وبيت هانوفر بأمانة وإخلاص. ولمّا لم يتمّ إجراء أيِّ استفساراتٍ منّي حول الظروف التي دفعتْني لتحمُّل الدَّيْن المُشار إليه من قِبَل وزير خارجيّة جلالتك، أرى أنّه من الضروريّ تقديم بعض التفاصيل أو التوضيحات حول هذا الموضوع. ولكن إذا كان القرار قد اتُّخذ، حتّى مِن قِبل جدِّك الملكيّ، ليتمّ الصمود أمامه، فسأبتهج بسداد دَيني، مع الاحتفاظ باسم رعيّة إنكليزيّة والاحتشام في طُرقٍ عدّة. لذلك، وإنْ كانت جلالتك قد نشرت هذه المسألة بأمرٍ ملَكيٍّ للقناصل، فلا يُمكنني أنْ أُلام على اتِّباعي لمثالك الملَكي». الإمضاء هيستر لوسي ستانهوب
في اليوم نفسه، كتبَت إلى دوق ولينغتون، قائلة: «ليس لمَلكتك شأنٌ في التدخُّل في أموري». وأوضحَت أنَّ ديونَها تراكمَت بسبب رغبتها في مساعدة الفقراء. ففي العام 1834، خلال ما يُعرف اليوم بـ ثورة الفلّاحين السوريّين، أُفيد بأنّها «مَنحت ما لا يقلّ عن 77 حماية لأشخاصٍ مُختلفين». أمّا وزير الخارجيّة، اللّورد بالمرستون، الذي بدا وكأنّه يفقد صبره، على الرّغم من محاولته المُستميتة لضبْط النَّفس، فقد رأى أنْ يَكتب بنفسه إلى السيّدة هستر ليؤكِّد لها أنَّ كلَّ ما قامت به السلطاتُ البريطانيّة، إنّما كان بهدف تجنيبها حَرَجَ المثول أمام محكمةٍ عثمانيّة. غير أنَّ رسالته جاءت بنتيجةٍ مُعاكِسة لما كان يرجوه! إذ جاء ردُّها شديد اللّهجة، كاشفاً عن استيائها العميق، حيث كتبَتْ إليه قائلة: «إذا كانت مُراسلاتكم الدبلوماسيّة على القدْر ذاته من الغموض الذي تتّسم به الرسالة التي بين يدَيَّ الآن، فلا عجبَ أنْ تفقد إنكلترا تفوُّقَها البارز في علاقاتها الخارجيّة الذي كانت تُفاخِر به يوماً (...). سأواصل خَوْضَ معاركي، حملةً بعد حملة». ولم تَكتفِ بذلك، بل لَجأت إلى الصحافة لتشنَّ حملةً ضدّ السلطاتِ البريطانيّة، مسلِّمة جميع المُراسلات المُتبادَلة بينها وبين الحكومة إلى الصحف. وبالفعل، نَشرت صحيفةُ «ذا تايمز» هذه المراسلاتِ كاملةً في عددها الصادر بتاريخ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 1838، ما أثار جدلاً واسعاً حول القضيّة وألقى بظلاله على الصورة الدبلوماسيّة لبريطانيا في ذلك الوقت.
لقد دفعَ هذا الأمر بالطبيب والمبشِّر جوزيف وولف إلى مراسلة اللّورد بالمرستون، سعياً لتصحيح بعض المعلومات التي وردَت في الصحف بشأن السيّدة هستر. ولئن لم يكُن يعرفها شخصيّاً، فإنّه أمضى وقتاً طويلاً في المنطقة نفسها، وكَتَبَ قائلاً: «لقد قامت بجَلْدِ خادمي العربي المسكين قَبل خمسة عشر عاماً». ورأى أنَّ «الحقيقة يجب أنْ تُعرف». ومن المُفارقات، أنَّ رسالته - مع أنّها كانت ضدّ السيّدة هستر - تُعَدُّ من أغنى المصادر بالمعلومات عن حياتها، متفوِّقةً على أيّ وثيقة أخرى مُتاحة لدينا. فقد تناولتِ الرسالةُ تفاصيلَ عن ديونها وصورتها في المنطقة وسلوكها العامّ، ما يجعلها شهادةً مهمّة لفهْم طبيعة حياتها وشخصيّتها. تحدَّث وولف عن تراكُم ديونها، قائلاً: «لقد تراكمَت هذه الديون لأسبابٍ سخيفة في كثيرٍ من الأحيان - على سبيل المثال، أعطت الحاخام ليفي من الخليل 7000 قرش لأنّه سهرَ معها طوال اللّيل وتحدَّثا عن المسيح المُنتظَر، وما إلى ذلك (...)». وفيما يخصُّ موقف سكّان المنطقة منها، أوضحَ وولف أنَّ اليهودَ في القدس كانوا يعتبرونها «ساحرة»، في حين أَطلق عليها المسلمون لقب «مجنونة»، أيْ: امرأة مختلّة عقليّاً، وهو ما جَعلهم يعذرونها على ارتدائها ملابس الرجال. ومن المُثير للاهتمام أنَّ وولف ذكَر تعبيراً شاعَ عنها بين العرب، حيث كانوا يقولون: «السِّتّ تُحبّ الإسلام أكثر من الإنكليز»، وهي عبارة وَردت في الرسالة بالرسم العربي. وأضافَ وولف في رسالته: «وكان الجميع يَعلم أنّها أهانت كلَّ القناصل».
تُوفّيت هستر في 23 حزيران/ يونيو 1839. وكانت قد هدَّدَت، في رسالةٍ إلى اللّورد بالمرستون، بأنّها ستَدفن نفسَها في منزلها إنْ لم يُلغَ قرار مُصادَرة أملاكها وإسقاط ديونها عَلَناً. لا يوجد دليل على أنّها قامتْ بمِثل هذا التصرُّف الدرامي، لكن من الواضح أنّها نادراً ما غادرَت منزلها. وبناءً على وصيّتها بأنْ تُدفن في حديقتها، سافرَ القنصل مور إلى بلدة جون برفقة مُبشِّرٍ أميركي أجرى مَراسِم الدفن بإيجاز. ووفقاً لما ذَكره خَدَمُها، الذين بَلغ عددهم ثمانيةً وعشرين، فقد احتفظَت «بكامل مَدارِكها حتّى اللّحظات الأخيرة قَبل وفاتها».
(*) باحث في تاريخ الهند وجزيرة العرب والخليج
(يُنشر هذا المقال بالتزامن مع دورية «أفق» الإلكترونيّة الصادرة عن مؤسّسة الفكر العربيّ)