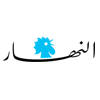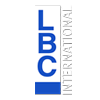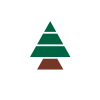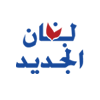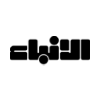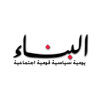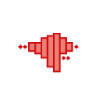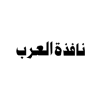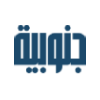اخبار لبنان
موقع كل يوم -المرده
نشر بتاريخ: ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
كتب علي حيدر في 'الأخبار'
إن فهم المشروع الصهيوني من زاوية مرحليّته ليس مهماً فقط لاستيعاب ماضيه الاستعماري، وإنما لأنه يشكل مدخلاً أساسياً لفهم طبيعة الخطر الإسرائيلي المتجدّد على لبنان والمنطقة بأسرها. فإسرائيل لا تنظر إلى حدودها الراهنة كحدود نهائية، بل كحدود مؤقّتة ضمن مسار توسّعي طويل يتكيّف مع التحوّلات الإقليمية والدولية.
لذا، فإن قراءة مبدأ المرحلية ليست ترفاً تاريخياً، بل ضرورة سياسية وأمنية لبنانية، لأن جنوب لبنان كان يُفترض أن يكون ضمن الدولة اليهودية في مرحلة التأسيس في عام 1948، كما تكشف وتُسهب الوثائق الإسرائيلية في شرح المساعي والمحاولات الإسرائيلية قبل وبعد تأسيس الدولة. إلا أن الظروف السياسية وتعارض المصالح بين الدول العظمى، حالا دون تحقيق ذلك في حينه. لذلك ما بدأ باحتلال الأرض الفلسطينية لم يتوقّف عند ذلك، بل تحوّل إلى مشروع هيمنة وتوسّع على المجال العربي المحيط، وفي طليعته لبنان.
من أبرز ما يميّز المشروع الصهيوني منذ تأسيسه اعتماده مبدأ المرحليّة في تحقيق أهدافه التوسعية. فالمرحليّة لم تكن خياراً تكتيكياً عابراً، بل جوهراً بنيوياً في إستراتيجية الحركة الصهيونية، فرضتها قيود الواقع وموازين القوى من جهة، لكنها تحوّلت في الوقت نفسه إلى أداة تخطيطية واعية لضمان استمرار التقدّم نحو الهدف النهائي المتمثّل في إقامة كيان يهودي مهيمن على أرض فلسطين في المرحلة الأولى، على أن يكون قاعدة للتوسّع نحو «إسرائيل الكبرى» بحسب ما أقرّ رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ومن هنا، ارتبطت كل مرحلة من مراحل المشروع الصهيوني بشعار سياسي يُقدَّم من خلاله الصهاينة كما لو أنهم في موقع الدفاع، فيما الفلسطينيون والعرب هم «المعتدون»، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة ويخفي في باطنه أطماع المرحلة التالية.
المرحليّة عقيدة إستراتيجية
تجلّت هذه الإستراتيجية منذ البدايات الأولى للاستيطان، حين رُفع شعار «الوطن القومي لليهود» من دون الحديث صراحة عن «الدولة اليهودية». فالمصطلح الأول بدا أكثر تسويقياً وإنسانياً في زمن الانتداب البريطاني، وأقرب إلى استدرار تعاطف القوى الكبرى. ولم يظهر الطابع الدولتي الواضح إلا في مؤتمر بلتيمور في عام 1942، ثم في مؤتمر الحركة الصهيونية الثاني والعشرين في عام 1946، اللذين مثّلا تحوّلاً مفصلياً في الخطاب الصهيوني نحو إعلان هدف إقامة دولة يهودية في فلسطين.
وقد أدرك ديفيد بن غوريون باكراً أن نجاح الحركة لا يتحقّق بالشعارات الثابتة، بل بتكييفها مع المراحل التاريخية، فكتب في أحد مقالاته أن «غايتنا لا تتناقض مع الوجود العربي على الأرض، فنحن لا نهدف إلى إبعاد العرب، أو انتزاعهم من أراضيهم ومراكز مكاسبهم، بل بالعكس؛ الغاية هي في إحياء الأرض، تحقيق إمكاناتها الاستيطانية العديدة… وهكذا تتسع الأرض لمن فيها من سكان قليلين وأيضاً لملايين من المستوطنين الجدد». لكنه هو نفسه قاد عملية إقامة الدولة وتهجير الفلسطينيين من وطنهم في عام 1948، ومنع عودتهم لاحقاً.
إن مبدأ المرحليّة هذا لم يكن مجرّد سلوك سياسي، بل عقيدة إستراتيجية متجذّرة عبّر عنها بن غوريون صراحة في رسالته الشهيرة إلى ابنه عاموس في عام 1937، مبرّراً موافقته على مشروع تقسيم فلسطين الذي طرحته لجنة بيل البريطانية برؤية المرحليّة والتدرّج في تحقيق المشروع الصهيوني، إذ كتب: «السؤال المصيري هو: هل إقامة الدولة اليهودية تساعد أم تعطّل تحويل هذه الأرض إلى يهودية؟
أنا متحمّس جداً لإقامة الدولة – حتى وإن كانت تتزامن الآن مع الموافقة على التقسيم – لأنّي أرى أن الدولة اليهودية المنقوصة ليست النهاية، وإنما هي البداية… لأنه بواسطته نزيد من قوتنا، وكل زيادة في القوة تساعدنا على حياة وتملّك باقي الأرض.
إن إنشاء دولة – حتى ولو كانت منقوصة وجزئية – يُعتبر أقصى ما يمكن عمله لتعزيز قوتنا في المرحلة الراهنة، ويشكّل رافعة قوية لجهودنا التاريخية لتحرير كامل الأرض».
هذا التصور يلخّص جوهر التفكير الصهيوني القائم على استثمار الممكن المرحليّ للوصول إلى غير الممكن الإستراتيجي. وهو ما جسّدته القيادات التي توالت على إدارة مشروع التوسّع على مراحل.
التهديد الوجودي
إلى جانب البعد السياسي، رافق المشروع الصهيوني في جميع مراحله شعار الأمن. فـ«التهديد الوجودي» ظلّ السردية المركزية التي تُبرّر كل توسّع، لا بمعنى أنه مُختلق، بل لأن إسرائيل تحوّله إلى ذريعةٍ لتوسيع السيطرة وتثبيت الهيمنة.
فالأمن لم يكن غاية دفاعية بقدر ما كان واجهة تغطّي دوافع السيطرة. منذ قيام الكيان، تحوّل الأمن إلى أداة لإضفاء الشرعية على العدوان، داخلياً لتعبئة المجتمع الإسرائيلي خلف الجيش، وخارجياً لتسويق سياساته في الغرب على أنها «دفاع عن النفس». وهكذا، أصبحت الذرائعية الأمنية وسيلةً لتحويل الفعل الهجومي إلى مبرّر أخلاقي، والفعل الاحتلالي إلى «ضرورة دفاعية».
أدرك بن غوريون أن نجاح الحركة الصهيونية لا يتحقّق بالشعارات
الثابتة، بل بتكييفها
مع المراحل التاريخية
لكنّ الأهم أن «الأمن» في الإستراتيجية الصهيونية لم يكن غاية في ذاته، بل مدخلاً لإعادة هندسة الجغرافيا والسياسة الإقليمية. فكل «انتصار أمني» كان يُترجم عملياً إلى توسّع جغرافي أو تحوّل إستراتيجي: من حرب 1948 إلى حرب 1967، ومن اجتياح لبنان 1982 إلى الحروب على غزة. وفي كل مرة، كانت الرواية الإسرائيلية تبدأ بالدفاع وتنتهي بالاحتلال.
إنّها آلية سردية ممنهجة تُحوّل الضحية إلى معتدٍ، والمعتدي إلى مدافع، بما يتيح لإسرائيل الانتقال من مرحلة إلى أخرى تحت غطاء «الضرورة الأمنية» التي لا تنتهي.
إعادة صياغة الخطاب
وإذا تأمّلنا تاريخ الصراع، نرى أن المشروع الصهيوني استخدم المرحليّة لإدارة التناقض بين الطموح والقدرة، مستثمراً كل فرصة لتوسيع رقعة السيطرة المادية والمعنوية.
ومع كل مرحلة، أعاد صياغة خطابه ليتناسب مع التالية: من استعمار استيطاني إلى دولة، ومن دولة إلى قوة إقليمية وكيانٍ وظيفي ضمن المشروع الأميركي، وصولاً إلى سعيه اليوم لإعادة صياغة موازين القوى في المشرق، خصوصاً تجاه لبنان، عبر الضغط السياسي والحصار الاقتصادي ومحاولات فرض معادلات ردع تخدم أمنه الإقليمي على حساب سيادة لبنان وقوته.
فإذا نجحت (ولن تنجح) خطة نزع سلاح المقاومة، تكتمل الظروف الملائمة للانقضاض على لبنان وتحقيق الأطماع التاريخية التي لم تسمح الظروف السياسية مع بداية تأسيس الكيان وفي الخمسينيات من تحقيقها.
إنّ القراءة المفاهيمية لتاريخ الحركة الصهيونية تكشف أن المرحليّة ليست مجرّد تكتيك سياسي بل مبدأ رئيسي في فلسفة المشروع الصهيوني، هدفها التدرّج بين الممكن والمأمول حتى يتحوّل المؤقّت إلى دائم. وهي تذكير للبنانيين والعرب بأن الشعارات الإسرائيلية – من «الأمن» إلى «السلام» و«الاستقرار» – ليست سوى واجهات وظيفية لمخطّطات تراكمية تتجاوز الجغرافيا الفلسطينية لتطاول بنية المنطقة ودولها.
إنّ تجاهل منطق المرحليّة الصهيونية يعني تجاهل الخطر المتنامي على لبنان الذي يُستهدف اليوم بأساليب أكثر تعقيداً ونعومة. فكما أثبتت التجارب، ليست إسرائيل دولةً تسعى إلى أمنها فحسب، بل هي مشروع يسعى إلى نزع أمن الآخرين كي يضمن أمنه. ومن هنا، فإن الوعي بمنطق المرحليّة هو شرطٌ أساسيٌّ لحماية لبنان من المخطط الصهيوني المُسلّح بأدوات جديدة تحت شعاراتٍ أمنية قديمة.