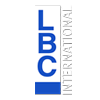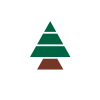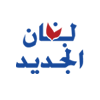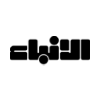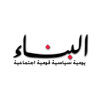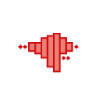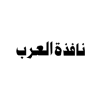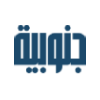اخبار لبنان
موقع كل يوم -جريدة الأخبار
نشر بتاريخ: ٣٠ نيسان ٢٠٢٥
ما علاقة الرأسمالية بحياتنا الخاصة؟ ولماذا كلما نعرف أكثر، يزداد إحساسنا بالعجز؟ لماذا تابع كل العالم الانتخابات الأميركية؟ وما علاقة ترامب بقلقنا الآني؟
شهد القرن العشرون حتى يومنا هذا، تغييرات لا مثيل لها على صعيد جماعي وفردي.
منذ عام 1915، شهد العالم الحرب العالمية الأولى التي طغت فيها مهنة العسكري لدى الرجال على سائر المهن. ثمّ وقعت حرب عالمية ثانية محورها أوروبا دمّرت ثلث العالم. هكذا، لم يعد هناك عدد كافٍ من الرجال في سوق العمل، ما أدّى إلى دخول المرأة في معترك العمل.
بعد تلك الحقبة، صار العالم محكوماً من قطبين: الولايات المتّحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي الروسي، وانطلق تسابق عالمي نحو الفضاء وتنافس نووي وتكنولوجي.
صار الفرد في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية حائراً في خياراته الشخصية، فآباؤه كانوا محاربين، بينما متطلّبات الحاضر تفرض عليه دخول معترك العمل: إمّا كصناعي أو كأكاديمي أو كحرفي، وتطوّر حقل الطب والهندسة والحقوق، ولا سيّما مع تأسيس الأمم المتحدة.
اختار كلّ فرد بحسب قدرته الطبقية والذاتية الانخراط في مهن معيّنة، وصارت هناك تخصّصات في الجامعات من أجل تنظيم الحياة المهنية، ولا سيّما في الأنظمة الليبرالية، وأنشئت البورصات العالمية، ورُبط الدولار الأميركي بأسعار النفط والذهب وانطلقت فكرة العولمة على تلك القاعدة.
في أواخر القرن العشرين، سقط الاتحاد السوفياتي الروسي وصار العالم محكوماً بقطب واحد هو الولايات المتحدة الأميركية. صدّرت الأخيرة عبر الميديا والسينما «لا ثقافتها» إلى العالم، وصار الكوكب محكوماً ثقافياً من هوليوود والبترودولار. صرنا نتسابق للاستهلاك الأحمق من أجل السعي نحو التمتع بالسعادة المنشودة من قبل «الحلم الأميركي».
أعطى المجتمع الرأسمالي العمل أهميةً من أجل تعريف الفرد عن نفسه في المجتمع. وبدل أن يكون العمل مجرد مصدر للعيش، أصبح صفة يُقيّم بها الفرد. لم يعد الإنسان حيواناً سياسياً، بل صار مجرد كائن يعمل ويستهلك.
حين يتعب الفرد، يُدفع إلى ممارسة اليوغا وزيارة الأطباء النفسيين
هذا الهوس بالاستهلاك جعل الإنسان ينسحب من المجال السياسي وصار العمل هدفاً عوض أن يكون وسيلة. إلا أنّ التقدم التكنولوجي، ولا سيّما في مجال الذكاء الاصطناعي، يجعل كثيرين عاطلين من العمل لأنّهم استُبدلوا بماكينات. تقول الفيلسوفة الألمانية حنّة آرنت (1906 ـــ 1975): «نحن نشهد على مجتمعات مؤلفة من أفراد عاملين، إلا أنّهم عاطلون من العمل».
تقصد بذلك أنّ الحداثة عرّفت الإنسان عبر عمله، ثمّ حرمته الشيء الوحيد الذي يستطيع أن يمارسه في المجتمع ألا وهو العمل. إذا صار العمل هدفاً بحدّ ذاته وتعريفاً للفرد، سينتج من ذلك إحساس الإنسان غير العامل بأنّ لا معنى ولا جدوى لحياته. تكمن المشكلة ــ وفقاً لآرنت ــ في تحويل أي نشاط إنساني إلى عمل وبالتالي إلى سلعة. وهذا ما يضع الإنسان في سجن الإنتاج والاستهلاك اللامتناهيين.
إذا أردنا وصف العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية بعيون الفيلسوفة آرنت، فهو منقسم إلى فضاءين: الفضاء العام والفضاء الخاص. يتّصل الفضاء الخاص بشبكة الإنتاج العامة، كما عندما نشتري منزلاً لنسكن فيه أو عندما نسافر بغية السياحة ونحن نستطيع أن نفعل ذلك لأننا نعمل وننتج.
وعندما يستبدل الاقتصاد بالسياسة، يصبح الفضاء العام غير موجود، لأنّ فكرة المجتمع قائمة على عقود اجتماعية سياسية لا اقتصادية فردية.
وفي مجتمعات مماثلة، لن يجد الفرد أي قيمة لوجوده من دون العمل، فحتى في المجال الفني، نلاحظ بأنّ نتاج أي فنان صار يسمّى عملاً فنياً وليس تحفة أو إبداعاً.
إنّ غياب السياسة عن المجتمع يجعل أفراده معزولين، لأنّ الفعل السياسي هو العنصر الجامع، ويصبح الفعل السياسي مهنةً هو الآخر. فالشعوب تحكم على المسؤول السياسي من منظار تنفيذه للعمل الذي وعد به.
وفي مجتمع رأسمالي، يصبح دور السياسة تأمين راحة كلّ فرد في مساحته الخاصة المنعزلة. وهذا الأمر يناقض تعريف العمل السياسي الذي يكمن دوره بالأساس في تنظيم المساحات العامة عبر التشريعات، وبسبب ذلك، يصبح الفرد لا يملك نفسه على الصعيد الخاص، لأنّ السياسة تتحكّم به. وفي الوقت نفسه لا يوجد مساحات سياسية عامة مشتركة يستطيع أن يكون جزءاً منها.
باختصار نستطيع أن نقول إنّ دور السياسة لم يعد عملاً خلّاقاً عاماً يسعى إلى نشر قيم معيّنة مثل الحريّة، بل انحسر بمجرد تنظيم ما يقرّره الاقتصاد.
يعتبر المفكّر الفرنسي غي دوبور (1931 ــ 1994) أنّ النظام الرأسمالي مميّز، لأنّه يستطيع أن يكون سائداً في دولة ديموقراطية أو توتاليرية أو حتى مملكة.
بعد تطوّر الرأسمالية، كانت هناك لحظة تحوّل فيها كل نظام في العالم إلى نظام رأسمالي. يصبح شكل النظام ـــ أكان ديموقراطياً أو توتاليرياً ــ مجرد قناع. وفي ظل نظام مماثل، يتشكّل مجتمع المشهد. نتيجة لذلك، تصبح السلطات السياسية في كلّ الأنظمة مجرد دمية بين يدي الاقتصاد الاستهلاكي. ففي نظام دخلته الرأسمالية، لن يكون الحاكم سوى الرأسمالية.
وإذا تحوّلت السلطة من حاكم سياسي إلى حاكم اقتصادي، تكون النتيجة بأنّ فعل السياسة يبدأ بالاحتضار لأنّ السوق الاقتصادي هو الذي يحكمها وليس العكس.
وبما أنّ الرأسمالية الحديثة تفشّت في كلّ العالم والأنظمة، يصبح «المشهد» هو النظام السياسي الفعلي المتبقّي في العالم. إنّ خصوصيات الحضارات بدأت بالامتزاج لتصبح شبه عالمية، فاستخدام الطائرة للسفر، والهاتف الذكي للتواصل لم يعد خياراً، بل واقع معاش.
إنّ الطائرة والهاتف الذكي ليسا سلعتين سياسيتين بل اقتصاديتين، فلم نسمع يوماً أنّه أقيم استفتاء شعبي في مجتمع ما لاستقصاء رغبته في استخدام تلك السلع.
إذ إنّ حاجتنا الإلزامية إلى استخدام تلك السلع، ليست فعلاً سياسياً، بل فعل اقتصادي ينطبق على أي مواطن في العالم. هذا الأمر لا ينحصر فقط بالتطور التكنولوجي والسلع، بل ينطبق أيضاً على الفن مثل أغاني البوب التي كانت موسيقى شعبية مؤلّفة من قبل الشعب في القرن العشرين. أمّا اليوم، فقد أصبحت أغنيات مؤلَّفة من أجل الشعب مثل أي سلعة استهلاكية.
في ظلّ تلك المتغيّرات، يصبح السؤال حول وضع الإنسان الفرد جوهرياً. من أجل أن يكون الفرد فاعلاً في المجتمع، عليه أن يستهلك، وبالتالي أن يُنتج. من هنا يصبح تعريف الإنسان في المجتمع عبر مهنته وكميّة إنتاجه. ولذلك يسعى الأفراد إلى التنافس في سلّم الإنتاج: مَن ينتج أكثر، يهيمن!
أدخلت الرأسمالية الفرد في دوّامة مجنونة، فهو يركض ليل نهار ويتحمّل ضغطاً كبيراً من أجل جني المزيد من المال و«الترقّي المهني» وبالتالي الاجتماعي. وحين يتعب، يُدفع إلى ممارسة اليوغا، يزور الأطباء النفسيين، يشاهد مدرّبين شخصيين، يتعاطى الأدوية والمخدّرات.
صار الإنسان مجبراً على ممارسة حياة لم يجهّزه أهله لخوضها، لأنّهم لم يعيشوا مثله. لاحظ هذا الفرد خللاً جديداً في جسمه ونفسه، ومع ذلك ظلّ مواظباً على خوض سباق السوق والعمل لأنّه لا يملك خياراً آخر ببساطة.
وفي ظلّ كلّ هذا، يشهد الكوكب تغييرات اقتصادية أثّرت في الفرد والجماعات. مع وجود المكننة والذكاء الاصطناعي، تصاعدت البطالة وفي الوقت نفسه زادت أسعار السلع، ولا سيّما في بلدان العالم الأوّل.
صار الإنسان عاجزاً عن استهلاك حاجياته الأساسية لا الكمالية، وصار يشعر بالانفصام: فهو اعتاد على دوّامة السعي نحو «الترقّي في السلم الاجتماعي والمهني». وبهذا كان يستهلك كلّ شيء وهو الآن يشعر بحالة مراجعة وجودية: هل كلّ الخيارات التي اتّخذها مدفوعاً من النظام الرأسمالي كانت تستحق كلّ هذا العناء؟
والأخطر من ذلك أنّ التغييرات التي تفرضها الرأسمالية تطال المجال الهوياتي للفرد، فتغريه بأن يغيّر نفسه جذرياً، ثمّ تجعل من هذا التغيير غير صالح نظراً إلى سرعة التغييرات العالمية، خصوصاً الاقتصادية والتشريعية.
مثال على ذلك: أعلن بايدن في أوائل ولايته الولايات المتحدة الأميركية بلاداً حاضنة ومشجّعة للحريات، ولا سيّما الجنسية، فسمح بالقانون بإدخال الجنس الثالث رسمياً والسماح له بالانضمام إلى الجيش والمدارس والمؤسسات الرسمية. كان وقع هذا القرار رائعاً للمتحوّلين جنسياً والمثليين، فاستطاعوا أن يمارسوا حياتهم بكل شفافية مثل سائر جميع المواطنين. انخرطوا في المساحة الرسمية المشتركة.
ثمّ انتخب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، وبقرار سريع، ألغى قرار بايدن وطرد تلك الفئات من المدارس والجيش وسائر الوظائف، ما أدّى إلى تدمير حياتها.
كان هؤلاء معتادين على التعامل مع وضعهم قبل قرار بايدن، إلا أنّ قراره جعلهم يتراخون في حماية أنفسهم لأنّ ذلك صار من مهمّة الدولة، فجاء قرار ترامب ضربةً قاصمة لوجودهم في هذا البلد لأنّه تمّ تجريدهم من حقوقهم المدنية وصاروا مواطنين درجة ثانية.
هذا المثال يجعل من الفرد الحديث مشكّكاً في كل وعود الرأسمالية وفي جدوى السعي وراءها، فصار واضحاً أنّها دوّامة لا تنتهي تماماً كآلة الهامستر الذي يدور من دون توقف ومن دون إدراك لسبب فعله هذا. تقلّبات الرأسمالية السريعة ستجعل الأفراد والجماعات كائنات غير مبالية، ما يضرب سبب وجود الرأسمالية. قد يكون نهاية هذا النظام ليس بالثورات والاضطرابات، بل بالاعتراض عليه بطريقة بسيطة ألا وهي: اللامبالاة!