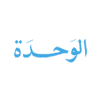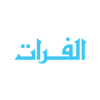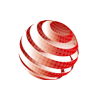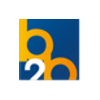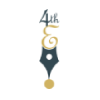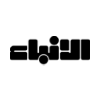اخبار سوريا
موقع كل يوم -تلفزيون سوريا
نشر بتاريخ: ٢٧ أذار ٢٠٢٥
غايتنا من هذه الورقة هو إبراز الوظيفة الدلالية والجمالية لكلّ من العنوان والتّكرار في قصيدة 'الهدهد' لمحمود درويش وذلك عن طريق دراسة بنية النّص ومحتواه الرّمزي دراسةً تحليليةً تفكيكية. إذْ أنّ العنوان هو أوّل ما يواجه دارس النصّ الأدبي، فالعنوان هو العتبة الأهمّ من بين عتبات النصّ، وهو العلامة التي تميّز نصّاً أدبياً عن آخر. وفي قصيدتنا 'الهدهد لمحمود درويش' يكتسب العنوان ميزةً إضافية كونه حاضراً على مدار النصّ، وهو الحامل الأساسي للعمل لقيامه بوظيفتيه الأساسيتين: الوظيفة الجمالية من حيث أنّ العنوان هو الباعث الرّئيس للتخيّيل والتفكير دون أنْ يكون أي تصور محدّد ملائماً له، على حسْب تعبير كانط. والوظيفة الثّانية للعنوان هي الوظيفة الدّلالية من حيث هي تسهيل للعلاقة بين النصّ ومستخدمه.
والهدهد، كما نعلم، هو ذاك الطّائر الجميل، رسول الحبّ والجمال، الذي دلّ سليمان الحكيم عل بلقيس، سيّدة سبأ، وأجمل نساء الأرض. وقد ورد ذكره في القرآن الكريم (سورة النّمل- 20). و'الهدهد' في قصيدة الشّاعر الفلسطيني محمود درويش (1941-2008) هي الكلمة – البؤرة، والدّالة الأوليّة للنصّ، وإشارته الأولى. وقصيدة 'الهدهد' تبدأ بجملة غامضة وحالمة ومتحرّكة في الوقت ذاته:
(لمْ نقتربْ من أرضِ نجمتنا البعيدةِ بعدْ)
ثمّ تتحوّل تدريجياً لتفتح أمامنا النصّ كلّه: (أسرى -ولو قفزتْ سنابلُنا عن الأسْوار وانبثق السّنونو منْ قيدِنا المكسور- أسرى ما نحبُّ، وما نريدُ، وما نكونُ)
في المقطعين السّابقين نجد أنّ الكلمات (أو ما يطلق عليه النّقاد بالوحدات الدّالة) تصطفّ لتشكّل جملاً (أو وحداتٍ دلالية) وهذا ما جعل الخطاب يسير في سردٍ منطقي يحكمه الصّوت الواحد، إلى أنْ تأتي الجملة الاعتراضية لتلعب دوراً في بتر هذا التّسلسل المنطقي بغية إدخال الصوت الآخر، وهكذا تتولّد لدينا حركية جديدة في بنية العمل يُستدل عليها من فعلي قفز السّنابل وانبثاق السّنونو. هذا الصوت الآخر الناتج عن أفعال الحركة يُمثّل المستوى الدّلالي الضمني، لكن الفاعل جدّاً، خلف المستوى الظّاهر للنّص.
مع تقدّم النّص نلحظ نكوصاً في أنا المتكلّم، إذْ ينكمشُ الفعل دون أنْ يتجاوز محيط الذّات ليذكرنا بطفولتنا المبكّرة، يقول درويش: (عادت إلينا من رسائِلنا رسائلُنا) و(من أسمائِنا نأتي إلى أسمائِنا). برأينا، فإنّ هدف هذه الجمل المرتكزة على تقنية الحركة الدّائرية، على العودة إلى نقطة البدء، هو خلق حالة الحنين للتأكيد على النزوع نحو النّكوص النّفسي.
يقول شيلينج 'إنّ ما يُميّز الشّعر في ذاته هو ما يميّز جميع الفنون، وهو تمثيل المطلق فيما هو خاصّ'. ومحمود درويش يعتمد في نصّه هذا على الأسطورة بوصفها مطلقاً، فالنصّ يميل بنا -في جوّه الملحمي- نحو فكرة المطلق الغائب، فالزمن ينقلب ليصبح ماضياً، أو مضارعاً بصيغة الماضي، في تجسيده للواحد الفرد، وفي محاولته لتقديم وجهة نظرٍ تفسيرية للصورة الإلهية، وهي في النّص تجديدٌ لصورةٍ قديمة هي الصورة المحمّدية. نقرأ: (قال: لنْ تصلوا إليه، الكلّ له والكلّ فيه، وهو في الكلّ، ابحثوا عنه لكي تجدوه فيه، فهو فيه).
وأيضاً: (لقد ههَ اللّسانُ، فكيف نمتدحُ الذي طلب المديح ومديحه فيه، وفيه الكلّ للكلّ)
وللوصول إلى هذه الصّورة يستعمل النصّ الخطاب غير المباشر، خطاب الإضافة والإنابة القابل للحذف. بينما، وللمقارنة، نجد أنّ الحسين بن منصور الحلّاج (858-922م) كان مباشراً في استناده على ذات الصّورة المحمدية في قوله:
رأيتُ ربّي بعين قلبي فقالَ منْ أنت؟ فقلتُ أنت
وهذه الفكرة، فكرة الاستلابُ تجاه الواحد الفرد عند درويش أو الحلّاج، تتكرّر دون تحديدٍ لإله أو سلطانٍ أو حبيب بمعنى أنّها قابلة لأن تُؤوّل كإلهٍ أو سلطانٍ أو حبيب. والتّشابه طبيعي، ذلك أنّ النّصوص تُشير إلى النّصوص كما تُشير الإشارات إلى الإشارات، فالنّص محكومٌ دوماً بالتّشابه مع نصوصٍ أخرى.
'الهدهد' نصٌّ مملوءٌ بأحرف النّفي، ذلك أنّ النّفي يسمح للمتكلّم بالمقابلة بين صوتين متقابلين ليشير إلى تعدّد الأصوات، وهو نصّ مليءٌ كذلك بالتّكرار، تكرار الوحدات الدّلالية (أو الجُمل)، فالتكرار يُدخل النصّ في دائرة مغلقةٍ من جهة، و'يعينه على تجميع ما تفرّق ذكره' على حدّ تعبير الدكتور صلاح فضل:
(قبلنا الطوفان، لمْ نخلع ثياب الأرضِ عنّا
قبلنا الطوفان، لمْ نبدأ حرب النّفسِ بعد، وقبلنا
الطوفان، لمْ نحصد شعير سهولنا الصّفراء بعد.
وقبلنا الطوفان، لمْ نصقل حجارتنا بقرن الكبْش بعد،
وقبلنا الطوفان، لمْ نيأس من التّفاح بعد).
إنّ تقنية التّكرار التي يستخدمها في المثال السّابق تُفيد التّوكيد، هذا إذا حمّلنا الكلمة دلالةً نحوية إضافةً إلى دلالتها الصّوتية، إنّه تكريسٌ لتصعيد النّص إلى الذّروة النّفسية، ورغم توالي التّكرارات إلّا أنّها تُمثّل سياقاً ديناميكياً، سياقٌ يُخرج النّص من ذاته وتركه لينفلت متصاعداً:
(منفى هي الأشواقُ، منفى حبّنا، ونبيذنا منفى، ومنفى
تاريخ هذا القلب).
'الهُدهُد' هو بؤرة النّص، وهذه الكلمة تنحرف بمعناها عن الكلمة المعجمية الصّلبة لتدخلَ في طور الكلمات السّائلة، الكلمات الفضفاضة القابلة لتأويلاتٍ عدّة، لذا فإنّ اختيار الهدهدَ كدليلٍ، وقرنه بعدم قدرة النّاس على الطّيران، يقابله على الصّعيد النّفسي التّوق الشّديد للحرّية، وهذا الحلم يعكس كذلك نقيضه: واقع الحرمان.
تطير 'الهدهد' في مستويين: عامودي، حيث يُمثّل الهدهد إرثاً أسطورياً مقدّساً، ومستوىً أفقي إذْ ينزل بنا من جمود النّص إلى تاريخيته في زمنٍ تصاعدي مرن.