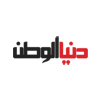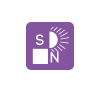اخبار فلسطين
موقع كل يوم -وكالة شمس نيوز
نشر بتاريخ: ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٥
إذا كانت خطّة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في شأن غزة، تُقدَّم باعتبارها إنجازاً دبلوماسياً أنهى حرباً طاحنة دامت لعامين، فإنها لا تمثّل، في جوهرها، نهاية للصراع، بل وقفاً مؤقّتاً لإطلاق النار، قائماً على أسس هشّة من الالتزامات المتبادلة والتنازلات غير المُعلنة والضمانات القابلة للنقض.
وعلى رغم نجاح المرحلة الأولى التي تنصّ على تبادل الأسرى - حتى الساعة -، لملامستها حاجة «إنسانية» عاجلة لدى الطرفَين، لكنّ التحدّي يبدأ الآن، حين يغيب الزخم «العاطفي»، وتطفو على السطح أسئلة لا يمكن حسمها بالبيانات والتصريحات التي ستملأ المشهد في احتفالية التوقيع على الاتفاق. فتلك، تُحسم بالقوّة والمصالح، وبالقدرة على فرض الواقع على الأرض، وهو ما تعذَّر على إسرائيل فعله طوال العامَين الماضيَين.
في قلب المرحلة الثانية من الاتفاق، وهي الأهمّ، سلسلة من الأسئلة التي لا تزال بلا إجابات واضحة، لعلّ أبرزها ما إذا كانت «حماس» ستوافق على نزع سلاحها؟ وهل الحركة وقّعت أصلاً على التزام صريح بهذا الشأن، أم أن ذلك الشرط أُدرج في نصّ غامض يَسمح بتفسيرات متعارضة؟ الواقع والمنطق يشيران إلى أنها غير معنية بتسليم السلاح، الذي لا يُعدّ مجرّد أداة عسكرية في يدها، بل هو جزء من هويّتها السياسية وشرعيتها. وعليه، فهي ستحاول «التلاعب» بمعاني نزعه، وربْطه باستحقاقات لاحقة وبالتزامات من الطرف الآخر.
بالتأكيد لا. فتل أبيب، التي لم تحقّق أهداف حربها، وفي المقدّمة منها تدمير «حماس» ومنعها من العودة إلى الحكم، لن تقبل بنتائج شكلية، بل ستطالب بإثباتات، من مثل تسليم أسلحة محدّدة، وتفكيك ورش التصنيع وبنية القيادة العسكرية. وإذا لم ترَ نتائج من هذا النوع، فلن تتردّد في اعتبار «حماس» متملّصة من الاتفاق، وستبحث عن طرق لاستئناف الضغط عليها، وذلك عبر عمليات «تحت سقف الحرب»: غارات جوية محدودة واغتيالات موجّهة أو حتى تشديد الحصار.
أمّا من ناحية التزام ترامب بضماناته، بعدما تعهّد لقطر وتركيا ومصر، وبالتبعية لـ»حماس»، بألّا تستأنف إسرائيل حربها، فإن تعهداته تبقى مشروطة وغير مُطلقة، خصوصاً أنه أضيفت إليها ضابطة: «إذا التزمت حماس»، ما يعني أنه في حال أعلنت إسرائيل أن الحركة خرقت الاتفاق، وتحديداً في ما يتعلّق بمسألة نزع سلاحها وعزْلها عن الحكم في غزة - وقد تكون تل أبيب قادرة هنا على تقديم «أدلّة» استخبارية تدعم ذلك - فسيكون لدى الرئيس الأميركي أكثر من خيار: إمّا أن يجبر إسرائيل على الالتزام وهو ما ليس مألوفاً في سياساته، أو أن يعيد تفسير التزامه، ويسمح لحليفته بـ»الردّ على الخرق». ويبدو الخيار الثاني أكثر رجحاناً، خصوصاً إذا ما وجد ترامب أن لديه مصلحة في التخلّي عن ضماناته.
وبالعودة إلى مرحلة تبادل الأسرى، تظهر مفارقات كثيرة، من بينها البند الداعي إلى استبدال الجيش الإسرائيلي بقوّة استقرار دولية يُفترض أن تضمّ جنوداً من دول مثل الإمارات وإندونيسيا والأردن، وربّما السعودية لاحقاً، تحت مظلّة «مجلس السلام». على أن هذه القوّة لا تزال حبراً على الورق، والأغلب أنه - في حال تشكيلها - لن تتمكّن من الدخول إلى غزة، من دون تفاهمات أمنية مع «حماس» نفسها.
وهكذا، فإن أيّ دولة قد ترغب في إرسال جنودها إلى القطاع، ستحتاج إلى ضمانات من الحركة بعدم استهدافها، في حين ستطالب الأخيرة باعتراف ضمني بسلطتها والتسليم بوجودها وعدم التعرّض لها. وفي الوقت نفسه، سيُطلب إلى هذه القوّة، التنسيق مع إسرائيل، التي ستطالبها بفعل ما لم تقدر عليه هي خلال الحرب، أي منع «حماس» من السيطرة وإعادة ترميم قدراتها وحكمها الفعلي لقطاع غزة.
والنتيجة المتوقّعة، هي أن القوّات الدولية ستكون موجودة شكليّاً، لكنها غير فاعلة عمليّاً، أي نسخة معدّلة من «اليونيفل»، في حين أن إسرائيل التي عانت نسبيّاً من هذا النموذج، لن تقبل بتكراره في غزة، خصوصاً إذا رأت أن هذه القوات غير قادرة على فرض سلطتها، ومضطرّة، نتيجة طلب أمان جنودها، إلى أن تسهّل على «حماس» إعادة تموضعها عمليّاً.
وإذا كانت العناوين المُعلَنة تروّج لـ»حكومة دولية» و»قوّة استقرار»، فإن الواقع على الأرض مختلف جذريّاً. فالجيش الإسرائيلي ما زال منتشراً في مناطق محدّدة من غزة، ليس كقوّة احتلال، نظريّاً، بل كطرف مكلّف بتسهيل الانتقال إلى سلطة مدنية. لكنّ هذه السلطة لم تنشأ بعد: لا «مجلس سلام» فعّال، ولا قوات دولية على الأرض، ولا حتى اتفاق في شأن مَن سيتولّى الأمن اليومي في الشوارع. وإزاء ذلك، لا تقف «حماس» متفرّجة، بل تستغلّ الفرصة؛ وهي تعمل، منذ ما قبل وقف إطلاق النار، على ترسيخ سيطرتها على كل شبر تنسحب منه إسرائيل، بما يشمل تصفية أعدائها من المتعاملين، بعدما تخلّت عنهم إسرائيل.
أيضاً، يغفل كثيرون أن الهدنة الحالية ليست انتصاراً لدبلوماسية ترامب، بل اعتراف ضمنيّ متأخر بأن الحرب فشلت في تحقيق أهدافها، على رغم كل الخسائر التي لحقت بالفلسطينيين. فإسرائيل دخلت المعركة بهدف تدمير «حماس» كقوّة عسكرية وسياسية، لكنها خرجت منها مضطرّة إلى التفاوض مع الحركة كطرف لا غنى عنه في أيّ تسوية، ما يعني أنها قبلت بالنتيجة، مرغومة. ومع ذلك، فهي لا تنوي التخلّي عن مطالبها الاستراتيجية، وإنْ كان يمكن أن تؤجّلها؛ فنزع سلاح «حماس»، ومنعها من العودة إلى الحكم، يظلّان في صلب الموقف الإسرائيلي، حتى لو تطلّب الأمر، في مرحلة لاحقة، العودة إلى أدوات القوّة.
وفي خضمّ ذلك، ليس البعد الداخلي الإسرائيلي ثانوياً، بل يُعدّ عامل تفجير محتملاً للاتفاق من الداخل، حتى لو التزمت جميع الأطراف الخارجية به. فعلى رغم أن انتخابات «الكنيست» مُقرّرة في تشرين الأول 2026، إلّا أن الاستقرار الداخلي للحكومة الحالية يبدو هشّاً جداً؛ خصوصاً أن الأحزاب المتطرّفة فيها، مثل حزبَي «الصهيونية الدينية» للثنائي إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ترى في أيّ تنازل تجاه «حماس» خيانة موصوفة، ليس لأسباب أيديولوجية فقط، بل لأن كلاً منها، شأنها شأن «الليكود»، يريد إثبات نفسه «أكثر يمينية» من الآخر، وذلك خشية فقدان قاعدته لمصلحة منافسه. فهل يضطرّ نتنياهو، تحت ضغط أميركي أو واقع ميداني، إلى قبول ترتيبات لا تقضي فعليّاً على «حماس»، سيعتبرها شركاؤه في الائتلاف انحرافاً عن الهدف المُعلن للحرب؟
في حالات كهذه، وهي متوقّعة ومعقولة جداً، قد تتسبّب المنافسة والمزايدة بدفع نتنياهو إلى اتّخاذ خطوات ذات طابع عسكري، وإنْ تحت سقف الحرب، ووضع شروط ومحدّدات إضافية لأيّ انسحابات لاحقة.
المصدر: الأخبار اللبنانية