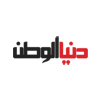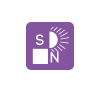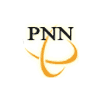اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٥
رفح هي ذاكرة عسكرية مفتوحة في الوعي الصهيوني؛ جرحٌ لم يلتئم منذ عقود، تُستعاد فيه كلّ مرّة مشاهد الفشل والارتباك والتآكل المعنوي، فكلّما توهّم الاحتلال أنه طوى صفحة الجنوب الفلسطيني، أعادته رفح إلى البداية، إلى تلك المساحة التي تتحوّل فيها القوة إلى عبء، والميدان إلى مرآة عاكسة لعجز المؤسسة العسكرية مهما غلّفت عجزها بخطاب الردع.
إعلان كتائب القسام عن استخراج جثة الضابط هدار غولدن من رفح يُمثل استدعاءً لملفٍّ مدفونٍ في الذاكرة الصهيونية، وإحياءً لتناقضاتها الأشدّ حساسية: الجندي المفقود، والبروتوكول الذي قتل صاحبه، والمدينة التي كُسرت فيها هيبة 'الهانيبال'، رفح هنا تحوّلت إلى جغرافيا الارتداد، أي المكان الذي تُفكَّك فيه منظومة الردع الصهيونية من داخلها، دون قصفٍ ولا بيانات.
منذ حرب العصف المأكول (2014)، ظلّت رفح كميناً زمنيّاً مؤجَّل الانفجار، تحتفظ بذاكرة الميدان، وتخبّئ في باطنها رموز الفشل التي يخشاها الجيش الصهيوني أكثر من أي صاروخ، فالمدينة الواقعة على تخوم التاريخ والمقاومة استطاعت أن تُعطِّل منطق النسيان العسكري، لتصبح كلّ عملية جديدة فيها تذكيراً بما لم يُحسَم بعد: ملفّات الجنود، والهزائم التي تَتنكّر بزيّ الانتصارات.
وهكذا، حين عادت جثة غولدن من رفح، لم تعد مجرّد رفاتٍ لجندي، بل شيفرة تُعيد فتح الذاكرة الأمنية المغلقة، وتؤكّد أن المقاومة لا تُقاتل في الزمن الحاضر فقط، بل تدير معركتها في ذاكرة العدو أيضًا، حيث لا هدنة ولا نسيان.
هدار غولدن؛ من الجندي إلى الرمز المأزوم
هدار غولدن لم يكن فقط ضحية مواجهة ميدانية؛ هو اختصار درامي لتقاطع خطأ استخباراتي، بروتوكول عسكري مُشكك، وكتاب يومياتٍ مفتوح لدى الجمهور، في الأول من أغسطس 2014، خلال اشتباك في رفح وساعاتٍ قليلة بعد دخول هدنةٍ مؤقتة حيز التنفيذ، قُتل غولدن وسُحب رفاتُه إلى داخل بنى تحتية تحت الأرض، ما أثار سلسلةً من المحاولات الصهيونية المُكثفة لاستعادته.
أثارت قضيّة غولدن تناقضات أخلاقية واستراتيجية حادّة في السرد المتداول، حيث وقع اعتقاله قبيل سريان هدنةٍ متّفقٍ عليها، تقول الشهادات إنه أثناء اقتراب الهدنة دخلت قوات صهيونية منطقة الاشتباك بحملة ميدانية مكثفة، ووقعت مواجهة أسفرت عن مقتله وسحب رفاتِه إلى أعماق البنى التحتية في رفح، رداً على ذلك فعّلت قيادة الاحتلال ما يُعرف بـ«بروتوكول الهانيبال»، وهو إجراء يسمح باستخدام قوة هائلة لمنع أسر جنود أو لاستردادهم، فأدت إلى موجة قصف وعمليات توغّل اعتُبرت من قِبل تقارير حقوقية ووسائل إعلام تحقيقية تجاوزاً مفرطاً في الانتهاكات، دخلت القضية سريعاً إلى قلب الخطاب العام الصهيوني، وتحولت اسماً يعرض هشاشة منظومة القرار وأخلاقيات الحرب أمام مجتمعٍ يبحث عن إجابات.
البعد العائلي والسياسي لحالة غولدن زاد من تفجّره؛ إذ لم يكن مجرد جندي عادي، هو قضية مرتبطة بقوى ونفوذ داخل الجهاز السياسي، مما حوّل مصيره إلى محور حساس يضغط على صناديق القرار ويفرض على الطبقة السياسية ردود فعلٍ علنية ومطالب محاسبة داخلية، النتيجة أن الملف الفردي تمدّد ليصبح معركة رمزية تستنفر وجدان الجمهور وتعيد فتح ملفات الثقة بالمؤسسة العسكرية.
من جندي مفقود إلى رمزٍ مأزوم: مسيرة غولدن تكشف ثلاثية الإخفاق: أولاً، ظروف أسره سلطت الضوء على هشاشة الفهم الاستخباراتي وقدرة الجهاز على قراءة الميدان بدقّة؛ ثانياً، ردود الفعل العسكرية والسياسية بينت التناقض بين خطاب الردع الرسمي ونتائج التطبيق الميداني؛ ثالثاً، تحويل ملفه إلى ورقة تفاوضية أظهر أن الزمن ذاته يمكن أن يتحوّل إلى سلاح استراتيجي، وهذه الديناميكية أطلق عليها بعض المحللين مصطلح 'شيفرة الاحتفاظ الاستراتيجي'، وهي قدرة الفاعل على تحويل رفات أو ملفات مفقودين إلى سلعة سياسية تُستثمر عبر سنوات، مما يحيل الجثة من كائن ميت إلى رمز حيّ.
باختصارٍ؛ غولدن لم يَبقَ مجرد اسمٍ في سجل المفقودين، هو صار مؤشراً على فشل استخباراتي تحول إلى ورقة تستدعيها المقاومة متى شاءت، فتُعيد افتتاح ملفاتٍ أُعتبرت منزوعةً عن طاولة النقاش، وتُذكّر المؤسسة بأن ما يُدفن ميدانياً يبقى حياً في ذاكرة الاستراتيجية والسياسة.
الهانيبال.. حين يتحول البروتوكول إلى لعنة
وُلد بروتوكول الهانيبال من رحم الذعر الصهيوني من فكرة الأسير الحيّ، إذ اعتُبر في العقيدة القتالية أخطر من القتيل نفسه، لأن وجود جندي في قبضة المقاومة يفتح باب المساومة، ويكسر صورة الجيش الذي لا يُساوَم، يقوم هذا البروتوكول على فلسفةٍ صادمة: يُمنع وقوع الجندي أسيراً مهما كان الثمن، حتى لو تطلّب ذلك قتله بنيران صديقة أو تدمير المنطقة المحيطة به بالكامل، بهذه العقلية اختُزلت قدسية حياة الجندي إلى معادلة حسابية باردة، تُجيز التضحية بالفرد لحماية صورة المؤسسة.
لكن المفارقة الكبرى تجلّت في رفح عام 2014، حين فُعِّل البروتوكول بكامل عنفه عقب أسر هدار غولدن، فانهالت القذائف والصواريخ على أحياء مكتظة بالسكان خلال ما سُمِّي 'الجمعة السوداء'، تلك اللحظة تحولت إلى نقطة انعطاف أخلاقي؛ إذ انكشف أمام العالم أن جيشاً يزعم حماية جنوده مستعد لإبادتهم إذا اقتضت الضرورة، وأن الردع الصهيوني يحمل في جوفه نواة تدميره الذاتي، فبدل أن يمنع الأسر، رسّخ الهانيبال في الوعي الصهيوني 'عقدة رفح'، وهو الخوف من التورط مجدداً في مشهدٍ يعيد للأذهان الهزيمة الأخلاقية قبل العسكرية.
على المستوى السياسي، كان الهانيبال مرآة للعقيدة الصهيونية التي تقدّس الصورة أكثر من الإنسان، وتُضحي بالجنود في سبيل الردع الشكلي، وهنا تبرز المفارقة: فكلما تمسّكت 'إسرائيل' بوحشية البروتوكول، فقدت صدقيتها أمام مجتمعها؛ وكلما حاولت التبرير أو الإنكار، تآكلت ثقة الجمهور بجيشه.
ومن هذه الزاوية، يمكن توصيف الظاهرة بما تسميه الكاتبة الهانيبال المعكوس، أي حين ترتد الأداة على صاحبها وتتحوّل من سلاح دفاعي إلى لعنة استراتيجية، لقد أصبح الهانيبال شاهداً على انهيار منطق التفوّق الأخلاقي الذي تتغنّى به 'إسرائيل'، وأصبح تفعيله في رفح إعلاناً عن انكسار المعنى في العقيدة القتالية الصهيونية، فما صُمِّم لردع المقاومة، انتهى بتكريس أسطورتها، إذ أثبتت أن من يملك القدرة على أسر الجندي يملك أيضاً القدرة على أسر منطق العدوّ ذاته.
كيف نقض القسّام منطق الهانيبال؟
لم يكن نقضُ منطق 'الهانيبال' فعلاً عسكرياً صرفاً، بل عملية تفكيك استراتيجية لمنظومة تفكير كاملة، إذ استطاعت كتائب القسّام أن تدير ملف الجندي هدار غولدن بعقلٍ بارد وطول نفسٍ استراتيجي، على مدار أكثر من عقدٍ من الزمن، في بيئةٍ مغلقة ومحاصَرة تُخترق ليل نهار بالمراقبة الجوية والإلكترونية والاستخباراتية، ومع ذلك بقيت الجندي طيّ السر، يتوارى عن أعين آلاف العيون المسلّطة على غزة، لتتحول إلى ورقة ردع مقلوبة تُدار وفق منطق المقاومة.
على المستوى العسكري، مثّل احتفاظ القسام بالجندي اختراقاً نوعياً لمعادلات الرصد والتعقّب الصهيونية، فبرغم اعتماد الاحتلال على تقنيات المراقبة فائقة الدقّة، وتكرار عملياته الخاصة لاستعادتها، لم يفلح في تحديد مكانه، وهو ما يشير إلى أن المقاومة طوّرت بنية أمنية مغلقة تتجاوز الوعي التقني الصهيوني، وتُبطل تفوّقه الاستخباراتي عبر ما يمكن تسميته بـ 'التضليل البنيوي'، أي بناء منظومة أمنية لا تكتفي بإخفاء المعلومة، بل تُحوّل المعلومة الخاطئة إلى أداة استنزاف للعدوّ نفسه.
أمّا على الصعيد النفسي، فقد شكّل الإعلان الأخير عن استخراج الجثة من رفح صفعة رمزية قاصمة للهالة العسكرية الصهيونية، إذ بدا المشهد كأن القسّام استحضر شبح هدار من بين الأنقاض ليقول لـ 'إسرائيل': ما قتلتموه أنتم بأيديكم، نحن من احتفظنا به، ونحن من نعيده في الوقت الذي نختار، هذا الفعل قلب معادلة الخوف، وجعل الجيش الذي أنشأ بروتوكول الهانيبال كي يمنع الابتزاز يعيش تحت وطأة ابتزازٍ دائم من ذاكرة فشله، فلقد تحوّل الأسير الميت إلى شاهدٍ على سقوط الهيبة العسكرية، لا في ساحة المعركة فحسب، إنّما في وجدان المؤسسة الأمنية والجمهور معاً.
إن نقض القسام للهانيبال كان انقلاباً في الوعي الصهيوني، فالمجتمع الذي تربّى على أسطورة الجيش الذي لا يُهزم وجد نفسه أمام نموذج مقاوم قادر على قلب المعادلة الأخلاقية والمعرفية في آن واحد: جيشٌ يقتل جنوده خشية الأسر، ومقاومةٌ تحفظ جثة أسيرها لسنوات وتُديرها كورقة تفاوض مقدّسة.
الارتداد الصامت داخل 'إسرائيل'
الإعلان عن استرجاع رفات هدار غولدن كان بمثابة صدمة اجتاحت المشهد الصهيوني بهدوء عاصف، لذلك أطلقتُ عليه 'الارتداد الصامت'، فهو اهتزازٌ داخلي للردع لا يواكبه اعتراف رسمي أو خطاب نزيه بالمأزق، بل يُقرأ في هزات الرأي العام، وتوتّر الصفحات السياسية، وارتباك صانعي القرار.
على مستوى الجمهور، أعاد الحدث فتح جروحٍ قديمة؛ قصص الأمهات والآباء في قوائم المفقودين عادت تطالب الكيان بإجاباتٍ لا تملكها، وصار السؤال عن: 'مَن المسؤول؟' يتردّد في وسائل الإعلام وفي المقاهي السياسية، هذا الإحياء العاطفي سرعان ما تحوّل إلى نقاشات استراتيجية، مفاوضون وقيادات يتساءلون عن جدوى بروتوكولات تُفقد المؤسسة شرعيتها بينما تحاول الحفاظ على صورة الردع.
سياسياً وعسكرياً، لم يتمكّن أي خطاب رسمي من طمأنة الجمهور؛ فقد اندفع السجال داخل البرلمان ووسائل الإعلام حول أخطاء استخباراتية، ومسؤوليات قيادية، لكن المسار الذي يتكرر هنا هو التجنّب الرسمي، فلا اعتراف صريح بالإخفاق، لا تقييمٌ شفاف، بل استبدال النقاش بغضبٍ متقطّع وتصاريح متضاربة، وهو ما يكوّن بالضبط معنى الارتداد الصامت.
دلالات ما بعد الإعلان وما وراء الجثة
عودة رفات غولدن بعد أحد عشر عاماً مثّلت إعادة ضبط لميزان الرموز في المواجهة، فعلى مستوى المعنى، تثبت أن الملفات التي تُدفن ميدانياً تبقى قابلة للاستدعاء، وأن الزمن بحدّ ذاته يمكن أن يتحوّل إلى سلاح استراتيجي، هنا يتجلّى مفهوم شيفرة الاحتفاظ الاستراتيجي، فقدرة الفاعل الذي يحتفظ بالملف على استدعائه كأداة تفاوضية أو نفسية متى شاء، ومن ثم إعادة ترتيب المستويات السياسية للخصم.
سياسياً، فتح الحدث نافذة تفاوضية جديدة، ليست بالضرورة مفاوضات علنية فورية، لكنها تغيّر وزن الأوراق. القدرة على الاحتفاظ بملف مفقود لعقد تُعيد للمقاومة قدرة مساومة أخفتها التوازنات السابقة.
جغرافياً، كرّست رفح مرة أخرى هويتها كجغرافيا الذاكرة المقاومة؛ مكانٌ لا ينسى التاريخ، ويعيد كتابة الأساطير العسكرية للخصم عبر أفعال تبدو بسيطة لكنها مؤثرة، فالاحتفاظ، الصمت، والإعلان في الوقت المناسب، هذه الجغرافيا لا تختزل في خرائط أو شوارع؛ إنها ذاكرةٌ ميدانية تمتلك قدرة على قلب معادلات الشرعية والردع.
ختاماً.. وإجابةً للسؤال المركزي: هل أصبح الهانيبال شاهداً على انهيار المنطق الذي صُمم ليحميه؟ الحدث لا يقدّم حكماً قطعياً على مستقبل العقيدة الصهيونية، لكنه يؤكد أن منطقاً قائماً على الردع بالهيبة يمكن أن ينهار من الداخل إذا لم تُرافقه شفافية، مرونة استخباراتية، وفهمٌ صحيح لطبيعة الخصم، فالهانيبال لم يمت بعد؛ لكنه صار ماثلاً كرمزٍ هشّ، ورفات غولدن صار بمثابة المرآة التي تعكس قصوره الوسِيع، وفي زمنٍ تدير فيه المقاومة ملفاتها عبر الاحتفاظ والوقت، أصبحت القوة تُقاس بمن يُحسن إدارة الذاكرة ويحوّلها إلى أداة نصرٍ مؤجلٍ يطلّ كلما ظنّ العدو أن الملف قد أُغلق.