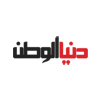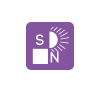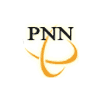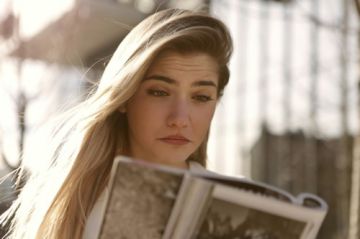اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ٣٠ تشرين الأول ٢٠٢٥
تُعدّ رؤية ابن خلدون للحروب والأخلاق إحدى الركائز الفكرية التي سبقت علم النفس الاجتماعي بمئات السنين؛ فقد قدّم في مقدمته تحليلًا ديناميًا لطبيعة السلوك الإنساني في الأزمات، وكيف تتحوّل الأخلاق الفردية والجماعية تحت ضغط الخوف والجوع والعنف.
لم ينظر ابن خلدون إلى الحرب بوصفها مواجهة عسكرية أو سياسية فحسب، بل كحدثٍ نفسي اجتماعي يختبر عمق القيم الإنسانية ويفضح هشاشتها عندما تتصدع البنى الاقتصادية والاجتماعية.
أولًا: الحرب بوصفها اختبارًا للعصبية والانتماء الجمعي
يُبرز ابن خلدون في مقدمته أن أصل الحروب هو العصبية، أي رابطة الانتماء التي تدفع الجماعة للدفاع عن ذاتها وقيمها.
'واعلم أن الحروب إنما تنشأ عن العصبية، فإذا كانت العصبية قوية كانت الحروب أشدّ وأنكى، وإذا ضعفت العصبية ضعف البأس وانهزم الناس.'
هذا التفسير يُعدّ نواة مبكرة لما يُعرف اليوم في علم النفس الاجتماعي بمفهوم التماسك الجماعي (Group Cohesion)، الذي يحدد مدى استعداد الجماعة للصمود والمخاطرة في مواجهة الخطر.
فكلما توطدت روابط الانتماء والثقة، زادت القدرة على التحمل والمقاومة، والعكس صحيح؛ إذ يؤدي ضعف العصبية إلى الانهيار النفسي قبل العسكري.
ثانيًا: التحول الأخلاقي تحت الضغط النفسي
يصف ابن خلدون بدقة كيف تُعيد الحرب تشكيل الطباع، فيقول:
'إذا تتابعت الشدائد على الناس واشتدّ خوفهم، تبدّلت طباعهم ومالوا إلى القسوة والغلظة، وذهبت عنهم المروءة والرقة.'
بهذا القول، يقترب ابن خلدون من مفهوم التحوّل النفسي تحت الصدمة الجمعية (Collective Trauma)، حيث يتراجع الضمير الجمعي أمام ضغط البقاء، وتتحول الأخلاق من قيمٍ مبدئية إلى أدواتٍ نفعية لحماية الذات.
وفي ضوء علم النفس الحديث، يمكن تفسير هذا التحول كاستجابة دفاعية متطرفة ناجمة عن تهديد الوجود المستمر.
ثالثًا: غزة نموذجًا حيًّا للتجربة الخلدونية
تشكل غزة خلال حرب الطوفان 2023 نموذجًا واقعيًا معاصرًا لما وصفه ابن خلدون قبل قرون.
فطول الصراع، وشدة القصف، وانهيار الاقتصاد، كلها عوامل أعادت صياغة المنظومة النفسية والاجتماعية للسكان.
وقد رُصدت في المجتمع الغزّي ظواهر متناقضة:
من جهة، احتكار التجار وغلاء الأسعار والنهب والأنانية، وهي سلوكيات تمثل مخرجات انحسار الأخلاق تحت ضغط النجاة.
ومن جهة أخرى، صور الإيثار والصبر والتكافل، كتقاسم الخبز والمأوى والعمل التطوعي رغم الخطر.
وهذا التناقض لا يُفسّر بالازدواجية الأخلاقية بقدر ما يُعبّر عن انقسام نفسي جمعي بين غريزة البقاء ونداء الضمير، بين ما يسميه ابن خلدون 'فساد العمران' وما يمكن أن نطلق عليه اليوم 'صمود الوعي الأخلاقي'.
من هذا المنظور، لا يمكن النظر إلى سلوكيات النهب والاحتكار في غزة كظواهر فردية، بل كدلائل على تآكل البنية التنظيمية للأخلاق العامة بفعل الحرب الممتدة، حيث يختفي الرادع المؤسسي، وتضعف سلطة القانون، ويتحوّل الاقتصاد إلى اقتصاد نجاة.
رابعًا: الحرب النفسية والفساد الأخلاقي
لقد أدرك ابن خلدون أن الهزيمة الأخلاقية تسبق العسكرية، فقال:
'المغلوب مولع أبدًا بتقليد الغالب في شعاره وزيه وسائر أحواله.'
وفي سياق الحروب الحديثة، يمكن قراءة هذا القول بوصفه توصيفًا مبكرًا لما يُعرف اليوم بـ الاستلاب الثقافي والنفسي، حيث يُهزم الوعي الجمعي أمام النموذج الأقوى أو الأغنى، فيتبنى سلوكياته حتى في لحظة مقاومته.
وفي الحالة الغزّية، تتجلى الحرب النفسية في محاولة تفكيك القيم المجتمعية من الداخل؛ عبر إشاعة الأنانية، وتفجير الغضب الاقتصادي، وتحويل معاناة الناس إلى منافسة على الموارد، بحيث يتحوّل الصراع الأخلاقي إلى صراع بقاء مادي.
هنا نلمس التقاءً عميقًا بين الفكر الخلدوني ومفاهيم علم النفس السياسي المعاصر، الذي يرى أن الحروب لا تُدار فقط بالنار والحديد، بل أيضًا بإضعاف الوعي الأخلاقي للمجتمعات المستهدفة.
خامسًا: من العنف إلى الترف.. الدائرة النفسية للحضارة
يؤكد ابن خلدون أن استمرار الحروب يُنتج القسوة، بينما يؤدي السلام المترف إلى التراخي والانحلال، قائلاً:
'إذا ألف الناس الغارة والسلب، صارت مكاسبهم من غير وجهها، وفسدت أخلاقهم.'
'الترف مؤذن بخراب العمران، لأن النفوس تألف الدعة وتكره الشدة.'
بهذا يقدّم ابن خلدون دورة حضارية نفسية، تبدأ بالعصبية وتنتهي بالترف، مرورًا بمراحل من التحول الأخلاقي الذي يحكم مصير الأمم.
وفي ضوء علم النفس الاجتماعي الحديث، يمكن القول إن المجتمعات الخارجة من الحرب تمرّ بمرحلتين متقابلتين:
1. مرحلة القسوة المبررة، حيث تصبح النجاة أولوية مطلقة.
2. مرحلة التراخي الأخلاقي، حين يُستبدل التضامن بالأنانية بعد انتهاء الصراع.
سادسًا: نحو قراءة خلدونية للوعي الجمعي في غزة
إن فهم السلوك الجمعي في غزة اليوم لا يمكن فصله عن الإطار الخلدوني الذي يربط بين البيئة السياسية والاجتماعية والأخلاق.
فما نشهده من تراجع في الضمير الاقتصادي، واحتكارٍ جشعٍ من بعض التجار، وانحسارٍ للتكافل في فترات، هو انعكاس لخللٍ في العصبية الجامعة التي كانت تحكم البنية الاجتماعية للمجتمع الغزّي.
ومع كل ذلك، يبقى وجود النماذج الأخلاقية العالية — من تضحية وصبر وإيثار — دليلًا على أن العصبية لم تمت، بل تمرّ بامتحانها الأشد.
إنّ الحرب، في ضوء الفكر الخلدوني، ليست فقط صراعًا على الأرض، بل معركة على نظام القيم والمعنى.
فإذا صمدت الأخلاق، بقي العمران وإن تهدم الحجر؛ وإذا انهارت، فذلك إيذان بخرابٍ نفسي وحضاري لا يُجبر بسهولة.
خاتمة
لقد سبق ابن خلدون علماء النفس والاجتماع حين ربط الحرب بالتحولات النفسية والأخلاقية، وبيّن أن فساد الأخلاق لا ينتج عن الانحطاط الذاتي فقط، بل عن تغير البيئة وضغط الحاجة واضطراب العمران.
واليوم، في ظل حرب الطوفان 2023، تتجلّى دراسته للحرب كمرآة دقيقة لواقع غزة، حيث تُختبر القيم في أقسى الظروف، ويتواجه الإنسان مع نفسه قبل عدوه.
إن استعادة القراءة الخلدونية في زمن الحرب لا تعني استحضار الماضي للتبرير، بل لفهم آليات التحلل والصمود معًا، وإعادة بناء الضمير الجمعي على أسس العدالة والمشاركة والمساءلة — وهي، في جوهرها، مفاتيح البقاء الأخلاقي لأي أمة.