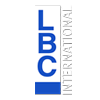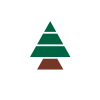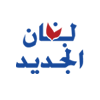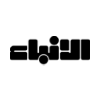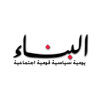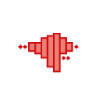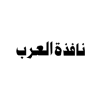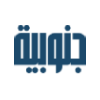اخبار لبنان
موقع كل يوم -جريدة اللواء
نشر بتاريخ: ٢٤ أيلول ٢٠٢٥
البروفيسور حسن الموسوي*
في بلدٍ يقاس فيه منسوبُ الأمل بسعر الصرف، صار التصنيف الائتماني للبنان بمثابة مِقياس حرارة علني للثقة. تُصدره جهاتٌ تعرفها الأسواق جيداً Moody’s موديز وStandard Poor’s S&P ستاندرد آند بورز وFitch Ratings فيتش. وكلما ارتفعت حرارة الشك، بردت القروض وابتعدت الاستثمارات، وتحوّل البلد في نظر المستثمر إلى مخاطرةٍ لا تُحتمل. خلال عقدٍ واحدٍ فقط تبدّل المشهد اللبناني من تصنيفٍ مقبول نسبيًّا إلى قاع الانهيار، ثم لمّعت التطورات القانونية أخيراً زجاج المرآة قليلاً من غير أن يتغيّر الجدار خلفها: تحسّنٌ طفيف لدى S&P إلى CCC في عام 2025، لكنه تحسّنٌ مشروط ومحدود الأثر، لأنّه يرتبط أساساً بالأدوات المقوّمة بالليرة - مثل سندات الخزينة - فيما أزمة السيولة بالدولار على حالها. تأتي هذه الإشارة على وقع تشريعاتٍ إصلاحية كـقانون رفع السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة المصارف المُقرّ في 31 تموز/يوليو، مع توقّع صدور قانون الفجوة المالية قبل نهاية السنة؛ وكلّها مؤشراتٌ تُقرأ كبداية مسار لا كخاتمٍ سحري. وتتعزّز الحزمة التشريعية بتفعيل قانون إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء (القانون 462/2002) عبر تعيين مجلسها بعد أكثر من عقدين من التعطيل؛ وهي خطوة طالما طالبت بها جهات التمويل الدولية، وعدّتها شرطاً لازماً للتمويل، الغاية منها سحب القرارات التقنية من التجاذب السياسي وتكريس حوكمة أكثر استقلالاً، في إطار مسار إصلاحي شامل.
جذور الانهيار: تراكم لا صاعقة
الطريق إلى هنا لم يكن مفاجأة برقٍ في سماءٍ صافية. لقد كان الانهيار حصيلةَ تراكمٍ مُنهِك بدأ قبل سنوات: دينٌ عامٌ تخطّى 90 مليار دولار وتجاوز 150% من الناتج المحلي، وعجزٌ ماليٌّ مزمن تغذّيه إيراداتٌ ضريبية ضعيفة ونفقاتٌ جارية تتضخّم بلا إصلاح، ومنظومةٌ مصرفية تشابكت عضويًّا مع الدَّين العام ومع البنك المركزي، حتى صار سقوط أحدها يجذب الآخر معه إلى القاع. حين تهافتت الاحتياطات الأجنبية تحت وطأة سياسات دعم غير مُستدامة، انفجر ما كان مكبوتاً في الحسابات؛ ولمّا جاءت لحظة الحقيقة في آذار/مارس 2020، أعلنت الدولة عجزها عن سداد سندات اليوروبوند، فتغيّر اللقب الرسمي بسرعة إلى تعثّر انتقائي، واندفع البلد إلى المنطقة الرمادية التي لا يُفضّلها أحد.
من الأرقام إلى الحياة اليومية
المفارقة أن الأثر الأشدّ لم يكن ماليًّا فحسب. عندما يفقد بلدٌ ما قدرته على الدَّين بالعملة الصعبة، تتقلّص خياراته في تمويل العجز والاستثمار العام، وتنعكس الأرقام المجرّدة على الحياة اليومية؛ قدرة شرائية تتآكل، ومدّخرات تُحبَس في نظامٍ مصرفي مأزوم، وخدمات عامة تسير ببطءٍ لا يوازي حاجة الناس. بعبارةٍ أكثر مباشرة؛ ليست التصنيفات سطوراً في تقارير مقرّرين، بل نتائج ملموسة يلمسها المودعُ في مصرفه، والمستثمر في حساباته، والمستهلك في فاتورة سلّته. وما دام لبنان خارج الأسواق المالية بشروطٍ معقولة، فإن كلفة الاقتراض - إن توافرت - ترتفع تلقائياً، والحلقة تضيق أكثر فأكثر. هنا يصبح إصلاح القطاعات المُنفلتة شرطاً لفتح الأبواب؛ وفي المقدّمة قطاع الطاقة الذي يمتصّ جزءاً كبيراً من عجز المالية العامة، إلى جانب تهدئة الجبهة النقدية وتوحيد سعر الصرف ونشر موازناتٍ دقيقة في مواعيدها لتطمين الداخل قبل الخارج.
ما حجم التحسّن فعلاً؟
لكن كيف تُقرأ إشارة CCC الجديدة إذاً؟ يجدر وضعها في حجمها الطبيعي: خطوة صغيرة في اتجاهٍ صحيح، لا أكثر. تشريعاتٌ أُقرّت وأخرى على الطريق تولّد انطباعاً أوليًّا بأن هناك إرادةً للانتقال من إدارة الأزمة إلى محاولة معالجتها. غير أنّ الأسواق لا تكافئ النيّات بقدر ما تكافئ التنفيذ. لذلك يظلّ وزن هذه الإشارة محصوراً في الشقّ السيادي المقوّم بالعملة الوطنية - حيث هامش التحرّك أكبر - فيما يبقى شقّ العملات الأجنبية رهينة معادلةٍ أصعب؛ استقرار نقدي حقيقي، ومصادر سيولة خارجية، وثقة لا تُستعاد بالشعارات.
السياسة قبل الحساب
في الخلفية، يتقدّم سؤالٌ سياسيٌّ بامتياز؛ ما قيمة أي خطوة مالية إذا ظلت المؤسسات معطّلة، والقرار الاقتصادي أسير تنازعٍ لا ينتهي؟ التصنيف لا يقيس الأرقام وحدها؛ إنه يقرأ البيئة التي تشتغل فيها تلك الأرقام. بلدٌ نجح مثل اليونان لم ينتصر بالأرقام وحدها بل بتوافقٍ سياسي على برنامجٍ صعب واستفادةٍ من دعمٍ خارجي مُنظَّم، فيما تجارب كـالأرجنتين ظلّت تتعثّر لأن السياسة هناك تُبدّل وجهتها أسرع مما تُبنى الثقة. وعلى مقربةٍ من المنطقة، تُظهر قبرص كيف يمكن لبرنامجٍ صارم أن يعيد الثقة خلال سنوات قليلة عندما تتوافر الإرادة وتُحترم خارطة الطريق. المغزى واضح؛ الإصلاح الاقتصادي قصة قرارٍ سياسي قبل أن يكون قصة أرقام.
جراحة المصارف: إطار إعادة الهيكلة
هنا تتضح مركزية النظام المصرفي في المشهد اللبناني. لا اقتصاد بلا وسيطٍ مالي سليم، ولا ثقة بلا مصارف قادرة على تمويل النشاط الإنتاجي بدل تمويل العجز. لهذا يتعامل التشريع الجديد مع المصارف كما يتعامل الجرّاح مع مريضٍ دقيق: تقييمٌ مستقلّ تُشرف عليه لجنة الرقابة على المصارف بالاستعانة بخبراتٍ داخلية وخارجية ومعايير دولية، على أن يتحمّل مصرف لبنان كلفة التقييم، ثم تصنيف لكل مصرفٍ على حدة يحدّد مصيره: من الاستمرار مع إعادة رسملة، إلى معالجة داخلية/هيكلة بنيوية، وصولاً إلى التصفية أو الدمج حين يكون النزف أكبر من قدرة الجسد على احتماله. الفكرة بسيطة وقاسية في آن: لا يمكن تأجيل الاعتراف بالخسائر إلى ما لا نهاية.
سقف السيادة وسلاسل المصارف
ومع أنّ عبارة Sovereign Ceiling السقف السيادي» لا تَرِد في النصوص الرسمية كثيراً، إلّا أنّ واقعها معروف في الأسواق؛ تصنيف المصارف عادةً لا يتجاوز تصنيف دولتها لأنها تعمل داخل بيئتها القانونية والنقدية وتتحمّل مخاطرها المباشرة. في لبنان، حيث تعاظمت حيازات المصارف من Sovereign Bonds السندات السيادية والودائع لدى البنك المركزي في سنوات ما قبل الانهيار، جاء التخلّف السيادي عن السداد كضربةٍ إضافيةٍ لميزانياتها. لذلك بدا مسار التعافي المصرفي رهينةَ مسارين معاً: مسارٍ تشريعي يُنهي حالة التعويم، ومسارٍ سياسي واقتصادي يعيد النمو ويستقر عبره النقد ويُعاد ترتيب الأولويات المالية. وما دامت الحلقة محكومةً بهذه الثنائية، فإن نجاح قانون إعادة الهيكلة يقاس بقدرته على نقل القطاع من تمويل الدولة إلى تمويل الاقتصاد الحقيقي، بحيث يتحوّل من طرفٍ في المشكلة إلى أداةٍ في الحل.
استقرار النظام لا تثبيت الرقم
يبقى السؤال العملي: من أين تبدأ رحلة استعادة التصنيف إذا لم تكن إشارات CCC كافية وحدها لإقناع الأسواق؟ الجواب المباشر: من حيث تُبنى الثقة. المقصود ليس تثبيت السعر على طريقة التسعينيات، بل تثبيت النظام عبر سياسة نقدية واضحة، وضبط تمويل العجز، وتوحيد أسعار الصرف على قاعدة واقعية لا على رغبات. حينها فقط يصبح لأي حديثٍ عن الاستثمارات الأجنبية معنى، ولأي استعدادٍ لدى المانحين والدائنين مكان. هذا هو «الحدّ الأدنى» الذي تعترف به الأسواق قبل أن تبدأ بحساب فوائدها على ورق.
كيف يترجم ذلك في الأشهر القليلة؟
على الأرض، يحتاج المواطن إلى معنىً مباشر لكلّ ذلك. ما الذي يعنيه أن تتحسّن مرتبة لبنان درجةً أو درجتين؟ يعني أولاً أن كلفة خدمة الدين قد تتراجع إن عاد البلد إلى الأسواق بشروطٍ مقبولة؛ ويعني ثانياً أن شركاتٍ كانت تُحجم عن الاستثمار قد تعود لتختبر المياه؛ ويعني ثالثاً أن المصارف - بعد إعادة هيكلتها - تستطيع أن تخرج من نومٍ قسري إلى وظيفة الوساطة الائتمانية كما يجب أن تكون. لكن هذه النتائج مشروطة كلها بأن لا يكون التحسّن على الورق فقط. تشريعات بلا تطبيق لا تغيّر مزاج المصارف المراسلة، ومؤتمرات مانحين بلا متابعة لا تُنشئ سيولةً جديدة، ووعودٌ بلا جدولٍ زمني لا تُحرّك رافعة الثقة.
«صندوق النقد» كإشارة ثقة لا عصا سحرية
ضمن هذا الإطار، لا مفرّ من التعامل بواقعية مع صندوق النقد الدولي. ليس لأنّه يحمل عصاً سحرية، بل لأنّ الاتفاق معه يشكّل إشارة ثقة متعارفاً عليها في الأسواق. اتفاقٌ واضحٌ ومُلزِم يفتح أبواب تمويلٍ مشروط ويُرشد السياسات العامة، ويجعل المُقرضين يتعاملون مع دولةٍ تسير وفق خريطة طريقٍ متّفق عليها، لا وفق تبدّل المزاج السياسي في كل منعطف. التجارب المحيطة - من قبرص إلى اليونان - تُظهر أنّ البرامج القاسية قد تكون كريهةً في المدى القصير لكنها، متى وُضعت موضع التنفيذ، تسمح بإعادة تَسعير المخاطر تدريجياً، وهذا هو جوهر التصنيف الائتماني: كيف ترى الأسواق مخاطرك بعد الإصلاح لا قبله.
نقطة المقاومة وكلفة التأجيل
لا يعني ذلك أن الطريق مفروشةٌ بضمانات. في كل مسار إصلاحي توجد «نقطة مقاومة»: لحظة يَظهر فيها أن تكاليف التغيير أعلى من مكاسب بقاء الوضع كما هو. تتجسّد هذه النقطة في المصارف التي قد تَرى في الاعتراف بالخسائر تهديداً وجودياً، وفي قطاعاتٍ مترابطة مع الدولة تخشى فقدان امتيازاتٍ قديمة، وفي طبقاتٍ سياسية تخاف من خسارة رأس مالها الرمزي لدى جمهورها. غير أنّ تجارب الأرجنتين، مثلاً، تؤكد أن تأجيل الألم يضاعف كلفته لاحقاً، وأن غياب الاستقرار السياسي يجعل أي تحسّنٍ مؤقّت مجرّد هدنة قصيرة. المغزى المحلي واضحٌ أيضاً: كلّ تعطيلٍ سياسي يُترجَم فوراً في لغة التصنيف، لأنّ المستثمر لا يقيس فقط قدرة البلد على الدفع، بل يقيس كذلك قدرة مؤسساته على اتخاذ القرار وتنفيذه.
ثلاث بوابات للقطاع المصرفي
وعند تفكيك مشهد المصارف من الداخل، تظهر ثلاث «بوابات» لا بدّ من عبورها:
الأولى، تقييمٌ شفاف يُخرج الأرقام من الغرف المغلقة إلى الضوء، وهو ما ينصّ عليه إطار إعادة الهيكلة عبر لجنة الرقابة.
الثانية، قرارٌ واضح بمصير كلّ مصرفٍ بناءً على هذا التقييم: إمّا الاستمرار مع إعادة رسملة، أو المعالجة الداخلية/إعادة الهيكلة البنيوية، أو التصفية/الدمج.
والثالثة، خارطةُ تمويلٍ تُمكّن المصارف القابلة للحياة من تمويل القطاعات الإنتاجية بدل الاكتفاء بسندات الدولة أو ودائع المصرف المركزي. إن لم تُفتح هذه البوابات معاً، فلن يُجدي تبديل الأقفال شيئاً.
إشارات صغيرة تغيّر الاتجاه
في نهاية المطاف، لا تبحث الأسواق عن كلماتٍ كبيرة بل عن إشاراتٍ صغيرة متتابعة: إعلانُ أرقامٍ دقيقة في مواعيدها، جدولٌ نقدي يُحترَم، قوانين تُقرّ وتُطبّق من غير استثناءات، مسارُ خصخصةٍ مدروسٌ في قطاعاتٍ محدّدة لا يَمسّ العدالة الاجتماعية، وبيئةُ أعمالٍ تخفّف كلفة الإجراءات على المستثمر المحلي قبل الأجنبي. بهذا فقط تنتقل البلاد من «إدارة الانهيار» إلى «إدارة التعافي». ولهذا تحديداً تبدو جملة «إصلاح القطاع المصرفي ضرورة وطنية» أكثر من شعار؛ فهي خلاصة تجربة دولةٍ اكتشفت أن الاقتصاد بلا وسيطٍ مالي سليم، كالجسم بلا شرايين. إذا بقي هذا القطاع على حاله، سيبقى كلّ إصلاحٍ اقتصادي ناقصاً؛ وإذا أُعيد بناؤه على قواعد الشفافية والحوكمة، سيصبح رافعةً للتعافي بدل أن يكون عبئاً عليه. المسؤوليات هنا موزّعة بوضوح: الدولة بخططها وشفافيتها، مصرف لبنان» بسياساته ومعاييره، المصارف باعترافها بالخسائر والتزامها الهيكلي، السلطتان التشريعية والقضائية بقدرتيهما على تشريعٍ مُحكَم وتطبيقٍ صارم، والشركاء الدوليون بدعمٍ مشروطٍ بجدولٍ واضح. عند هذا التقاطع فقط، يبدأ منحنى التصنيف بالانعطاف صعوداً.
اختبار الثقة لدى الناس
لا يحتاج القارئ إلى وعودٍ معلّبة كي يصدّق إمكان التغيير. يحتاج إلى مؤشراتٍ ملموسة في الأشهر القليلة المقبلة تُثبت أن ما كُتب في القوانين ليس حبراً جديداً على ورقٍ قديم. حين يرى أن الحكومة تنشر أرقامها بانتظامٍ وبلا فجوات، وأن المصارف التي لا تستطيع النهوض تُسلَّم إلى من يستطيع، وأن الكهرباء - هذه العُقدة الكلاسيكية - بدأت تتراجع كلفتها على المالية العامة، وأن سعر الصرف يتّجه إلى استقرارٍ معقول بدل القفزات الحادّة؛ حينها فقط يصبح للتصنيف معنى جديد لدى الناس، لا لدى التقارير. أمّا إن بقي كلّ شيء مؤجّلاً، فستبقى كل إشارات التحسّن «خبراً» صغيراً لا يغيّر مسار الصفحة.
خاتمة: من إدارة الانهيار إلى إدارة التعافي
هذا باختصار هو الفارق بين بلدٍ يُدير صورته وبين بلدٍ يُغيّر واقعَه. تستطيع أن تمنح الدرجة التي تراها مناسبةً بحسب معاييرها، لكن الذي يمنح الثقة - ويستعيدها - هو التنفيذ. وعندما يُعاد وصل السياسة بالاقتصاد على قاعدة المسؤولية، يصبح الطريق معروفاً: استقرار نقدي واقعي، طاقةٌ لا تبتلع ميزانية الدولة، مصارفُ تموّل الإنتاج بدل الدَّين، وعدالةٌ تُطمئن دافع الضرائب والمستثمر معاً. عندئذٍ فقط، يتراجع الكلام عن «الانهيار» إلى حاشيةٍ تاريخية، ويعود الحديث إلى ما هو أهم: كيف نضمن ألّا نعود إلى هنا مجدداً.
* أستاذ جامعي وخبير في الشؤون المالية والاقتصادية