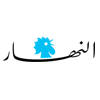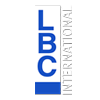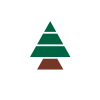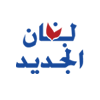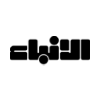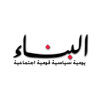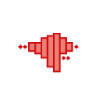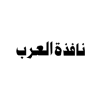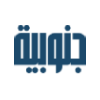اخبار لبنان
موقع كل يوم -جريدة اللواء
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٥
يقدّم الفنان البحريني «خليفة الشويطر» القدس ككائن حيّ يتنفس بين السماء والأرض، بين المهد والمحراب، بين طفلٍ يمدّ يديه نحو النور، ومدينةٍ ترفع ذراعيها كأمّ تحتضن أبنائها في الغياب. فثمّة لوحات تُرى بالعين، وأخرى تُرى بالقلب. هذه اللوحة تنتمي إلى الصنف الثاني، حيث يتحوّل اللون إلى نَفَس، والخط إلى دعاء، والظل إلى ذاكرة. فالمشهد لا يُقرأ من الأعلى إلى الأسفل فحسب، بل من الداخل إلى الخارج و من القلب الذي يخفق في قبة الصخرة إلى صرخة الوليد عند الجدار، بينهما الكوفية التي تحوّلت من قطعة قماش إلى خريطة روحية لوطنٍ لم يغِب إلّا في الجغرافيا. فهل سر تكوين اللوحة في هندسة المعنى عبر عمود الضوء؟
لوحة مبنية على محور عمودي صارم من الطفل الصغير في الأسفل، مروراً بالكوفية التي تشكّل الجسد، وصولًا إلى قبة الصخرة التي تمثل الرأس، فالضوء السماوي في الأعلى. هذا المحور ليس صدفة، بل هو رحلة صعود الإنسان من العجز إلى الوعي، من الطين إلى النور، من الأرض المسجونة إلى السماء المفتوحة. إنها حركة عمودية تشبه صلاةً مرسومة بالفرشاة؛ صلاةٌ تبدأ بيدين صغيرتين ترتجفان في أسفل اللوحة، وتنتهي بذراعين مفتوحتين في الأعلى كجناحين ينتظران البشارة. فهل تدرّج الألوان من القاع إلى القمة يعكس حركة روحية خالصة، من ظلمة الأرض إلى صفاء السماء. وكأن الفنان أراد أن يقول: «كل طريقٍ إلى النور يمرّ أولًا بالظلام.؟ وهل الثنائية اللونية ليست مجرد تباين بصري، بل معادلة فلسفية بين الوجع والفداء، بين الخراب والمعنى الإنساني؟ وهل الكوفية ليست زينة حول القبة، بل جسد الأمة؟
يُدرك خليفة الشويطر أن البنية التشكيلية ليست مجرد توزيع للعناصر، بل بناء فلسفي للوجود. فالتوازن المتماثل بين اليدين، وتوسّط القبة، وامتداد الكوفية، كل ذلك يخلق نظاماً بصرياً يوحي بالثبات والقداسة، وكأن اللوحة بأكملها هي جسد القدس القائم في وضع الصلاة. كما نسج الشويطر خطوط الكوفية بطريقة تجعلها أشبه بخلايا حيّة، كل خيط فيها نبض، كل عقدة شهيد، كل مربع ذاكرة بيت أو زقاق. بهذا المعنى، الكوفية لم تعد قطعة قماش بل تحوّلت إلى جلد الوطن، إلى جلد الإنسان الفلسطيني الذي حمل على كتفيه القدس والغياب معاً. فهل الطفل هو البذرة التي لم تمت؟ وهل الطفل عارياً إلّا من حفاضٍ أبيض، رافعاً يديه إلى الأعلى في حركة تشبه الصلاة أو النداء؟
الطفل هنا هو البراءة التي تواجه المستحيل، وهو تجسيد للجيل الذي وُلد في المخيمات لكنه لا يرى الجدار نهاية الطريق. يرفع يديه لا استسلاماً، بل استدعاءً للنور. كأنه يقول للعالم: «أنا لم أولد لأبكي، بل لأرى». بذلك يضع الفنان الطفل في الظلّ ليعزز التناقض بين ضعف الجسد وقوة الروح، بين صغر الحجم وضخامة المعنى. إن الطفل في اللوحة هو المستقبل نفسه، وهو وعد الأجيال الذي لا يموت مهما اشتدّ الليل. وإلى جانب الطفل، يتدلّى مفتاح على الجدار وهو رمز العودة الأقدم في الذاكرة الفلسطينية. كما أن القبة تتجاوز دلالتها الدينية لتصبح رمزاً كونياً للنور في مواجهة الظلام، وللثبات في وجه العاصفة. والجدار في اللوحة لا يُغلق الأفق تماماً؛ فالفنان تركه مفتوحاً للأعلى، وكأن الرسالة واضحة: «حتى لو سُدّت الطرق الأرضية، فباب السماء لا يُغلق». وهذا الانفتاح نحو الأعلى يمنح اللوحة بعدها الروحي، ويحوّل المأساة إلى رجاء. فهل هذا التشخيص البصري للقدس يجعلها كياناً إنسانياً ذا مشاعر، تتألم وتدعو وتنتظر أبنائها؟
دلالة إنسانية شاملة في هذه اللوحة من الجرح الفلسطيني إلى الجرح الكوني وعلى الرغم من أن الرموز كلها فلسطينية الهوية، فإن الطفل يمكن أن يكون أي طفل مظلوم في العالم، والقبة يمكن أن تكون أي معبد مقدّس، والكوفية يمكن أن تكون أي وشاح يلتف حول جرح الإنسانية. وهكذا تتحوّل اللوحة من شهادة محلية إلى بيانٍ كوني عن الكرامة والحرية والإيمان بالعودة. فهل هذا الفن يتجاوز السياسة، ليغدو مرآة للإنسان في بحثه الأزلي عن بيتٍ، عن أمٍّ، عن سلام؟ وهل اللوحة تنسج حواراً عميقاً بين المقدّس والإنساني؟ أم تتحوّل القدس من مكانٍ محتَلّ إلى معنى مُتحرّر، ومن حجرٍ صامت إلى كائنٍ حيٍّ يقول لنا: «ما زلتُ هنا... ما زلتُ أتنفّس فيكم».