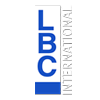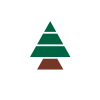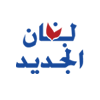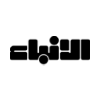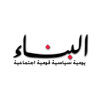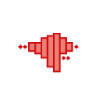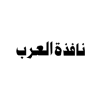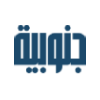اخبار لبنان
موقع كل يوم -جريدة الديار
نشر بتاريخ: ٢ أيار ٢٠٢٥
في مرحلةٍ وطنية مثقلة بالتصدّع والقلق والانهيار المتعدّد الأوجه، أعلنت وزيرة التربية إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامّة في تموز 2025، من دون مواد اختيارية، مع تقليص خجول للدروس، وإلغاء علامات الاستلحاق، في عام دراسي بدأ فعليًا في كانون الثاني لأكثر من نصف طلاب لبنان. القرار، الذي طُرح كأنه 'علمي ومحايد'، جاء وسط أزمات متشابكة: الحرب، النزوح، الانهيار الاقتصادي، والفاقد التعليمي، وبدا كأنه عودة إلى تقويم تقليدي صارم في توقيت يفتقر فيه المعلم والطالب إلى مقومات الاستقرار، ما أثار صدمة واعتراضات واسعة.
الوزيرة، ذات الخلفية كباحثة إجرائية، برّرت قرارها بتحليل استبيانات ودراسة ميدانية أعدّها المركز التربوي، وربما أرادت بخطوتها ترسيخ معايير تعيد هيبة الشهادة الرسمية بعد أعوام من التعديلات الطارئة. لكن الإشكال لا يكمن في الهدف، بل في التوقيت والسياق والطريقة. فقد اختارت لحظة خاطئة لإعادة صلابة شكلية، متجاهلة انهيارًا تربويًا واجتماعيًا عميقًا، ومتسلّحة بمنهجية 'إجرائية' صارت غطاءً تقنيًا لإصلاحٍ فوق الركام. القرار تجاهل واقعًا ميدانيًا مريرًا: طلاب مهجّرون، مدارس مدمّرة، معلمون مثقلون، وبيئة مفككة، خصوصًا المناطق الحدودية والقرى المنكوبة، حيث الجاهزية منعدمة، فجاءت 'النية الإصلاحية' عبئًا إضافيًا لا رافعة.
لذلك يتساءل كثر من التربويين والأهالي والنواب: هل يُبنى قرار كهذا على قراءة موضوعية فعلًا، في ظل غياب الزيارات الميدانية وتجاهل الشهادات الحيّة من المناطق المنكوبة؟ وهل تُختزل العدالة التربوية في جداول مكتبية؟ هل يكفي البحث الإجرائي لتبرير سياسات تمس مصير آلاف الطلاب؟ هل تتحوّل النوايا الإصلاحية إلى عدالة إذا أُسيء توقيتها؟ أم تُستخدم لشرعنة قرارات متسرّعة؟ هل يُقاس القرار بسلامته الشكلية، أم بعدالته وسياقه وشرعيته المجتمعية؟ وهل استند القرار إلى معطيات موضوعية، أم جاء نتيجة ضغوط من جهات مؤثرة ولو على حساب الإنصاف؟ وهل يُعقل، باسم 'هيبة الشهادة'، تجاهل معاناة الطلاب؟ أم أن التربية في الأزمات تتطلب عدالة مضاعفة، لا صرامة عمياء؟
توقّع كثيرون من وزيرة ذات خلفية بحثية أن تحمل معها روح البحث الإجرائي الحقيقي: الانخراط الميداني، التكيّف، والإنصات للمتأثرين. لكن ما حدث كان العكس: تجاهل ميداني شبه تام، وإصرار على خطاب رسمي يلمّع الواقع بأدوات نمطية كـ'نسبة الإنجاز' و'عدد الحصص'. هذا الانتقال من البحث التشاركي إلى البيروقراطية يُظهر كيف يتحوّل العلم، إلى أداة تبرير. فالبحث الإجرائي، في جوهره، يدمج الممارسة بالتقويم، ويُفترض أن يكون حساسًا للسياق، قائمًا على قراءة تشاركية. لكن في تجربة الوزارة، بدا الاستخدام شكليًا: استبيانات سطحية، تحليل تفاوتات، دون انخراط ميداني أو تفاعل حقيقي مع الواقع. فهل يُقاس البحث الإجرائي باستبيانات إلكترونية، أم بالمشاركة الميدانية والإنصات وتعديل المسارات وفقًا لسياق الواقع؟ لذلك رأى كثيرون أن ما حصل ليس إصلاحًا، بل تمويه شكلي يُمارس فوق جثة النظام التعليمي. الوزيرة، بدلًا من النزول إلى الميدان، اكتفت بلقاءات في الوزارة وقراءات مجتزأة لبيانات غير ممثّلة. والنتيجة؟ قرار موحّد يساوي بين طالب في منطقة آمنة، وآخر نازح فقد أحبّاءه، ويتعلّم بصعوبة عبر الشاشات.
من منظور النظرية البنيوية (Structuralism) كما طوّرها بيار بورديو، يمارس قرار الوزيرة ما يُعرف بـ'العنف الرمزي'، حين يفرض على الفئات المتأثرة بالحرب (طلاب الجنوب والبقاع والمناطق المتضررة) شروطًا موحّدة تُفترض عادلة، لكنها تُخفي التفاوت الاجتماعي وتكرّس التمييز في فرص التعلّم والوصول إلى المحتوى. فرض المنهج ذاته على جميع الطلاب، مع تجاهل الانقطاع والنزوح والمعاناة، لا يحقّق المساواة، بل يكرّس شكلًا خفيًا من الظلم المؤسسي. أما التقليص الخجول للدروس، فلا يُعدّ تكيّفًا تربويًا ولا يخفّف العبء، بل يمثل تمييزًا مقنّعًا (Institutional Discrimination)، حين تُفرض معايير موحّدة على طلاب عاشوا ظروف النزوح والخسارة، ويُطلب منهم التنافس مع من تلقّى تعليمًا مستقرًا.
ببساطة، قرار الوزيرة يتناقض مع أبسط المبادئ النفسية والسلوكية، في هرم Maslow، الذي يضع الأمان النفسي والاجتماعي والاستقرار شرطًا للتعلّم. فكيف يُنتظر من طالب مهجّر، فقد منزله أو أحد والديه، ويعيش في سكنٍ مؤقت أو يتعلّم عبر الإنترنت المتقطّع، أن يُظهر تحصيلًا طبيعيًا؟ أن يتعامل مع امتحان وطني كأن شيئًا لم يكن؟
ومن منظور Bandura، يرتكز التعلّم الاجتماعي على النماذج الداعمة والتفاعل الإيجابي والدعم المعنوي من المعلمين والمدرسة والمجتمع. لكن القرار الأخير أفرغ شبكات الدعم من معناها، إذ تحوّل المعلّم، المرهق نفسيًا وماليًا والمثقل بالمهام، إلى ناقل لمنهج ثقيل بالرغم من ترشيقه. فكيف يكون وسيطًا فعّالًا للتعلّم في بيئة فقدت استقرارها المؤسسي والعاطفي؟ ولو كانت العدالة التربوية حاضرة في فلسفة القرار، لكان من المنطقي اعتماد مبدأ 'تعويض الفاقد عبر التمييز الإيجابي'، كما يقترح John Rawls، عبر إتاحة خيارات وفرص أوسع للطلاب المتضررين. لكن القرار فعل العكس، جاء بمقاربة مركزية جامدة تناقض روح البحث الإجرائي، دون أي مرونة في المواد أو الأسئلة أو الوقت الكافي للاستعداد والمراجعة، وحتى دون اعتراف فعلي بحجم الضرر. اختُزل الحل في تخفيض شكلي لدروس في ثلاثة مواد، فيما بقيت المواد الأخرى بلا تعديل. الأخطر أن القرار تجاهل مبدأ الإنصاف المعتمد في نظم التقييم الحديثة، والتي تخفف الطابع العقابي للامتحانات، وبدل أن يكون النظام التربوي وسيلة لاحتضان المتعلمين في الأزمات، تحوّل إلى سلطة فوقية تُصدر قرارات تقنية بلا حسّ ميداني أو مشاركة مجتمعية.
حين تقول الوزيرة إنها لم تسمع بشكاوى طلاب الجنوب لأنها استمعت إلى مجموعة منهم داخل الوزارة، فإنها تعيد إنتاج أحد أخطر أنماط الحوكمة التربوية: 'التمثيل الزائف للواقع عبر نُخب مختارة'، كما حذّرت منه أدبيات Paulo Freire ، التي شدّدت على ضرورة الإصغاء للمقهورين لا الحديث باسمهم. بذلك، يُسهم القرار – بوعي أو بدونه – في تقويض ما تبقّى من الثقة بين المجتمع ونظامه التربوي. ففي بلد ترزح فيه الأسر تحت ضغوط اقتصادية قاسية، يعيد قرار كهذا إنتاج مشاعر الإحباط والعجز، وهو ما توضّحه نظرية 'العجز المُتعلَّم' learned helplessness، التي تشير إلى أن الطالب، حين يواجه نظامًا يتجاهل ظروفه، يفقد دافعيته وانتماءه لعملية التعلّم.
أغفلت الوزيرة ومن صاغ القرار دروس تجارب دول واجهت أزمات مشابهة، حيث أدّت المقاربات المركزية الجامدة إلى نتائج كارثية على العدالة التعليمية والثقة بالمؤسسات التربوية. في سوريا (2014)، فاقم الإصرار على الامتحانات التقليدية في ظل الحرب التسرب المدرسي، وعمّق الفجوات التعليمية والاجتماعية وفقًا لمنظمة Save the Children ، وفي هايتي (2010)، تسبّب القرار المتسرّع بإجراء امتحانات بعد الزلزال بارتفاع الرسوب وانهيار أداء المعلمين، وفق تقرير UNESCO 2011. حتى دول مستقرة كفرنسا وبريطانيا اضطرت، خلال جائحة كورونا، إلى التراجع عن الامتحانات الموحدة وتبنّي نماذج تقييم أكثر عدالة ومرونة. فهل تتفوّق بيروقراطية لبنان على حكومات الغرب في الصلابة... أم في الإنكار؟ لذلك، إزاء هذه التجارب تصبح الخشية في أن يؤدي قرار وزارة التربية إلى ثلاث نتائج مباشرة: رسوب بنسبة مرتفعة خصوصًا في المناطق المتضررة، وتآكل الثقة بالامتحان الرسمي بعد تحوّله من أداة تقييم إلى أداة قسر إداري.، وتفاقم اللامساواة بين المناطق أو بين المدارس الرسمية والخاصة.
لم يكن القرار الأخير فشلًا تقنيًا فحسب، بل نتيجة لتحويل أدوات البحث إلى ذرائع. فالاستبيان إذا أُجري في فراغ أو على عينة منحازة، لا يُنتج معرفة، بل يُستخدم كقناع. والباحث، حين يتجاهل الميدان ويكتفي بالأرقام، يفقد صفته كباحث. الوزيرة، رغم خلفيتها الأكاديمية، وقعت في فخ الإنكار المهني: اختزلت الواقع في نسب، وغفلت عن السياق، عن التلامذة المنكوبين، والمعلمين المرهقين، وعن أن التربية فعل احتضان لا تقويم. قرارها لم يكن مجرد ارتجال فحسب، بل يفتقر إلى فلسفة الإنصاف، ويعامل التربية كإجراء إداري لا كبنية اجتماعية حيّة. وحين تفشل الدولة في الأمن، والاقتصاد، والدعم النفسي، لا يحق لها مطالبة الطالب بأن يكون قويًا ومستعدًا لامتحان صاغته إدارة بيروقراطية. لا حياد في وجه الظلم، ولا حيادية في تقييم يتجاهل الجروح ويصمّ أذنه عن صوت المقهورين.
وحين يتحوّل القرار التربوي إلى إجراء فوقي يتجاهل واقع المتعلّمين، يفقد التعليم معناه كأداة للتحرّر والعدالة. ما نحتاجه ليس مراجعة القرار فحسب، بل مساءلة الفلسفة التي صاغته: هل التربية مساحة إنصاف، أم أداة قهر ناعمة تُكمل ما بدأته الحرب من تمزيق نفسي؟ العودة إلى امتحان صارم وموحّد، بلا خيارات أو تخفيف حقيقي، في وقت يئنّ فيه الجنوب، والمعلم من العوز، والطالب من القلق، ليست إصلاحًا ولا إنصافًا تربويّا، بل تكريسٌ للفشل بلغة التفوّق. ففي نظام تربوي عادل، الأولوية للمتعلّم، وصوت المعلم أصدق من التقارير في مكاتب الوزارة. ووزيرة بخلفية بحثية يُفترض أن تدرك أن التعليم لا يُدار بالأرقام، بل بالثقة والمرافقة والاستجابة الميدانية. وحين تُغلق الوزارة أبوابها على 'حلقة ضيقة'، يفقد القرار شرعيته، ويتحوّل من أداة إنصاف إلى وسيلة لإعادة إنتاج الظلم. التاريخ لن يذكر عدد الدروس المحذوفة، بل سيحفظ أي منظومة ساندت طلابها في المحن، وأيّها زادت أعباءهم وادّعت أنها فعلت ذلك 'بالعلم والمنهجية'.
لا يزال الوقت متاحًا لتصحيح المسار. فالخطأ ليس في التراجع عن قرار استند إلى قراءة ناقصة، بل في المكابرة واستمرار القطيعة مع الميدان. فالتربية في الأزمات لا تُدار بصرامة إدارية، بل بروح الرأفة والعدالة الإصلاحية. والتقييم الحقيقي يبدأ حين تُسأل الوزارة: هل تقيس امتحاناتكم المهارات، أم تفضح الانقسامات؟ وهل طلابكم يتعلّمون، أم يتألمون بصمت في قاعات تُشبه القبور؟
نحن بحاجة إلى قرار تربوي شجاع، لا تقني. قرار يرى أن الحرب ليست فقط في الجبهات، بل في القلوب والصفوف. قرار يعامل التلامذة كأرواح مرهقة تحتاج إلى سند، لا كأرقام. وإلّا، فإنكم تحوّلون التربية من فعل تحرّر، إلى أداة قهرٍ مكرّسة.