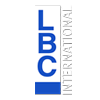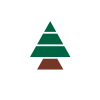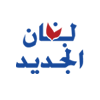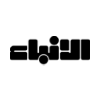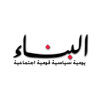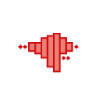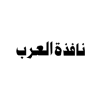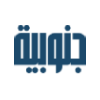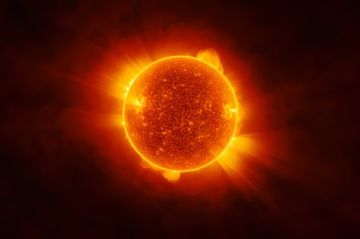اخبار لبنان
موقع كل يوم -المرده
نشر بتاريخ: ٩ تشرين الأول ٢٠٢٥
كتب عبد الغني طليس في 'اللواء':
أكثر من عشرة أبناء للسياسيين يتصدّرون الشاشات اليوم. متابعَةُ ما يقولون تقَدّم براهين عن مستوى تفكيرهم بقضايا جوهرية في البلد، وهل هُم بالعمق المعرفي المطلوب ولديهم «جُملة» سياسية خاصة مختلِفة، أم يُرددون نَوافل القول على عواهنه، وكلما رفعوا السقوف.. إلى السّحَاب، حصدوا إعجاب الأهل والأصدقاء والمُتَماثلين معهم، وكفى الله المؤمنين شَرّ… البحث عن الثقافة!
والسؤال الأدق هو: هل بإمكان ورثة السياسيين أن يسدّوا فراغ الآباء، أو يشكّلوا تكاملاً معهم، أو بديلاً صالحاً وناجحاً؟ الموضوع مرتبط بالشخصية أولاً، ذلك بأن نضج الرؤية عند الوريث للواقع والمرتجى ضروري لفهم ما يجري عملياً بحذافيره وخلفياته، وتكوين رأي واضح ومفيد تجاهه، فضلاً عن موهبة القدرة على التمييز بين المواقف الثابتة، والتكتيك، بما لا يؤدي إلى تناقض. وهذه الموهبة: الشخصية، هي الأخطر والأهمّ كونها إمّا تُحرّض على المعرفة، أو تستَنوِم على فُتات معارف الآخَرين. والتجربة المباشرة، عُنصرٌ مُحَرّك، وكذلك الاستماع الجيّد إلى من كان في الأمور خبيراً، لا حَسِيراً.
هذه المواصفات يكاد يحتكرها اثنان بين الآباء، الزعيم وليد جنبلاط في علاقته بوريثه تيمور جنبلاط، والزعيم سليمان فرنجيه في علاقته بوريثه طوني. فتيمور، في البداية بدَا مُجبَراً على ما يفعل، وعلى ما يخطِّط له الوالد، وغير مقنِع عند كثيرين بأنه يمكن أن يوازي والده، ويقتفي أسلوبيته في التحالفات ونقضها أو تبديلها مع متغيّرات حادة، بما يضمن مصلحة زعامته، ومصلحة الطائفة الدرزية في آن واحد.
ويبدو أن جنبلاط الأب أدرك مبكراً أن تيمور يحتاج «فَتّ خبزٍ» كثيراً، فأحجم عن إظهاره في مقابلات تلفزيونية حتى لا يعلَق بصورته عند المتابعين وهَن في التعبير أو في وعي مشاكل البلد الكبيرة والصغيرة. ونعلَم أنه أخضعه لأساتذةِ معرفةٍ سياسية، وخبراء تجارب عملية وفكرية، من أجل اكتساب قدرات مُلزِمة في الحياة السياسية اللبنانية. وغاب تيمور عن المنابر الحزبية إلّا بنصوص مكتوبة ومُدَوزَنة، وعن اللقاءات التلفزيونية بالمَرّة، فضلاً عن مواصلة القراءات اليومية في كتب تاريخ وسياسة، ومتابعةٍ أسبوعية لشؤون الناس في قصر المختارة، ما أكسبه ديناميكية في التعاطي مع جمهور والده، وبالتالي جمهوره، ففهِمَ طبيعة العلاقة مع المناصرين، وترَك انطباعاً عاماً بأن الوريث أنجز معمودية «النار» بصمت لكنْ بجدارة. ولا يزال وليد جنبلاط، حتى الآن، يرعى وريثه بأشفار العيون، وأيادي الاهتمام، وعقل القابض على الجمر، في طائفة تعاني دورياً من أجل البقاء وتحافظ على تراث وطني وسياسي عزيز.
ومثلما صنعَ جنبلاط بتيمور، صنع سليمان فرنجيه بابنه طوني الذي يتميّز عموماً، في طرح أفكاره، بتعابير سلسة وواضحة، ويتقن شرح مواقفه وتنظيمها وإطلاقها في شكل مدروس ومسؤول. وبسرعة قياسية تمكن طوني من اكتناه معرفة ضرورية بالواقع والوقائع، وبات قديراً جدّاً في اعتلاء المنصات الإعلامية بتمكّن ورقيّ صورةٍ. ولا يظنّن أحد أن هذه المسؤولية عابرة أو عادية أو بالإمكان التغاضي عنها، لأنها في النهاية هي المقياس الدقيق للحكم على الورثة ما إذا كانوا مسؤولين عما يقولون، أم هواةُ «شَفْلَقَة حَكي» يميناً ويساراً وسط ابتسامات التشجيع المجاني، على تحدّي.. العالَمين إذا أمكن بلا هوادة، اعتماداً على قواعد اكتسبوها بالتواتر أو بالفطرة أو بالدراسة على أيدي صانعي محتوى فاشل وقاصر!
يتحدّث وليد جنبلاط في التلفزيون عادةً بأفكار محدّدة يبلّغ فيها رسائل، وينسجها بترابُط، ولو متقطّع – مُتجَمّع يؤدي معناه، والاستدراكات لديه ضرورية لإكمال السردية المقصودة. ويقترب أسلوب سليمان فرنجيه من أسلوب جنبلاط مع رسائل أقلّ، وبحثٍ عن الكلمات المناسبة مترافقٍ مع همّ النجاح في التعبير المستهدف عنده. أما تيمور جنبلاط فغيابه عن الشاشات يمنع الحكم (التلفزيوني!) بالشواهد والأدلّة المُبَيّنة، لكنّه بات أحرصَ على إحكام الإحاطة بالفكرة.. المكتوبة منه أو من غيره. وينفرد طوني فرنجيه بالطلاقة وعدم الخشية من ضياع الجُمَل، ومفرداته السياسية لا يشوبها إنشاء لفظي ولا توجّه أدبي، بل يسوقُها ويدفع بها منطق النائب القادر على ضبط ما يقول عن اقتناع.
أُورِدُ هذا الكلام، وأمامنا طفرة هوجاء من ورثة سياسيين (أبناء نواب، أبناء وزراء، أبناء شخصيات) يمارسون تعلُّم الكلام.. بالناس عبر الشاشات، ويتنطّحون بأفكار مهزوزة معنىً ومبنىً كمَن اخترع شيئاً جللاً، وهم بالكاد يعرفون ألِفباء الأبجدية السياسية، معتمدين على هبائية الإعلام وفراغ مؤسساته من الجدية والأصول، وعلى فتْح الهواء لهم كأنه مُلْكٌ مكتسب… وخذوا أيها اللبنانيون على أفكار نيّرة ومواقف خيّرة بما يفيض عن حاجتكم، بل عن قدرتكم على.. الصمود في وجه العواصف الإعلامية المُكلِفة مهنياً، ووطنياً، وحتى إنسانياً.
غير جائز مطلقاً أن يتدرّب الوريث السياسي على الهواء مباشرةً. وإذا كان والده يجلس ويراقبه مبسوطاً بضَناه يتحدّث إلى الملأ، فإن الأهم هو ماذا يتحدث وكيف يتحدث وما هو الانطباع عنه لدى المشاهدين، خصوصاً حين يتخفّف الوريث المبتدئ من احترام المقامات، وتقدير الظروف، فينطلق مُحللاً مُحرّماً، ناصحاً بكذا وكيت، مبدياً ثقةً مصطنعة ركيكة، وهو بالكاد تجاوز عقدَين أو ثلاثة من عمره. وأغلب تجاوزاته تتم في حق أشخاص أو جهات أو وقائع يحتاج زمناً لإدراك منطلقاتها وأهدافها ومعانيها!
وتكبير الكلام، وتردادُ الجُمَل التي يتم حفظُها، وممارسة السخرية المؤذية، وتشييع النمط الاعتباطي في إلقاء الآراء على عواهنها، ليست أبداً من شروط التأثير المحترَم عبرَ الطلّة الإعلامية. فهذا يمكن أن يقترفه إي مدّعي تحليل، لا أمامه ولا وراءه مَن يحاسبه كونه ينظر إلى «الحساب» عند راعيه في سفارة أو مؤسسة حزبية. أما الوريث السياسي الذكي فمطلوب منه أكثر بكثير من ذلك، بل غير ذلك قطعاً، ويتعيّن عليه تقدير والده على أقل تقدير، وحفظ أدوار «الآخرين»، وتفادي الظهور بمظهر من يحمل سطلَ وَحْل يريد رميه على أحد، أخْذاً بثأر، أو تنفيساً لعُقدة، فما أن يُسأل حتى يجيب، بلا تفكير ولا تدقيق ولا مجرّد الانتباه إلى السؤال، كصاحب حاجةٍ في الحَكي، وصاحبُ الحاجة أرعن لا يروم إلّا قضاها كيفما اتفق.
لم تكن نزهةً طريقُ تيمور جنبلاط وطوني فرنجيه إلى الوراثة، بل كانت تعباً وشقاءً وتحصيلاً علمياً وحياتياً، وحُسْنَ تقدير وتدبير. وعلى الآخرين من الورثة إذا أرادوا مصيراً طيّباً أن يتعلّموا من تجارب الأبعدين إذا كانت تجارب الأقربين.. مش ولا بُدّ!