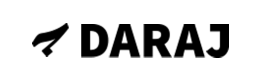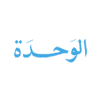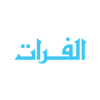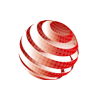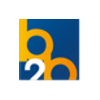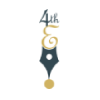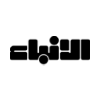اخبار سوريا
موقع كل يوم -درج
نشر بتاريخ: ١٤ أب ٢٠٢٥
خلال سنوات، ومثل غيرهم من القوميين، شيّد الكرد استراتيجية وترسانة من 'النكران والإهمال' حول الإبادة الآشورية/ الأرمنية، مبنية على أربع مستويات وأدوات، يمكن عبرها تفنيد أية مذبحة أو إبادة جماعية حصلت عبر التاريخ وتفكيكها وإنكارها وإهمالها، لأنها أدوات وألعاب عقلية مجرّدة، وليست معالجات وأدوات تعامل موضوعية مع ما حصل.
منذ أن سقط النظام السوري السابق قبل أشهر، غرقت سوريا في 'مجازر على أساس الهوّية'، تتالت وشملت مناطق مختلفة وجماعات أهلّية سورية؛ إذ قُتل بضع مئات من المدنيين 'العلويين' في شهر آذار/ مارس المنصرم على يد عصابات وفصائل مسلّحة، وحتى وحدة من الجيش النظامي الجديد، تقودهم مُعتقدات دينية طائفية 'إسلامية/ سُنية' ذات نوازع جهادية.
تكرّر الأمر بعد شهور قليلة في محافظة السويداء، إذ قُتل المئات من أبناء الطائفة الدُرزية وحُرقت العشرات من قراهم، حسب الآليات والأسباب نفسها.
لم تتّخذ السلطة السورية الجديدة أية إجراءات عملية في اتّجاه مقاضاة المرتكبين ومحاسبتهم، خلا لجنة تحقيق 'شكلية'، خرجت بنتائج خجولة في ما خصّ مجازر العلويين، وبعد شهور مما اعتبرته 'تحقيقات ميدانية'، فيما شكّلت وزارة العدل لجنة أخرى خاصّة بما حدث في محافظة السويداء.
إلى جانب 'الفشل الحكومي'، فإن مختلف القطاعات الثقافية والاجتماعية والسياسية السورية لم تنتج أي شيء ذا قيمة ودور في ما خصّ هذه الأحداث المروّعة. إذ غرقت أثناء معالجتها في استقطاب طائفي ومناطقي وسياسي شديد، لم تمارس إدانة واضحة، ولم تصبغها بتعاريف ومحدّدات وسياقات ذات دلالة، بل غلب التسويف والتبرير والتبسيط والنكران، المنطق الذي تناولت فيه ما جرى.
يحدث ذلك، في وقت ما تزال مختلف الجهات الفاعلة في البلاد، عاجزة تماماً عن إدارة ملفّ 'العدالة' بشأن ضحايا أحداث السنوات الماضية، حيث سقط مئات الآلاف من المدنيين جرّاء الحرب الأهلية التي طالت البلاد، أغلبهم نتيجة مواجهات ذات بُعد 'هوّياتي'، طائفي وعرقي وديني.
فالطابع الأعمّ، هو اتّهام مختلف الجماعات الأهلية نظيراتها الأخريات، بالتقاعس أو الامتناع عن الاعتراف والإقرار بحصول، أو 'اقتراف' مجازر جماعية على أساس الهوّية بحقّ الجماعات الأخرى، سواء ضمن سياق الحرب الأهلية السورية المديدة، أو ما تلاها من أحداث.
ما سوف تحاول هذه المقالة تفكيكه هو تأكيد 'استحالة' حدوث ذلك، سواء راهناً أو في المستقبل المنظور، بسبب التعقيدات النفسية والاجتماعية والسياسية المرتبطة بذلك، وسوف تستند المقالة إلى حدث مفصلي في التاريخ السوري المعاصر، متمثّل بالتهم الدائمة التي توجّهها الجماعات القومية الآشورية والسريانية والأرمنية إلى نظيرتها الكُردية، محمّلة إيّاها مسؤولية المشاركة في مجازر الإبادة الجماعية، التي طالت هذه الجماعات العرقية في السنوات الأخيرة لانهيار الإمبراطورية العثمانية (1915-1923) عبر المشاركة مع السلطات العثمانية في فعل ذلك.
إذ يُنكر ساسة ومثقّفون ومساحة من العقل الجمعي الكُردي/ السوري والكردي غير السوري، حدوث ذلك، ويستندون إلى ترسانة من الحجج المراوغة والاستدلالات الوظيفية والمخادعات اللفظية، للتهرّب وتبرئة الذات بأي ثمن.
يعتقد كاتب هذه المقالة أن تلك الآلية ستستمرّ طويلاً كشكل للعلاقات بين الجماعات الأهلية السورية، وآلية صياغاتها لتاريخها المعاصر.
قبل سقوط النظام السوري بأشهر، امتنعت شركة نقل عامّ، مقرّها في مدينة القامشلي ومملوكة لرجال أعمال آشوريين 'سريان'، عن نقل مجموعة من الكتب، بدعوى تضمّن عنوانها اسم 'كردستان'. أثارت الحادثة ردود فعل مُندّدة من النشطاء المدنيين والفاعلين الثقافيين والمعلّقين الكرد، مُصنّفين الحادثة كـ'فعل عنصري'، مُرجعين إيّاها إلى سياق مديد من المشاعر الناقمة والعلاقات السلبية التي يحملها آشوريو/ سريان وأرمن سوريا، سكّان المناطق الشمالية الشرقية بالذات، تجاه الكرد منذ عقود.
تمكّنت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، بالتعاون مع حزب 'الاتّحاد السرياني' من إيجاد مخرج 'تلفيقي' لما حدث، لكن، ولأيّام عديدة، دارت جدالات مطوّلة وطُرحت مواقف حادّة بشأن القضيّة، ركّز فيها المُعلّقون الكرد على ما اعتبروه 'الأساس في الأمر'، ألا وهو استياء أبناء الجماعتين القوميتين الآشورية/السريانية والأرمنية ونقمتهم تجاه نظرائهم الكرد، كأفراد وكشعب ومشروع سياسي، والحادثة الأخيرة، حسبهم، ما كانت إلا تعبيراً واستعارة عن جذر القضيّة وجوهرها.
شوك تحت الظفر
في العمق، كانت الحادثة تعبيراً وكشفاً لقضيّة ومسألة عامّة شديدة التركيب والعمق في عالم الاجتماع السياسي والثقافي لتلك المنطقة. لأجل ذلك، لم تكن المصطلحات والأفكار والمواقف والعبارات المنمّقة، المُستعارة من قاموس 'الوطنية' و'الوجاهة الثقافية' و'الكياسة الاجتماعية'، وما تستوجب من كلام مشذّب ومواقف باردة في مثل هذه الأحداث، قادرة على استيعابها.
إذ ليس بعيداً عن الصحّة وصف الموقف النفسي والاجتماعي والسياسي لشريحة واسعة من آشوريي وأرمن شمال شرقي سوريا، من الكرد، بأنه ناقم وسلبي، يفتقد إلى ما يفترضه التعايش المديد من حرارة وانفتاح ومعرفة بين الجماعات المتجاورة، خصوصاً بين الجماعات القومية الثلاثة في هذه المنطقة، المتداخلة منذ أزمنة سحيقة، حتى يصعب تحديد لحظتها التأسيسية.
لا يُلغي الإقرار بهذه 'الحقيقة الجارحة' كلّ أشكال النسبية المحيطة بها، لا ينفي مثلاً الكثير من أشكال العيش المشترك بين أفراد من هذه الجماعات في الحياة اليومية والعامّة. فلم يسبق أن شهدنا عنفاً أهلياً واسعاً في ما بينها، ولا مظاهر للعنصرية البادرة المباشرة. فالنقمة والسلبية تبقى في ما هو مُضمر، لا تكشفها إلا سلوكيات ومؤشّرات شديدة التركيب، لكنّها حاضرة بكثافة دون شكّ، بالذات في 'العالم السرّي' لكلّ منها، وتنفجر على شكل أزمات حادّة في ما يُمكن تسميتها بـ'الأوقات الصعبة' لعلاقات الجماعات، التي تظهر أحياناً قليلة في السياق التاريخي، لكنّها تكشف حقيقة ما تكتنزه الذاكرة الجمعية والمشاعر العامّة المتبادلة بين الجماعات الأهلية.
تُشير نُخب ثقافية واجتماعية كُردية إلى نقمة آشورية سريانية أرمنية، وتندّد بها على الدوام، لكن ببرود وجداني وقلّة تبصّر عقلي، لأنها تؤطّر موقفها من هذه 'النقمة الآشورية الأرمنية تجاه الكرد' بأسلوب عار من كلّ ما أنتجها، وكلّ ما يزال يحيط بها حتى الآن، من أفعال وأدوات ومسبّبات. فالكثير من النخب الكردية تستنكف عن طرح السؤال الأكثر جدارة بالمعرفة والمسؤوليّة الثقافية في الحياة العامّة، في مثل هذه الأنماط الخطرة من علاقات الجماعات، أي 'سؤال السبب'. يميلون ويفضّلون الركون إلى ما يعتبرونه أمراً واضحاً بالنسبة إليهم، يقولون لأنفسهم 'لا يحبوننا لأننا كرد'! خائفين من السعي الحثيث وراء جبال الأشياء الكامنة وراءها، خشية مواجهة ترسانة الحقائق التي قد يكشفها سبب 'النقمة'.
فما يحمله كثير من الآشوريين السريان والأرمن تجاه الكرد ليس ذا منبت 'ماركسي'، متعلّق بالطبقات والجهويات وأنماط العمل، الذي يمكن به وصفها وتفسيرها بنوعيّة العلاقات الطبقية داخل الجماعة الواحدة، بل نابع من مصدر وفعل سياسي ذي جذر حربي، هو تقاسمهما طرفي/ جبهتي فعلة 'الإبادة'، بين مرتكبين وضحايا.
فالإبادة الجماعية التي طالت الأرمن والآشوريين السريان 'السيفو'، خلال السنوات الأخيرة من عمر الإمبراطورية العثمانية، وأنهت تقريباً الوجود الديموغرافي لأبناء الجماعتين القوميتين الأرمنية والآشورية/ السريانية في هذه المنطقة، وحوّلتهما من شعبين ممتدّين على جغرافيا تاريخية، إلى مُجرد أقلّيتين قوميتين ودينيتين، بحيث أصبح هذا التحوّل الذي نتج عن ذلك الحدث التاريخي إلى جوهر الشخصيّة السياسية والنفسية والاجتماعية، وحتى الثقافية والروحية، لمن بقي من أبناء هاتين الجماعتين.
فالآشوريون السريان والأرمن، وبسبب تلك الفعلة، صاروا كتلاً بشرية هشّة، فاقدة لأية قدرة على بلورة مشروع سياسي ما، بسبب افتقاد الثقل الديموغرافي والسيادة الديموغرافية على الأراضي التاريخية التي لهم، كما فعل أبناء القوميات الأخرى في المنطقة، كالأتراك والعرب والفرس، أو استطاعوا تحقيق بعضاً من تطلّعاتهم في الدول التي تكوّنت، مثلما فعل الكرد في العراق، ويحاولون فعله في الدول الأخرى.
في الأدب السياسي ومحتويات السردية التاريخية ومضامين الذاكرة الشعبية لأبناء الجماعتين، ثمّة تهم واسعة تطال الكرد، تقول إنهم انخرطوا في تلك المجازر بكثافة، كانوا شركاء الدولة العثمانية وجيشها وتنظيماتها السياسية التي أقدمت على تنفيذ الإبادة الجماعية بحقّهما.
الذاكرة الجماعية والسردية التأريخية للأرمن والآشوريين/السريان متخمة بالمرويات التي تتّهم الكرد بالضلوع في كلّ تفاصيل الإبادة، سواء كتنظيمات عشائرية مرعية من الجيش والسلطة العثمانية 'فرق الخيّالة الحميدية'، أو ككتل أهلية/ قبلية كردية، شاركت واستغلّت الغبن والتحطيم الذي مارسته الدولة العثمانية بحقّ الأرمن والآشوريين، ففتكوا بهم واستولوا على ممتلكاتهم، انتهزوا اللحظة/ الفرصة التاريخية الاستثنائية، وأزاحوا شركاءهم التقليديين في الولايات العثمانية الأربع 'الشرقية'، أرضروم ووان ودياربكر ومعمورة العزيز، صارت بعض أراضي اثنين منها جزءاً من الجغرافيا السورية فيما بعد، إذ تشير التقديرات الأكثر موضوعية إلى أن ثلثي أبناء الجماعتين القوميتين كانوا ضحايا ما حدث.
لا تريد نخب كردية الدخول في نقاش جدّي وواضح بشأن ذلك، لكنّهم قبل ذلك لا ينزعون إلى وعي معنى الحدث التاريخي ومكانته، في تشكيل الهوّية القومية والذاكرة الجماعية المستقبلية لأبناء الجماعتين الآشورية/السريانية والأرمنية وتأطيرها.
فالنظراء الكرد، ودائماً بأغلبيتهم العظمى وليس المطلقة، لا يعون الدوافع والديناميكيات شديدة التركيب والتراكم، التي خلقتها تلك الحادثة التاريخية وحوّلتها إلى مروية مركزية وحكاية شبه وحيدة في هوّية أعضاء الجماعتين الآشورية والأرمنية ووعيهم لأنفسهم وللعالم، المنصّة والأداة التي على أساسها يقيسون كلّ شيء ويحدّدون كلّ علاقة، مصدراً أوّلياً ودائماً لما يعتبرونه 'شكل العالم من حولهم'.
طوال قرن كامل مضى، منذ أن وقعت الإبادة وحتى الراهن، بقي الكرد في الوعي والضمير الجمعي لأبناء الجماعتين، ما كانوا عليه ضمن 'المروية الكبرى للإبادة'، كمتّهمين ومنخرطين في ما حدث، وتالياً كمتسبّبين لما انتهت إليه الجماعتان من مصائر. حُشر الكرد في تلك المكانة 'الآثمة'، وما تغيّر موقعهم بحُكم الزمن، لأن الجماعتين هاتين بقيتا متمركزتين حول حكايتهما التأسيسية، لم تتخلّيا عنها كأساس أوّلي للشخصيّة القومية والوعي الجمعي للذات، وبذلك لم تستطيعا أن تحوّرا وعيهما لحركة التاريخ والعلاقة مع الجماعات الأخرى، مع الكرد بالذات.
فإذا كانت أحداث السنوات الأخيرة من عمر الدولة العثمانية قد أصبحت 'الماضي' بالنسبة إلى القوميات الغالبة، التي حقّقت لنفسها حضوراً ودولاً وتمثيلاً بين الأمم؛ فإنها لم تصبح كذلك بالنسبة إلى الأرمن والآشوريين السريان يوماً. فالإبادة الجماعية بالنسبة إليهم هي 'الانفجار العظيم'، الذي أعاد تشكيل أصل الأشياء والحقائق والوجود، وجودهم وحقيقتهم. والإبادة كانت على درجة من الفظاعة يُستحال استيعابها وبلورة حياة عامّة مقبولة بعدها، لأنها أخرجت شعبين كاملين من التاريخ والجغرافيا، سيصبحون ثلاثة، لو أضفنا إليهم اليونان الأرثوذوكس فيما بعد.
يقوم الاستنكار الكردي لما يحدث في الحاضر، من نقمة جمعية تجاههم، في واحد من أهم أبعاده، على مخيّلة تعتبر أن ما حدث هو شيء من الماضي، لم يعد موجوداً، ومن الحصافة و'الأخلاق' ألا يُتذكّر ويُعتدّ به، متناسين أن شروط 'هندسة النسيان' ومساراتها، لا تتطابق بين جماعة وأخرى.
فالجماعات الأكثر قدرة على بناء الحاضر، وميلاً إلى تحديث بناءها الحياتية وخلق أشكال من الطمأنينة والمؤسّسات الحديثة، هي الأكثر قدرة على القطيعة مع الماضي، بأشكال من النسيان والغفران والتجاوز والمصالحة مع 'المرتكبين'.
لم يتمكّن الآشوريون السريان والأرمن من 'هندسة النسيان'، لأن فواعل سياسية وثقافية وديموغرافية متناهية الخصوصية، ما تزال تعمل على مركزة الإبادة في الذاكرة الجمعية لأبناء الجماعتين، وإبقائها حاضرة وحيوية في الراهن، وتالياً رفع سوّيتها وقدرتها على الإطاحة بكلّ إمكانية أو محاولة لتجاوزها، ولو نسبياً، وبذا تصعب مغادرة الكرد لما هم فيه من مكانة بالنسبة إليهم. هذا ما لا تعيه النُخب الكردية، الثقافية والسياسية والاجتماعية، وغالباً لا تريد وعيه، مكتفية بالعبارات المُقتضبة والمريحة 'لا يحبّوننا لأنهم لا يحبّوننا'.