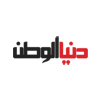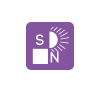اخبار فلسطين
موقع كل يوم -وكالة سوا الإخبارية
نشر بتاريخ: ٢٥ أيار ٢٠٢٥
في زاويةٍ من حيّ تل الهوى جنوب مدينة غزة ، حيث كان يذيع صيت شارع 'باصات كردش' بأنه مصدر أشجار الياسمين، تقف أم ناهض مسلم (62 عامًا) تُقلِّب أناملها في الهواء، كأنّها تلمس ذكرياتٍ مطمورة تحت الركام.
“البيت كان هنا… أين هنا بالضبط؟” تسأل نفسها بصوتٍ خافت، بينما تحاول أن تتذكر إن كان منزلها يقع يسارَ بقايا إشارة مرور أم يمينَ جذع نخلة مقطوع. حولها، تشبه الشوارع جثةً مُمتدة؛ لا لافتات تُرشد، ولا روائح تهدي، فقط غبار الحرب يلفُّ كل شيء.
لم تكن أم ناهض تعلم أن البحث عن بيتها سيُصبح أشبه بقراءة خريطةٍ ممزقة، أو سرد قصةِ مدينةٍ مُحتضرة ترفض أن تموت بصمت.
“شارع الوحدة… أتذكر كيف كان يضج بالحياة!” يقول يوسف محمد (60 عامًا)، جار أم ناهض، وهو يشير إلى كومةٍ إسمنتية كانت يومًا مكتبة سمير منصور، حيث اشترى أول كتابٍ لابنه.
“هنا، عند الزاوية، كانت رائحة القهوة تختلط بصوت ضحكات الطلاب… والآن، كل ما تسمعه هو صمتٌ يُشبه الموت”. وفقًا لبلدية غزة، دمّرت الحرب أكثر من 80% من لافتات الشوارع، بالإضافة إلى البنية التحتية وتدمير المعالم بشكلٍ كامل، وانهار معها تاريخٌ كامل من الأسماء التي حملت حكايات الأجداد.
“لم نكن ندرك أن اللافتات الحديدية هي خيوطٌ تربطنا بذواتنا”، يقول محمد السرساوي، رئيس قسم الإعلام في بلدية غزة، بينما يُظهر خريطةً عليها علاماتٌ حمراء تشير إلى شوارعَ اختفت تضاريسها.
لم تكن الخسائر مادية فحسب. ففي محيط ملعب فلسطين، حيث كانت أفران الحطب تُنثر رائحة الخبز الطازج، أصبحت الإشارات الوحيدة الباقية هي “زقاق الصواريخ” و”شارع الرشاش” – أسماءٌ أطلقها السكان بسخريةٍ مريرة لتمييز الفراغات التي لم تعد تُشبه شيئًا.
“نحتاج إلى أسماء جديدة لنعرف أين نضع أحزاننا”، تقول بسمة القيق (25 عامًا)، التي التقطت عشرات الصور بهاتفها المحطَّم كي تتأكد من أنها تسير في الاتجاه الصحيح.
“حتى الروائح خانتنا… كان البحر يُعلن عن نفسه بنسماتٍ مالحة، والآن الرائحة الوحيدة هي رائحة الموت”.
في غزة، لم يعد السؤال “كيف نعيش؟” وحده يُطارِد السكان، بل أيضًا “أين نعيش؟”.
فالمدينة التي كانت تُعرَف بشوارعها الضيقة المليئة بحكايات الباعة، وباللافتات التي تحمل أسماءً تاريخية مثل “الراهبات الوردية” و”الشفاء”، صارت تشبه لوحةً فنية مُشوَّهة.
“كنا نعرف اتجاه الريح من ميلان أشجار النخيل في شارع البحر… الآن النخيل نفسه صار رمادًا”، يقول محمد أحمد (32 عامًا)، سائقُ تكسي يضطر يوميًا إلى ابتكار مساراتٍ جديدة، لأن إشارات المرور اختفت، والطرق التي كان يحفظها عن ظهر قلب أصبحت متاهةً من الحفر.
الأمر لا يتعلق بالتشويش البصري فحسب. فوفق بلدية غزة، فإن أكثر من 80% من البنية التحتية الحضرية دُمّرت، ما حوّل الشوارع إلى كتلٍ إسمنتية متشابهة.
وفي ساحة الجندي المجهول، التي كانت نقطة التقاءٍ للعائلات، تحوّل الركام إلى مشهدٍ يومي.
“هنا كان أولادي يلعبون… والآن أنظف رفات جيراننا من تحت الأنقاض”، تقسم أم محمد الأحمد (50 عامًا) وهي ترفع حجرًا عليه بقايا كتابٍ مدرسي.
حتى مستشفى الشفاء، الذي كان رمزًا للصمود، صار جزءًا من “المناطق المحظورة” بسبب الأضرار الهيكلية التي جعلت جدرانه أشبه بوجهٍ مُشرَعٍ للريح.
وسط هذا التشويه، تظهر محاولاتٌ صغيرة لاستعادة الهوية؛ فبعض العائلات تُعلّق لوحاتٍ خشبية على الأنقاض مكتوبًا عليها “هنا كان منزل آل عبدالهادي”، أو “هذه زاوية أبو علي”.
“الاسم هو آخر ما تمسكنا به”، تقول بسمة، التي علّقت على حائط منزلها المُدمَّر لافتة كتبت عليها: “شارع البحر – 2023”.
ربما لن يفهم الغرباء معناها، لكنها تؤكد لها أنها ما زالت تعرف مكان بيتها.
في غزة، حيث تذوب الجغرافيا في بحرٍ من الرماد، يتحول كل اسم إلى حصنٍ أخيرٍ للذاكرة.
فالأسماء الجديدة – وإن كانت تعكس مرارة الواقع – تُشبه ندوبًا على جسد المدينة؛ تُذكّر بأن الحرب لم تقتل كل شيء.
ربما لن تعود رائحة الياسمين إلى شارع باصات كردش قريبًا، لكن أم ناهض ما زالت ترفض أن تنتظر كل صباح، تمشي بين الأنقاض وتُعيد رسم الخريطة في ذهنها: “هنا كان بيتي… هنا سأبنيه مرةً أخرى”.
ملاحظة : هذا النص مخرج تدريبي لدورة الكتابة الإبداعية للمنصات الرقمية ضمن مشروع ' تدريب الصحفيين للعام 2025' المنفذ من بيت الصحافة والممول من منظمة اليونسكو.