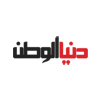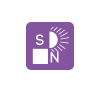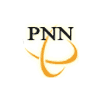اخبار فلسطين
موقع كل يوم -وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
نشر بتاريخ: ٢٩ تشرين الأول ٢٠٢٥
الكاتب:
نــداء مقبــل
يمرّ الواقع الفلسطيني بمرحلة دقيقة تتطلب مراجعة شاملة للنهج الوطني والسياسي القائم منذ عقود. فالمشهد اليوم أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى: انقسام سياسي طال أمده، وتحديات اقتصادية واجتماعية متنامية، وتحولات إقليمية ودولية سريعة تغيّر موازين القوة والاهتمام.
هذه التحولات لا تُضعف المشروع الوطني، بل تُذكّر بضرورة إعادة بنائه على أسس جديدة أكثر شمولًا وواقعية وتنوعًا في أدواتها. فالمرحلة لم تعد تحتمل تكرار الخطاب ذاته أو الرهان الأحادي، بل تحتاج إلى استراتيجية وطنية متكاملة تنبع من الداخل وتخدم الإنسان الفلسطيني أينما كان، وتعيد تعريف العلاقة بين المواطن، والمؤسسة، والوطن.
الغاية ليست استبدال الخطاب الوطني، بل تجديده بروحٍ من الشراكة والمبادرة تحافظ على الثوابت وتواجه الواقع بمرونة وثقة. وحين تكون الرؤية شاملة، يصبح التنوع مصدر قوة، وتتحول الاختلافات إلى طاقة عمل بدل أن تبقى موضع تجاذب أو خوف.
المؤقتات كمرحلة لا كإقامة دائمة
عاشت التجربة الفلسطينية مع ترتيباتٍ مؤقتة طالت أكثر مما ينبغي: مؤسسات انتقالية، نصوص مؤقتة، وهياكل حكم لم تكتمل. ورغم أن هذه المؤقتات كانت ضرورية في لحظات التأسيس، فإنها أضعفت الوضوح السياسي وأبقت الحالة العامة في دائرة الانتظار.
لكن المؤقت ليس عيبًا بذاته؛ إنه مرحلة اختبار وبناء يمكن تحويلها إلى جسرٍ منظم نحو الاستقرار إذا أُدير بعقلية تخطيط لا إدارة أزمة: تحديد أفقٍ زمني واضح، وإطلاق مسارٍ وطني يعيد ترتيب الأولويات وفق جدولٍ حقيقي للإصلاح والمساءلة وتجديد الشرعيات. بهذه الرؤية، تصبح المؤقتات مساحة إنضاج لا تكرار، وبوابة عبور نحو دولة مؤسساتٍ دائمة وفاعلة.
من الرهان الأحادي إلى التنوع الوطني
التحوّل المطلوب هو الخروج من الرهان على أداة واحدة أو مسار واحد، إلى رؤية متعددة المسارات تعمل بتكاملٍ لا بتنافس:
المسار السياسي: تعزيز الحضور القانوني والدبلوماسي وترجمة الاعتراف الدولي إلى مكاسب عملية. اليوم تعترف أكثر من 140 دولة بدولة فلسطين؛ وهذه مكانة ينبغي تحويلها إلى دعمٍ مؤسّسي واقتصادي ملموس (وفق رصد دبلوماسي مجمّع حتى منتصف 2025)..
المسار الشعبي والمجتمعي: إشراك فئات المجتمع كافة في التخطيط والمتابعة، وتطوير قنوات المشاركة المحلية والقطاعية بما يعزز الثقة العامة.
المسار الاقتصادي: بناء قاعدة إنتاجية محلية تحصّن المجتمع من الهشاشة؛ فمعدل البطالة الإجمالي بلغ نحو 28.6% في الربع الثاني 2025 وفق المسح العمالي الرسمي (بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2025)، وارتفعت المعدلات في غزة إلى مستوياتٍ مرتفعة مع نهاية 2024 (وفق تحديثات البنك الدولي 2024)
المسار الثقافي والتعليمي: تطوير خطاب وطني يعيد تعريف الانتماء بالوعي والعمل، ويُنمّي الحس الجمعي والهوية الجامعة.
بهذا التنوّع، ينتقل المشروع الوطني من ردّ الفعل إلى فعلٍ منظم طويل الأمد قادر على التكيّف والإنجاز.
الإصلاح المؤسسي والحوكمة: لغة الشراكة لا التصادم
أي استراتيجية وطنية لن تنجح دون تطويرٍ من الداخل يعيد للمؤسسة دورها الطبيعي كأداة لخدمة المواطن. والمطلوب هنا خطواتٌ عملية واضحة:
شفافية القرار والإنفاق العام عبر نشرٍ دوري للبيانات وتوسيع أدوات المتابعة المجتمعية.
فصل الأدوار بين التنفيذ والرقابة لضمان الاستقلال وتحديد المسؤوليات.
حوار وطني مؤسّس يشارك فيه المجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء لصياغة جدول إصلاح إداري بزمنٍ محدد.
تمكين الشباب والنساء داخل المؤسسات عبر مساراتٍ مبنية على الكفاءة.
وتشير القراءة الرقابية إلى تزايد إدراك المواطنين لمخاطر الفساد وضعف التأثير الشعبي، ما يستدعي مقاربة مشاركةٍ ومساءلةٍ منتظمة، (وفق تقارير رقابية فلسطينية 2025).
الاقتصاد الفلسطيني: من التعافي إلى التنمية
أولًا: قراءة في الأرقام… لفهم الواقع ورسم المسار
تُقدّر الانكماشات الحقيقية في 2024 بنحو 26–28% على مستوى الاقتصاد الفلسطيني، مع انكماشٍ أعمق في غزة وارتفاعٍ كبير في البطالة هناك (وفق تقرير البنك الدولي 2024)، كما سجّلت التقديرات الأممية ارتفاعًا في معدلات الفقر على مستوى فلسطين إلى قرابة 74.3% في 2024، (بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2024).
أما في 2025، فتُظهر بيانات العمل الرسمية معدل بطالة إجماليًا بنحو 28.6% في الربع الثاني داخل الضفة الغربية وفق التعريف الإحصائي المحدث، (وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2025).
هذه المؤشرات لا تُستخدم لصناعة مزاجٍ سلبي، بل لتحديد حجم المهمة ووضع سياساتٍ واقعية لردم الفجوة.
ثانيًا: من المساعدات إلى التنمية المنتِجة
الاعتماد التاريخي على المساعدات لم يعد كافيًا. فقد شهدت الموارد الخارجية تراجعًا خلال العقد الماضي، فيما أُقِرّت ميزانية طوارئ لعام 2025 بنحو 20.6 مليار شيكل مع فجوة تمويلية تقارب 6.9 مليارات شيكل؛ ما يستدعي تنويع أدوات التمويل والانتقال من نمط الاستجابة إلى نمط الاستثمار التنموي (بحسب تقارير رقابية فلسطينية 2025).
مسارات عملية مقترحة:
توسيع القاعدة الضريبية بعدالة مع تحفيز الاستثمار المحلي وتخفيف العبء عن محدودي الدخل.
إطلاق بنك وطني للتنمية والاستثمار يمول مشاريع إنتاجية طويلة الأجل.
شراكات بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة.
توجيه جزء من تحويلات المغتربين إلى صناديق استثمارية محلية بعوائد واضحة واستدامة اجتماعية.
ثالثًا: تشغيل سريع ونمو مستدام
تُقدّر الحاجة إلى نمو سنوي لا يقل عن 6% خلال السنوات الخمس المقبلة لتعويض خسائر القاعدة الإنتاجية وتخفيف البطالة المرتفعة، وهي نسبة طموحة لكنها ممكنة إذا ما تم توجيه الجهد نحو قطاعات تشغيلية سريعة التأثير توازن بين المدى القصير والإصلاح الهيكلي طويل الأمد (استئناسًا بتقديرات البنك الدولي 2024/2025).
1. المشروعات الصغيرة والمتوسطة: عماد الاقتصاد الحقيقي
تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95% من إجمالي المنشآت الاقتصادية في فلسطين، وتستوعب قرابة 45% من القوى العاملة (بحسب معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني 'ماس' 2025).
إلا أن هذه المشاريع تعاني من ضعف التمويل، وارتفاع تكاليف التشغيل، وصعوبة الوصول إلى الأسواق.
لذلك، دعم هذا القطاع يجب أن يتجاوز منح القروض إلى بناء منظومة تمويل تنموي مرن تشمل:
إنشاء صناديق محلية للتمويل الصغير والمتناهي الصِغر بشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تقديم حوافز ضريبية مؤقتة للمشاريع الإنتاجية الجديدة التي تشغّل شبابًا أو نساء.
تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية للمشروعات المحلية وفق نظام تفضيل وطني واضح.
إن تحريك هذا القطاع لا ينعش الاقتصاد فقط، بل يعيد الثقة إلى فئة الشباب التي تمثل أكثر من 60% من المجتمع الفلسطيني، ويخلق فرصًا ملموسة دون انتظار المشاريع الكبرى أو التمويلات الخارجية.
2. الزراعة والصناعات التحويلية: من الاكتفاء الجزئي إلى الأمن الغذائي
رغم محدودية الموارد، يبقى القطاع الزراعي أحد ركائز الصمود الاقتصادي والاجتماعي.
يُسهم حاليًا بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي ويشغّل ما يزيد عن 12% من القوى العاملة (وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2025).
لكن إمكاناته الحقيقية أكبر من ذلك بكثير، إذا ما أُعيدت هيكلته حول سلاسل القيمة المحلية:
من زراعة المحاصيل الاستراتيجية (كالقمح والزيتون والخضار الورقية) إلى التصنيع الغذائي والتعبئة والتسويق الذكي.
ولتحقيق الأثر المطلوب، يجب:
دعم التعاونيات الزراعية الحديثة بمعدات وإعفاءات ضريبية مرحلية.
تمويل مشروعات التخزين البارد واللوجستيات الزراعية التي تقلل الفاقد وتحسّن الأسعار.
تشجيع الزراعة الذكية والمستدامة عبر تقنيات الري بالتنقيط والطاقة الشمسية في المناطق الريفية.
بهذه المقاربة، تتحول الزراعة من قطاع دعم اجتماعي إلى قطاع إنتاجي تجاري يخلق فرصًا دائمة ويقلل الاعتماد على الواردات الغذائية التي تجاوزت 20% من إجمالي الاستيراد الفلسطيني (تقديرات 2024).
3. الاقتصاد الأخضر والرقمي: بوابة المستقبل
يمثل التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي فرصة حقيقية لتجاوز العقبات الهيكلية في التشغيل والنمو.
فقطاع الطاقة الشمسية وحده قادر على خلق آلاف الوظائف الجديدة في التصنيع والتركيب والصيانة، إضافة إلى تقليل فاتورة الطاقة المستوردة التي تشكل عبئًا سنويًا على الموازنة.
وفي المقابل، يشهد الاقتصاد الرقمي نموًا متسارعًا عالميًا؛ إذ تشير التقديرات إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في الاستثمار الرقمي ترفع الناتج المحلي بنسبة 0.6% ، (بحسب تقارير التنمية المستدامة 2025).
يمكن تسريع هذا التحول عبر:
رقمنة الخدمات الحكومية لتقليل البيروقراطية وخلق وظائف في البرمجة والتصميم والتحليل.
دعم الشركات الناشئة والمبادرات التكنولوجية التي يقودها الشباب من خلال حاضنات أعمال ومسرّعات وطنية.
دمج التحول الأخضر مع الرقمي في مبادرات مثل الزراعة الذكية، الطاقة النظيفة، وإدارة النفايات.
هذا المسار لا يخلق فرص عمل فحسب، بل ينقل الاقتصاد الفلسطيني إلى مرحلة تنافسية قادرة على الاندماج في سلاسل الإنتاج الإقليمية والدولية.
4. منصة البيانات الوطنية: من الشفافية إلى الكفاءة
لا يمكن لأي سياسة تشغيلية أو خطة نمو أن تنجح دون معلومة دقيقة ومحدثة.
إن إنشاء منصة وطنية موحّدة للبيانات الاقتصادية والاجتماعية سيكون بمثابة العقل الرقمي للتنمية.
تتضمن هذه المنصة:
تحديث شهري لمؤشرات التشغيل والإنتاج والاستيراد والتصدير.
خرائط تفاعلية للمشروعات والمنح الدولية.
بيانات مفتوحة تساعد القطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني على التحليل واتخاذ القرار.
هذه الشفافية لا تعزز فقط الثقة بين المواطن والمؤسسة، بل تخلق بيئة تنافسية صحية تُقاس فيها النتائج لا الوعود.
البعد الدبلوماسي والتحولات الدولية
تشهد البيئة الدولية تحوّلًا متسارعًا في الموقف من القضية الفلسطينية. فمع الاعتراف الرسمي المتزايد — أكثر من 140 دولة حتى منتصف 2025 — تتعزز مكانة فلسطين القانونية والسياسية.
لكن هذا الزخم يحتاج إلى تحويلٍ عملي:
ربط الجهود السياسية بمشاريع تنموية واقتصادية حقيقية على الأرض.
بناء تحالفات اقتصادية إقليمية تُسهم في إعادة الإعمار والبنية التحتية.
تفعيل دور الشتات الفلسطيني كقوة دعم وتأثير دولي منظم، خاصة الجاليات في أوروبا والأمريكتين.
الدبلوماسية هنا ليست شعارات ولا مناسبات، بل أداة لبناء واقعٍ جديد عبر التعاون والانفتاح والاستثمار الذكي في العلاقات.
الحلول العملية
لكي لا تبقى الاستراتيجية إطارًا نظريًا، يمكن تلخيص مسار العمل في خطوات واقعية قابلة للتنفيذ:
تشكيل مجلس وطني للتنمية والشراكة يضم ممثلين عن المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات لمتابعة التنفيذ والمراجعة السنوية.
خطة وطنية ثلاثية المراحل (36 شهرًا) تشمل إصلاحًا إداريًا تدريجيًا، وتوسيعًا للحوار المجتمعي، وإطلاق مشاريع اقتصادية محلية صغيرة.
حملة وطنية للمشاركة تعزز قنوات التواصل بين المواطنين وصنّاع القرار عبر البلديات والجامعات.
ميثاق وطني للنزاهة والشفافية توقع عليه المؤسسات الرسمية والأهلية معًا، ويُراجع دوريًا لتجديد الالتزام العملي.
اعتماد مؤشرات أداء وطنية لقياس التقدم مثل معدلات التشغيل، والنمو الإنتاجي، ونسبة الشراء المحلي، والمشاركة المجتمعية في التخطيط العام.
الخاتمة
ليست فلسطين بحاجة إلى خطابٍ جديد بقدر حاجتها إلى إطار عملٍ وطني جامع يعيد الاعتبار للإنسان كمحورٍ لكل مشروع.
فالاستراتيجية الوطنية الجديدة ليست إعلان نوايا، بل خطة فعلٍ ومسار بناء.
وحين يتحول المواطن من متفرجٍ إلى شريك، والمؤسسة من متنفّذٍ إلى خادم، والاقتصاد من عبءٍ إلى مصدر كرامة،
عندها فقط يمكن القول إننا بدأنا كتابة فصلٍ جديد من الحكاية الفلسطينية — فصلٌ عنوانه:
'الوحدة في التنوع، والإصلاح بالعمل، والوطن للجميع'.