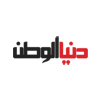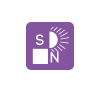اخبار فلسطين
موقع كل يوم -شبكة قدس الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٧ نيسان ٢٠٢٥
خاص - شبكة قدس الإخبارية: لم يكن السلاح يومًا تفصيلًا عابرًا في التجربة الفلسطينية، بل كان أحد الأعمدة المركزية التي تشكَّلت حولها الهوية الوطنية المعاصرة، وتكوَّنت في ظلها معادلة الردع والصمود في وجه المشروع الاستيطاني الإحلالي.
وفي قلب هذه المعادلة، تتبوأ المقاومة المسلحة - بما تمثِّله من تعبير عن إرادة المواجهة - مكانةً جوهريةً في الوعي الجمعي الفلسطيني، وخصوصًا في قطاع غزة، الذي تحوَّل إلى أيقونة للصمود تحت الحصار والعدوان والصمود في وجه الإبادة، وحامل لمعادلات الكلفة التي أعادت الاعتبار إلى مفهوم الردع في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
في هذا السياق، لا يمكن مقاربة الحديث عن نزع سلاح المقاومة بمعزل عن الإطار السياسي والاستراتيجي الذي يُطرَح فيه. فالمسألة لا تتعلق فقط بتجريد قوى مُحددة من سلاحها، بل بتفكيك البنية الدفاعية الأخيرة لشعب محاصر، والتخلي عن آخِر ما تبقَّى من عناصر المواجهة في وجه منظومة استعمارية تزداد شراسة، وتحاول فرض معادلة استسلام جديدة، بقفازات سياسية هذه المرة، بعد أن فشلت أدوات الحرب والإبادة في كسر إرادة الصمود.
ما يُطرَح اليوم، بِاسم 'الترتيبات الأمنية' و'ضمانات الاستقرار' و'اليوم التالي للحرب'، في جوهره إعادةُ صياغة لمرحلة أمنية، تتكرَّر فيها محاولات تفريغ المقاومة من مضمونها، وتحويل السلاح إلى عبء بدلاً من أن يكون ضمانة، ما يُعيد إلى الواجهة سؤالًا جوهريًا: هل نزع السلاح حقًا خطوة نحو السلام؟ أم أنه مرحلة تمهيدية لتفكيك ما تبقَّى من قدرة الفلسطينيين على البقاء والمواجهة؟
السلاح بوصفه هوية... والمقاومة بوصفها روحًا
لا يمكن فصل سلاح المقاومة عن الهوية الكفاحية لفصائل المقاومة الفلسطينية، ولا عن جوهر العقد غير المعلن الذي تشكَّل بينها وبين جمهورها الفلسطيني. فالسلاح في هذه الحالة لم يكن مجرد وسيلة اشتباك عسكري، بل تحوَّل إلى رمز مركزي في الوجدان الشعبي، ورافعة وطنية للفصائل التي اختارت أن تُعبِّر عن تطلعات شعبها في التحرر، من خلال مقاومة مسلحة متواصلة، أثبتت فاعليتها في تحرير الأرض.
إن شرعية المقاومة والمواجهة لم تكن يومًا مرتبطةً بلون سياسي محدَّد، ولم يرتبط التفاف الشعب الفلسطيني بخيار المواجهة بفصيل بعينه، بل كان هذا الالتفاف دومًا لصالح الفصيل أو الجهة التي تقود الحالة المقاومة، وتخوض غمار التصدي للاحتلال، وتدفع ثمن المواجهة، وخاصةً عبر العمل المسلح.
ومن هنا، فإن مكانة الفصائل المقاومة في الوعي الجمعي الفلسطيني لا تُبنَى فقط على خطاباتها، بل على مدى انخراطها في الفعل المقاوم، وعلى امتلاكها أدوات التأثير والردع في وجه آلة البطش والعدوان.
في هذا الإطار، لا يُمكن النظر إلى سلاح المقاومة على أنه مجرد 'أداة' تُستخدم عند الحاجة، بل هو جزء من تعريف الذات الوطنية الكفاحية. والتخلي عنه، طوعًا أو تحت الضغط، لا يعني تسوية ميدانية فقط، بل إعادة تشكيل المقاومة على أسس منزوعة الفاعلية، تتماشى مع المعايير الأمريكية والإسرائيلية لـ'لفاعلين المقبولين' في المشهد الفلسطيني.
هذا ما يجعل طرح نزع السلاح تهديدًا وجوديًّا للمقاومة بوصفها فكرة ومسارًا، ويجعله محاولةً مكشوفةً لإفراغِ المقاومة من مضمونها التحرري وتحويلِها إلى وظيفة أمنية أو إدارية لا تُهدِّد الاحتلال ولا تُقيِّد يدَه.
من زاوية فلسفية، تمثِّل المقاومة المسلحة تعبيرًا عن الرفض المادي للاحتلال، وتُجسِّد الحق الطبيعي في الدفاع عن الذات والكرامة، وتُعيد صياغةَ الفلسطينيِّ بصفته طرفًا فاعلًا لا ضحية صامتة.
فالسلاح المتوفر لدى المقاومة، على بساطته، حتى وإن لم يُستخدَم باستمرار، يظل حاملًا رسالةً رمزيةً مفادها أن هذا الشعب ما زال يمتلك قراره في الرد والمبادرة، وأن الاحتلال لا يستطيع أن يهنأ بالهيمنة دون حساب.
وتُحاول المنظومة الإسرائيلية، مدعومة بغطاء أمريكي وغربي، نزعَ الشرعية عن هذا السلاح عبر تحويله إلى عنوان الأزمات وسبب النكبات، في سياق معركة مفاهيم واسعة هدفها إعادة تعريف المقاومة على أنها عبئًا لا أداة تحرر. غير أن سلاح المقاومة الفلسطينية –بخلاف تلك المحاولات– يستمد شرعيته من القانون الدولي الذي يكفل لكل شعب تحت الاحتلال أن يُقاوِم بكل الوسائل، بما فيها الكفاح المسلَّح، من أجل تقرير مصيره واستعادة حريته.
ولعل الأهم من ذلك، أن هذا السلاح اليوم عاملٌ أساسيٌّ في تعقيد حسابات الاحتلال، وركيزةٌ في مواجهة تغوُّله على غزة والضفة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة. فوجوده يفرض على الاحتلال التفكير بمستويات عدة قبل أي عدوان، ويحوِّل كل مغامرة إلى مخاطرة. أما غيابه، فبمثابة تفويض مفتوح للاحتلال بالتمدد دون عواقب، ويعيد إنتاج مرحلة الاحتلال المباشر، ولكن بصيغة جديدة أكثر فتكًا وأقل كلفة.
سردية 'نزع السلاح'... من بيروت إلى غزة
لطالما ارتبطت محاولات نزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية بمنهجية سياسية تقوم على تفكيك البنى التحررية وتجريد الشعوب من أدوات دفاعها، تحت مسمى 'الحلول السلمية' أو 'حقن الدماء' أو 'الانتقال إلى الحياة المدنية'.
هذه السردية ليست جديدة، بل تمتد جذورها إلى تجارب قاسية، دفعت فيها حركات التحرر ثمنًا باهظًا نتيجة التعويل على الوعود السياسية أو الدولية، مقابل التخلي عن السلاح أو الانكفاء الميداني. وفي مقدمة هذه التجارب تأتي تجربة المقاومة الفلسطينية في لبنان بعد اجتياح بيروت في العام 1982.
ففي تلك المرحلة، وفي ظل الحصار الدموي الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على بيروت، قُدمت لمنظمة التحرير وعود دولية وعربية شتى بأن الانسحاب من العاصمة اللبنانية سيؤدي إلى وقف العدوان، وحقن دماء المدنيين، والحفاظ على ما تبقَّى من بيروت. وعلى أساس هذه الضمانات، وافقت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية على الانسحاب من بيروت، بوساطة دولية، وعلى رأسها المبعوث الأمريكي فيليب حبيب، الذي تعهَّد بحماية المدنيين الفلسطينيين.
لكن ما حدث لاحقًا كان على النقيض تمامًا: لم تتوقف المجازر، بل وقعت واحدة من أفظع المذابح في التاريخ المعاصر في صبرا وشاتيلا، بمشاركة مليشيات لبنانية وبغطاء إسرائيلي مباشر. وبدل أن يكون الانسحاب مدخلًا لمرحلة جديدة من التهدئة، تحوَّل إلى لحظة انكشاف وطني كارثية، استُبيحت فيها المخيمات، واهتز فيها حضور المقاومة، وفتحت الطريق أمام مرحلة طويلة من التراجع الفلسطيني في لبنان.
في المقابل، كانت تجربة المقاومة اللبنانية لاحقًا مثالًا مغايرًا. فعندما قررت قوى المقاومة في لبنان، من جبهة المقاومة الوطنية إلى 'حزب الله'، أن تملأ الفراغ الذي خلَّفته المقاومة الفلسطينية، وأعادت بناء قدراتها الميدانية، ورفعت كلفةَ الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، تغيَّر المشهد تمامًا.
لم يكن الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني في العام 2000 نتيجة مفاوضات أو تفاهمات سياسية، بل نتيجةً مباشرةً لمعادلة الاستنزاف والردع التي فرضتها المقاومة، وأجبرت الاحتلال على مغادرة الأرض دون قيد أو شرط، تحت ضغط الخسائر وتآكُل جدوى البقاء.
هذه المقارنة بين الحالتين –الانسحاب الفلسطيني من بيروت بعد تعهُّدات فارغة، والانسحاب الإسرائيلي من جنوبي لبنان تحت ضغط المقاومة– تضع أمامنا خلاصةً مركزية: أن نزع السلاح أو الانكفاء الميداني دون معادلة ردع حقيقية لا يؤدي إلى التهدئة بل إلى التغوُّل، وأن منطق الاحتلال لا يعترف بالضعف بل يتغذَّى عليه، فيما يرتدع فقط عندما تُرفَع في وجهه كلفةُ بقائه وسلوكه.
وهذا ما يُعيد إنتاج نفسه اليوم في غزة، حيث يُعرض على فصائل المقاومة التخلي عن سلاحها، مقابل وعود فضفاضة بـ'الإعمار' و'الاستقرار'، فيما آلة الإبادة ما تزال تعمل، ومشاريع التهجير والضم والسيطرة الأمنية ما تزال تطرَح بكل وقاحة.
وفي هذا الإطار تُروِّج قوى دولية وإقليمية أن بإمكان غزة أن تتحوَّل إلى 'سنغافورة' إذا ما سلَّمت سلاحها، بينما تَغضُّ الطرف عن حقيقة أن الاحتلال لم يغادر شبرًا من الأرض الفلسطينية دون مقاومة، وأن العدو الذي ارتكب المجازر في بيروت وصبرا وشاتيلا ذاته الذي يُنفِّذ المجازر في جباليا ورفح وخان يونس وهو أيضًا الذي يطرح اليوم نفسه بصفته ضامنًا لأية تسوية.
الاحتلال لا يطلب السلام... بل الاستسلام
حين يُطرَح 'نزع السلاح' شرطًا لأية تسوية 'محدودة' في قطاع غزة، فإن ما يجري الترويج له ليس مشروع سلام حقيقي، بل معادلة استسلام، تُخفِي تحت شعاراتها المتأنقة استراتيجيةً متكاملةً لتفكيك عناصر القوة الفلسطينية، وتحييد آخِر أدوات الردع المتبقية في وجه الاحتلال الإسرائيلي. فالمسألة لا تتعلق بترتيب أمني موضعي أو مطلب تكتيكي ضمن اتفاق شامل، بل تتجاوز ذلك إلى جوهر المشروع الصهيوني: تطويع الفلسطيني وترويضه وإخراجه من معادلة الفعل، سواءٌ بالمواجهة أو بالمقاومة أو حتى بالرفض الصامت.
في مقاربة الاحتلال الإسرائيلي، يُقدَّم نزع السلاح بوصفه شرطًا مسبقًا لأي 'هدوء' لا بوصفه 'حلًّا طويل الأمد'، في حين أن هذا -على قصوره الفاضح- يتجاوز أيضًا تجربتَنا التاريخيةَ التي تؤكد أن الاحتلال لم يحترم يومًا أيةَ اتفاقات، ولم يلتزم بأية تهدئة إلا بقدر ما تفرضه عليه موازين القوة. وحتى في أشد مراحل التفاوض مع منظمة التحرير، ظل يوسِّع استيطانه، ويواصِل قمعَه، ويُعيد تعريفَ التسوية بوصفها إدارةً للصراع لا إنهاء له. فما الذي يضمن أن يكون سلوكه مختلفًا هذه المرة إذا نُزِعت المقاومة من أدواتها الدفاعية؟
لا يُخفي الطرح الإسرائيلي أهدافَه، بل إن أبرز قادة الاحتلال، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عبَّروا بصراحة عن رؤيتهم لمستقبل غزة: لا دولة، لا سيادة، لا مقاومة، لا أفق. بل إدارة مدنية محلية محدودة، تُشرف عليها إسرائيل أمنيًّا، وتُدار خدماتيًّا بتمويل خارجي. وقد جاء ذلك صراحةً في خطته التي أعلنها مؤخرًا، أن أية تسوية يجب أن تضمن 'السيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل على قطاع غزة'، مع تفكيك المقاومة وسلاحها وإبعاد قادتها، ثم استكمال مخطط ترامب بتهجير الشعب الفلسطيني وإفراغ قطاع غزة من أهله.
وتتقاطع هذه الرؤية مع طروحات أمريكية تُعيد إنتاج فكرة 'الحل الاقتصادي' بدل الحل السياسي، عبر تقديم حوافز مشروطة بالتخلي عن الكفاح المسلح، والانخراط في هندسة إقليمية جديدة، تُدمج فيها غزة ضمن مشاريع تسوية إقليمية، تَخدِم تطبيع الاحتلال مع محيطه، وتُحيِّد الساحةَ الفلسطينيةَ من التأثير على التوازنات الإقليمية.
لكن ما يُفشل هذه المقاربة في جوهرها، أن الاحتلال لا يُقدِّم شيئًا مقابل كل ما يطلبه. فحتى مع افتراض قبول فصائل المقاومة بفكرة تسليم السلاح، فإن أيًّا من الأطراف الدولية أو الإقليمية لا يضمن للفلسطينيين حقهم في دولة مستقلة، أو يوقف الاستيطان في الضفة، أو يوقف الاعتداءات على الأقصى، أو ينهي الحصار. بل إن ما يُعرض ببساطة: نزع السلاح مقابل 'هدوء مؤقت' وفتات اقتصادي، في ظل استمرار بنية الاحتلال كما هي، بل وتعزيزها.
وبذلك، فإن ما يُقدَّم، ليس إلا تكريسًا لفكرة الهزيمة، وتحويلًا لقطاع غزة من ساحة مقاومة إلى ساحة خاضعة، بلا قدرة على الرد، وبلا إمكانيات لفرض أية معادلات في وجه الاحتلال، ما يجعل من نزع السلاح –في هذه اللحظة– خطوةً في اتجاه الاستسلام، لا الاستقرار، ومحاولةً لانتزاع ما فشل الاحتلال في تحقيقه بالدم والنار، عبر أدوات الضغط السياسي والاقتصادي والمساومة على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه.
مقارَبات بديلة... ليست المقاومة وحدها من يُطلَب منها
في ظل الهجمة المركَّبة التي تستهدِف تفكيك البنية المقاومة للشعب الفلسطيني، تُطرَح فكرة نزع السلاح وكأنها 'مفتاح الحل'، ويُقدَّم التخلي عن أدوات المواجهة شرطًا مسبقًا لأية تهدئة أو إعمار أو حتى لمجرد وقف العدوان.
لكن هذا المنطق القائم على اشتراطات أحادية الجانب، لا يُنتِج سوى خلل في المعادلة، لأنه يُحمِّل طرفًا واحدًا –هو الضحية– مسؤوليةَ إنهاء الصراع، دون أي التزام جوهري من القوة المحتلة بتغيير سلوكها أو الاعتراف بحقوق الطرف الواقع تحت الاحتلال.
لا تبدأ المعادلات العادلة من نزع أدوات الدفاع، بل من معالجة جذور الصراع. وفي الحالة الفلسطينية، لا يُمكن القفز عن حقيقة أن الاحتلال أصل الأزمة، وأن تهدئة أية ساحة فلسطينية لا يمكن أن تكون عبر كسر شوكة المقاومة، بل عبر كبح جماح العدوان.
ومن هنا، تُقدِّم بعض الأطراف الإقليمية، مثل مصر، مقاربةً تبدو أكثر اتزانًا، تربط مسألة السلاح أو أية ترتيبات أمنية مستقبلية، بإطلاق عملية سياسية جادة تضمن للفلسطينيين حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وإنهاء الحصار، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة والقدس.
هذه المقاربة لا تُعفي المقاومةَ من الأسئلة الصعبة، لكنها لا تُحمِّلها وحدها مسؤولية الخروج من المأزق. بل تدعو إلى معادلة متوازنة، يكون فيها التراجع عن أدوات القوة مقرونًا بتقدُّم حقيقي في مسار استعادة الحقوق. لا أن يُطلَب من المقاومة أن تُلقِيَ سلاحها بينما يواصِل الاحتلال سياساته الإجرامية، ويوسِّع مشروعه الاستيطاني، ويعمِّق تهويد القدس، ويمنَع قيام أي كيان فلسطيني مستقل.
إن الاستسلام للضغوط الدولية بخصوص السلاح، دون وجود أفق سياسي واضح، لا يُمثِّل مخرجًا للصراع، بل بوابة لانفجارات قادمة، لأن الشعب الذي يرى أن كلفة المقاومة أقل من كلفة الاستسلام، لن يتردد في إعادة بناء أدوات المواجهة، حتى لو حُيِّدَت مؤقتًا. وهذا ما أثبتته التجربة الفلسطينية مرارًا: حين تنكسر المعادلات أو تتآكل شرعيتها، يعود الفعل الشعبي إلى الشارع، وتعود روح المقاومة بأشكال جديدة.
من هنا، لا ينبغي أن تكون 'المعالجة' من طرف واحد، وكأن المقاومة المشكلة، بل المطلوب معالجة منطق الاحتلال نفسه، وإنهاء الحصار، وإعادة الإعمار، ووقف العدوان، وفتح أفق سياسي جاد يضمن الحدَّ الأدنى من العدالة. فليس السلاح الفلسطيني مشروعًا للدمار، بل إنه مشروع للكرامة المشروطة بالعدالة، وليست أية محاولة لتفكيكه دون ضمانات خطوةً نحو السلام، بل نحو مزيد من الهيمنة والعنف البنيوي.
بكلمات أخرى، إن ما يُطلَب اليوم من الفلسطينيين ليس نزع سلاح المقاومة فحسب، بل نزع حقهم في المقاومة، وتجريدهم من وسيلتهم الوحيدة لمحاولة خلق توازن في معادلة الصراع. وما لم يكن هناك استعداد دولي وإقليمي لمعالجة هذا الاختلال، فإن كل محاولات 'الهندسة الأمنية' ستبقى حلولًا مؤقتة على رمال متحركة، سرعان ما تنهار أمام أول موجة غضب شعبي، أو أول انتهاك إسرائيلي جديد.
ختامًا، فإن طرحَ سؤال نزع سلاح المقاومة كأنَّه مفتاح الحل، وكأنَّ المشكلة في السلاح لا في الاحتلال، وفي أدوات الدفاع لا في أدوات العدوان، معاكسٌ لكل ما كشفته التجربة الفلسطينية –كما تجارب الشعوب الأخرى– أن المقاومة ليست خيارًا أيديولوجيًّا معزولًا، بل ضرورة واقعية تولد من غياب العدالة، ومن عجز العالم عن فرض الحد الأدنى من الإنصاف.
ولأن الاحتلال الإسرائيلي لا يَطلب السلام بل الاستسلام، فإن التمسك بحق المقاومة، والسلاح في قلبها، يمثِّل التمسكَ بالقدرة على البقاء كشعبٍ لا يُقهَر، لا كشعبٍ يُدار. وإن الدفاع عن هذا الحق، لا يعني رفض الحلول، بل رفض الإملاءات، وتأكيد أن أيةَ تسوية تُبنَى على أساس كسر إرادة الفلسطيني، وسلبه أدوات المواجهة، تسويةٌ لن تصمد، لأنها ببساطة لا تَحترم الحقيقةَ ولا تعالج الجذر.
إن ما فشلت آلة الإبادة في تحقيقه يجب ألَّا يُنتزع الآن بأدوات الضغط السياسي والمساومة تحت عنوان الهدوء أو إعادة الإعمار. فالسلاح هنا، ليس ترفًا عسكريًّا، بل حصيلة دماء، وتجربة كفاح، وحق أصيل في الدفاع عن الأرض والكرامة. وإن المقاومة التي لم تنكسر في وجه الحصار والعدوان لن تسمح بتحويل صمودها إلى هزيمة سياسية تُفرَض عليها بغطاء دولي.