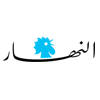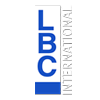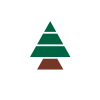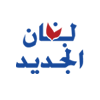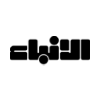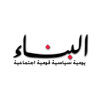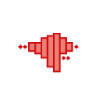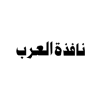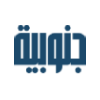اخبار لبنان
موقع كل يوم -جريدة اللواء
نشر بتاريخ: ١٧ أيلول ٢٠٢٥
د. رفيف رضا صيداوي*
في روايتها «هند أو أجمل امرأة في العالَم» الصادرة حديثاً عن دار الآداب في بيروت، تتابع هدى بركات في مسارها الروائيّ مُساءَلة بؤس العالَم، بتنويع حكاياتها وتقنيّات سردها، ولا سيّما بابتداع شخصيّاتها وتشكيلها. لكنّ هذا اللّعب والتنويع لدى بركات، لا يحيد عن محاولة القبض على التغيّرات التي يشهدها العالَم ولبنان، وعلى مَفاصِل الوجع الإنسانيّ.
لم تَعمد هدى بركات في روايتها الجديدة إلى تبديل مَواقِع السرد، بل تركته، على طول الرواية، مُسترسَلاً حرّاً مُنساباً من طرف الراوية الرئيسيّة والشخصيّة الرئيسيّة «هنادي» التي شكَّلت عنصراً أساسيّاً من عناصر البنية السرديّة؛ فنتعرَّف إلى مواقفها وتأمّلاتها الفكريّة وأسلوبها الخاصّ في الوجود والإحساس، كما في إدراك الآخرين والعالَم. تحكي هنادي وجَعها الممتدّ زمنيّاً بين ماضٍ وحاضرٍ بائسَيْن ومستقبلٍ مجهول. هي المُعلَّقة بين الأزمنة، لكن غير المُتعلّقة بالأمكنة. فهي لم تَعُد من باريس إلى لبنان «حبّاً أو اشتياقاً»، كما تصرِّح في أوّل تلفّظ لها في الرواية، بل «بسبب أنَّ أرض اللّه الواسعة لفظتْني. وجدتُ نفسي على الرمل، عند حافّة المَوج كالحيتان النّافقة».
هنادي العائدة من رحلة تشرّدها الطويلة في فرنسا إلى بيروت، هي إنسانة مُهمَّشة ومنبوذة، نبذتها أمّها في عليّة مطبخ منزلهما في لبنان بعدما تحوَّلت من طفلةٍ فائقة الجمال إلى إنسانة فائقة القبح، أشبه بمسخٍ نتيجة مرض «الأكروميغاليا» الذي يصيب غدّة الدماغ ويُسبِّب تضخُّم الأطراف (قويّة العضل لكنْ هشَّة العظام والمفاصل، مقوَّسة الظهر، فكّاها كفكَّيْ رجل، منفوخة الحاجبَيْن كالقردة... إلخ)؛ إذ كان جمال هنادي سيعوِّض الأمّ عن ابنتها البكر «هند» التي غيَّبها الموت قَبلَ ولادة هنادي. لكنّ هنادي نجحت في الهربِ من سجنها في العليّة لتستقرَّ في باريس.
انطلاقاً من هذه الشخصيّة المشوّهة والمعطوبة، بَنَتْ هدى بركات خطابها الروائيّ في تناظُرٍ فنّيّ بديع بين هنادي من جهة ولبنان من جهة ثانية، المشوَّه والمعطوب بدَوره بفعل الحرب الأهليّة وبفعل الأحداث اللّاحقة (انفجار المرفأ، الجمود الاقتصادي، الفقر والتهميش، تراكُم النفايات، انقطاع الكهرباء...) التي أمعنت في تشويه البلد وعاصمته بيروت، حيث كان هناك منطقة اسمها النهر وباتت اسماً من دون مسمّى، وحيث لا مجرىً لهذا النهر الذي تجري فيه المجاري والأوساخ، وتُشير إليه هنادي في سياق جلوسها المفضَّل عند حافّته، بتكرارها عبارة «حافّة النهر الذي ليس نهراً»، «حافّة النهر الذي يسمّونه نهراً وهو ليس كذلك»... إلخ، تماماً كاللّازِمة.
بين ضفّة نهر السين الجميل حيث كانت هنادي تجلس تحت أشجار الصفصاف الخضراء دوماً برفقة العربيّ المُسلم «رشيد» المعطوب والمُهمَّش أيضاً، وحافّة نهر بيروت الذي لم يعُد نهراً، تقاطعت الرواية مع رواية «بريد اللّيل» (2019) التي أطلّت فيها هدى بركات على إنسان مُجتمعات العالَم الثالث، ولا سيّما العالَم العربيّ، المُهمَّش بحسب مقاييس توزُّع خارطة القوى العالَميّة أو بحسب مقاييس التوزُّع الجغرافي (شمال وجنوب)، أو بحسب مقاييس التقدُّم والتخلُّف، وكأنّها تُسائل بؤس العالَم الرّاهن وظلمه. في حين أنّها في اشتغالها على شخصيّة هنادي التي تُحاكي في تشكُّلها تداعيات حروب لبنان وتحوّلات القيَم والتهميش والإفقار، تتقاطع مع خطاب رواياتٍ سابقة لها كرواية «حجر الضحك» (1990) أو «أهل الهوى» (1993) في إبراز بعض ملامح هذه التحوّلات. بحيث كان الضحك في الرواية الأولى مجازاً لخطابٍ روائي يَستكشف تفاصيل التهافُت القيمي الأخلاقي الذي أفرزته الحرب في لبنان، ودفعتْ به إلى السطح. وكشفت استعارته عن تجربةٍ معيشيّة لا يستوعبها الاستخدام العادي للغّة، بحسب بول ريكور.
ضحكُ خليل بطل «حجر الضحك» تحوَّل مع تحوُّل الشخصيّة من طبيعتها اللّيّنة المُسالِمة إلى أخرى قاسية، فغدا ذاك الضحكَ القاتلَ الذي استأثَرَ به أسيادُ الحرب. ضحْكُ الفاسقين الجشعين الذين يستبيحون كلّ القيَم من أجل المصلحة الخاصّة والثروات الطائلة. أمّا ضحكُ الشخصيّة الرئيسيّة في «أهل الهوى» التي أفضت بها الحرب إلى الجنون والقبوع في مصحٍّ للأمراض العقليّة فأضحى حاملاً دلاليّاً لضحك المجانين «المُسالِمين» (أو شواذ القاعدة) على مَن هُم خارج المصحّات.
كلّ هذه المجازات التي حملتها روايات هدى بركات، سواء في مجاز الضحك أم الجنون أم الذكوريّة الفائقة أم غيرها، انبنتْ على شخصيّاتٍ روائيّة مشوَّهة ومعطوبة يحكي تشوُّهُها انقسامَ العالَم إلى طبقتَيْن: طبقة مَن هُم فوق، وطبقة مَن هُم تحت، أي المُهمَّشين والفقراء الذين نقرأ من خلال تشوّهاتهم وإعاقاتهم تشوّهات العالَم ولبنان وإعاقاتهما. وكأنّ عالَم الـ «تحت» الذي تنتمي إليه هنادي اللّبنانيّة التي خبرتِ الغربة خلال عيشها الطويل في فرنسا يختلف عن نظيره في الغرب بالنَّوع لا بالدرجة.
العيش على الحافّة
هنادي، كسائر الشخصيّات في روايات هدى بركات، إنسانة تعيش انفصاماً وازدواجيّةً على مستوياتٍ مختلفة. ازدواجيّة هويّتها الجنسيّة لكونها فيزيقيّاً أقرب إلى شكل الذكر بسبب المرض («فأنا على ما يبدو ويَظهر أنثى» تقول هنادي - ص141). وازدواجيّة الأزمنة، ولا سيّما زمنها الحاضر الذي لا يختلف في لبنان عن أيّ أزمنةٍ أخرى: «أختان توأم أنا وهند، في زمنَيْن مُختلفَيْن. زمنان مختلفان لكنّهما اختلفا بلا معنى، في تفاصيل صغيرةٍ بلا معنى» (ص119)، بمقدار ما أنّ اللّيل لا يختلف عن النهار، إلّا بحسب إيقاع حياتها هي وضَجَرِها هي، ولا سيّما بعدما أضحت أكثر مَيلاً إلى العزلة. ناهيك بعلاقاتها سواء تلك التي ربطتها بأمّها التي عادَت هنادي إلى بيروت لتقطنَ في ذاكرتها بعدما كانت قد هربَتْ منها، أم بـ»رشيد» الحبيب المعوّق المُقيم في فرنسا وهويّته الضائعة بين الوحشة والتهميش و«الكراك» وقليلٍ من الصحو وكثيرٍ من النَّوم («أنا أحببتكَ رشيد لأنّك أشفقتَ عليَّ ثمَّ أحببتني، ولو قليلاً، وربّما لأنّه لم يحبّني أحدٌ» - ص158)... ثمّ غادرته لقناعتها بأنّ للأشياء نهاياتها، وبأنّ «الحبّ لا يقيم لمدّة غير محدودة» (ص239)..أَم بالأب المجهول والغائب الحاضر، أَم بنبيل العامل البسيط الذي اختفى من حياتها في بيروت فجأةً، أم بقطّتها البيروتيّة زكيّة أو زاكو المعوّقة العوراء ذات القوائم الثلاث، وصولاً إلى المكان (فرنسا/ لبنان - الشقق البائسة/ الشارع)... وهي كلّها ازدواجيّات تلعب على نوتة واحدة: نوتة الغربة حين تكون مُعاشة من أشخاصٍ معطوبين ومعوّقين وفقراء ومُهمَّشين؛ فتغدو غربتهم في أوطانهم أم في خارجها، بحدّ ذاتها، عَطَباً وإعاقة.
وإذ يضيق المجال عن الإحاطة بكلّ المضامين الرمزيّة لنصّ هدى بركات ودلالاته، نعود إلى مجاز العطب والإعاقة الذي انطوى عليه نصّها الجديد، وإلى دلالتَيْه: هنادي التي تعيش على حوافي الأشياء لا في الأشياء نفسها، ربّما بسبب قساوة الحياة عليها التي جَعلتْها تنأى عن التعلُّق بها لتَبتدعَ قانونها الخاصّ: «كنتُ أتعثَّر وأقف، من دون أن أحظى بوقتٍ للتفكُّر أو التردُّد. كانت المَوجات التي ترديني متلاحقة، فلم يتسنَّ لي أن أتعلَّم السباحة. قبلتُ بقانون البحور والشطآن، وقلتُ إنَّ دَوري وواجبي هو أن أنهض من جديد، من دون أسئلةٍ كثيرةٍ ومن دون مساعدةٍ من أحد. هذه هي العِبرة. هذا سيكون قانون حياتي...» (ص153). لكنّ الديناميّة التي منحتها هدى بركات لشخصيّتها جعلتها مواكِبة في تحوّلاتها، ولا سيّما على مستوى الأفكار والمواقف والسلوكيّات والأحاسيس، لتحوّلات البلد في تداعياته وبؤسه، ومُتناظرة معها. فبدَت هنادي إنسانةً فاقدةً الأمل من الحياة والمُجتمع الذي لا يتكفَّل إلّا بالأقوياء ولا يحلو إلّا من منظارهم وبعيونهم لأنّهم أسياده؛ وبالتالي مضى ضجرٌ مُستجدّ يضغط عليها مع الوضعيّة المُستجدّة لمدينة بيروت منذ كارثة انفجار مَرفئها وتداعيها كأنّها تَحتضر؛ وذلك في سياقِ اتّحادٍ وتزامنٍ فنّيّ رائع بين وضعيّة بيروت التي يبدو أنّها باتت مُصابة شأن هنادي بمرض الأكروميغاليا الذي اشتدَّ عليها مع الأيّام: «الآن صرتُ أضجر أيضاً من ثقل حركتي، ربّما بسبب تقدّمي في السنّ، وتأخّر جسمي في تلبية ما أنوي القيام به، مهما كان» (ص221). أمّا الدلالة الثانية، فتكمن في انفتاح النصّ على خواء الحياة وخواء معانيها في وطنٍ تفترق الناس فيه كثيراً «وتنسى بعضها من دون سببٍ مهمّ. فقط لأنّ عجلات الحياة تدور» (ص203). حتّى النهر الذي ليس بنهر ضاقَ الشريط الترابي المُحاذي له، «ولم يتبقَّ من جذْع شجرة الصفصاف المقصوفة سوى شظايا عموديّة (...) صارت الصفصافة التي لم تعُد تشبه الصفصاف في شيء، صورةً في الذاكرة البعيدة للأشجار» (ص272).
أمّا ماذا بقيَ من ذلك كلّه؟ فبقيتِ الاستعاراتُ فقط. استعارَتْ هدى بركات المرضَ والأعطابَ والإعاقات للتعبير عن عالَمٍ يتهاوى ويتصدَّع. واستعارَتْ لبطلتها قرينةً تُقرنها بكلّ ما تكرهه من قتلٍ ووسخٍ لكونها، أي القرينة، وبحسب الروايات الموروثة، توأماً لكلّ إنسان؛ إذ تولد معه وتعيش تحت الأرض في عالَم الجنّ الموازي لعالَمِ البشر، وتَخضع لأحكام الغرائز. فتحملنا هذه الاستعاراتُ على التساؤل عمّا إذا كان عالَمُ الجنّ هذا كما تقول الخرافة هو الذي يُسيّرنا كبشر أو أنّ الواقع ومجرياته السرياليّة بات هو الذي يُثبت صدقيّة الخرافة؟ وعمّا إذا كانت «الخرافة بَلسماً والنسيانُ رحمة» كما استنتجتْ هنادي؟
----------------
* مؤسّسة الفكر العربي
(يُنشر هذا المقال بالتزامن مع دورية «أفق» الإلكترونيّة الصادرة عن مؤسّسة الفكر العربيّ)