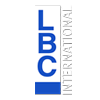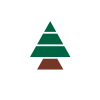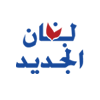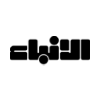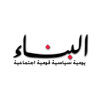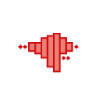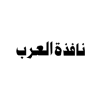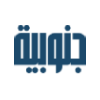اخبار لبنان
موقع كل يوم -جريدة اللواء
نشر بتاريخ: ١٣ أيلول ٢٠٢٥
د. خالد صلاح حنفي*
لم يَسبق في تاريخ البشريّة أن شهدَ التعليمُ تحوّلاً مُتسارِعاً وشاملاً كذاك الذي نعيشه اليوم في عصر الرقْمَنة. ففي أقلّ من عقدَيْن، تحوّلتِ الفصولُ الدراسيّةُ من فضاءاتٍ حضوريّة قائمة على التفاعُل البشريّ إلى بيئاتٍ رقميّة افتراضيّة تتوسّطها الشاشاتُ وتُديرها خوارزميّات الذكاء الاصطناعيّ، ويُسيّجُها جدولٌ زمنيّ محكم يُقاس بالدقائق والثواني.
لقد أَظهر تقريرٌ صادر عن اليونسكو في العام 2024 أنّ أكثر من سبعين في المائة من الدول أَدخلتْ منصّاتٍ رقميّة إلزاميّة في التعليم العامّ، وأنّ نسبة استخدام التكنولوجيا في التدريس ارتفعتْ بنسبة ثلاثمائة في المائة منذ العام 2020. لكنّ هذا التّسارُع التقني لم يُواكَب بقفزةٍ مُماثِلة في تطوير البُعد الإنسانيّ للتربية.
في هذا السياق، لم تَعُد الأنْسَنةُ مجرّد مَطلبٍ أخلاقي أو تجميلٍ أيديولوجي للخطاب التربويّ، بل صارت ضرورةً حضاريّةً مُلحّة. فكلّما تقدَّمت التكنولوجيا، وتعقّدت الآلات، وازدادت سرعة المُعالَجة، تضاءَلَ التفاعُلُ البشريّ، وتراجَعتِ المهاراتُ العاطفيّة، وانكمشَ الفضاءُ المُتاح للتعاطُف، والتأمُّل، والتفكير الأخلاقيّ. وقد أَظهر تقريرٌ لمنظّمة التعاوُن والتنمية الاقتصاديّة أنّ نحو 615 مليون طفلٍ حول العالَم، على الرّغم من التحاقهم بالمدارس، لا يَمتلكون المهارات الأساسيّة في القراءة والكتابة، لكنّ الأعمق من ذلك هو أنّ نسبةً كبيرة منهم تُعاني من نقْصٍ حادٍّ في المهارات الاجتماعيّة والعاطفيّة مثل التعاطُف، وضبْط النَّفْس، والقدرة على حلّ النّزاعات. وهذه المهارات تُعدّ اليوم من الركائز الأساسيّة للنجاح الشخصيّ والمُجتمعيّ.
لكنّ الحاجةَ إلى الأنْسَنة لا تَنبع من تحوّلاتِ التعليم فقط، بل من طبيعة العالَم الراهن نفسه، الذي يعيش تصدّعاتٍ وجوديّة عميقة؛ يُمزِّقها التوتُّرُ بين التقدُّم المادّيّ والانحطاط الأخلاقيّ، بين الاتّصال الرقميّ والانفصال البشريّ، بين الثروة المعرفيّة وفقر القيَم. وفي عالَمٍ تُهدِّد فيه الحروبُ استقرارَ المُجتمعات، ويُهدِّد فيه التغيُّرُ المناخي كيانَ الكوكب، وتُهدِّد فيه وسائلُ التواصُل الاجتماعيّ الصحّةَ النفسانيّة للشباب، تَصير التربيةُ الإنسانيّة خطَّ دفاعٍ أوّل ضدّ الانهيار الحضاريّ؛ فكيف نُربّي أجيالاً قادرةً على بِناء السلام، بينما تُدرّبهم مناهجهُم على المُنافَسة المفرطة؟ وكيف نُشكِّل مواطنين عالَميّين، بينما تُنمّي وسائلُ الإعلام لديهم الكراهية والتمييز؟
الهويّة الرقميّة بُعْدٌ وجوديّ جديد
أَظهرتْ دراسةٌ حديثة نُشرت في مجلّةٍ طبيّةٍ دوليّة أنّ أكثر من نصف المُراهقين في عيّنةٍ شَملت دولاً عدّة يُعانون ممّا يُعرف بـ Eco-Anxiety، أي القلق الوجوديّ النّاتج عن تدهْورِ البيئة، حيث يَشعر هؤلاء الشباب بالعجز أمام كارثةٍ مناخيّة لا يملكون أدوات التأثير فيها. وهذه الظاهرة لا تُعَدّ مجرّد اضْطرابٍ نفساني، بل هي استجابة أخلاقيّة لانعدام العدالة البيئيّة، وهنا تَبرز الأنْسَنَةُ كأداةٍ تربويّة لإعادة إعطاء الفرد شعوراً بالقدرة على التأثير، من خلال تعليمه أن يكون مسؤولاً، لا ضحيّة.
كما أنّ الهويّة الرقميّة صارت تُشكّل بُعداً وجوديّاً جديداً في حياة الإنسان، إذ لا يعيش الفرد اليوم في الفضاء الماديّ فقط، بل في فضاء افتراضيّ دائم التوالُد، حيث تُصنّفه الخوارزميّات، وتُشخّصه البيانات، وتُحوّله إلى «ملفّ سلوكيّ». وفي هذا الفضاء، تُختزل الإنسانيّة في تفاعُلاتٍ رقميّة، وتُستبدَل العلاقات الحقيقيّة بالإعجابات والتعليقات. وقد وُثِّق في تقريرٍ لمنظّمة الصحّة العالميّة أنّ ما يُقارب أربعين في المائة من المُراهقين يُعانون من اضْطراباتٍ في الهويّة بسبب التعرُّض المُفرط للصور المثاليّة على وسائل التواصُل، ما يُولِّد شعوراً بالدونيّة وفقدان الثقة بالنَّفس. وهذه الظاهرة تُظهِر أنّ التربية لم تَعُد مَهمّة تربويّة فحسب، بل عمليّة إنقاذٍ وجوديّ، تهدف إلى استعادة شعور الإنسان بذاته، وبقيمتِه، وباستقلاليّته.
والأنْسَنة، في هذا السياق، ليست مجرّد مُحاوَلة للحفاظ على «اللّمسة الإنسانيّة» في التعليم، بل هي مشروع مقاوَمة تربويّة ضدّ التفكيك المُمنْهَج للإنسان. فهي تُقاوِم التجزئة بين العقل والقلب، بين المعرفة والأخلاق، بين الفرد والمُجتمع. وهي تُذكّر بأنّ الإنسان ليس كائناً قابلاً للبرْمَجة، بل إنّه كائنٌ مُبدع، مُتأمِّل، مُتعاطِف، قادرٌ على الحبّ، والتسامُح، والابتكار الأخلاقيّ.
ومن الناحية الفلسفيّة، تُعيد الأنْسَنةُ طَرْحَ السؤال الكانطيّ الأصيل: «ما هو الإنسان؟»، لكن في سياقٍ تربوي مُعاصِر يُهدِّد فيه التقدّمُ التقني بإعادة تعريف الكائن البشريّ ككائنٍ وظيفي. فكما رَفَضَ كانط مُعاملة الإنسان كوسيلة، ورآه غايةً في ذاته، فإنّ التربية الإنسانيّة تَرفض أن تُعامِل الطالب كمجرّد رقمٍ في سجلّ، أو ككائنٍ يَجب تكييفه مع متطلّبات سوق العمل، بل تُعامله كفاعلٍ أخلاقي، قادرٍ على الاختيار، والمسؤوليّة، والتغيير. وهذا الموقف يُناقِض الأنموذج النيوليبراليّ السائد في كثيرٍ من السياسات التعليميّة، الذي يُحوِّل الطالبَ إلى «رأس مال بشريّ» يَجب استثماره لتحقيق النموّ الاقتصاديّ. وقد سجَّلت دراسةُ مؤسّسة بروكنغز أنّ سبعين في المائة من سياسات التعليم في الدول النامية تُركِّز على «المُلاءَمة مع احتياجات السوق»، بينما لا تَتجاوز نسبةُ السياسات التي تُولي اهتماماً صريحاً بالتنمية الأخلاقيّة والروحيّة اثنَيْ عشر في المائة فقط.
وتُظهر دراساتٌ عدّة أنّ النّظامَ التعليميّ غالباً ما يُوظَّف كأداةٍ للتأقلُم مع الوضع القائم، لا لتحدّيه. وهنا تكمن أهميّة الأنْسَنة: فهي لا تُربّي على التسليم، بل على التساؤل، ولا تُربّي على الطّاعة، بل على التفكير النقديّ. وقد أَشارت أبحاثُ مركز دراسات التربية والنقد الاجتماعيّ في باريس إلى أنّ المدارس التي تُطبِّق مناهج قائمة على الحفْظ والتلقين، وتُقصي الحوارَ والمُساءلة، تُسهِم - ولو بشكلٍ غير مباشر - في ترسيخ سلطات القبول والانقياد، وهو ما يُوصَف بـ «التربية الآليّة». أمّا من منظور ميشيل فوكو، فإنّ الأنْسَنة تُشكّل تمرُّداً ضدّ «الرقابة التربويّة» التي تُنتج الأفراد وفْقَ نماذج موحَّدة، وتُهمِّش مَن يَخرج عن الإطار. فالتربية الإنسانيّة، في هذا السياق، تُعيد الاحترام للتنوُّع وتَراه مَصدر ثراء. ولا يُمكن الحديث عن الأنْسَنة في العصر الرقميّ من دون التوقُّف عند التحدّيات الهيكليّة التي تُهدِّد تحقيقها. فأوّل هذه التحدّيات هو الهيْمَنة التقنيّة، التي حوَّلت الفصلَ الدراسي إلى فضاءٍ رقميّ، تَغيب فيه النظرة، والابتسامة، ولهفة السؤال. وقد أَظهرت دراسةٌ أَجرتها منظّمة الصحّة العالميّة بالتعاون مع اليونيسيف أنّ متوسّط الوقت الذي يقضيه المُراهِق في تفاعُلٍ بشريّ مُباشر مع معلّمه لا يتجاوز اثنتَيْ عشرة دقيقة يوميّاً، بينما يَقضي أكثر من ستّ ساعات وثلاث وعشرين دقيقة أمام الشاشات، وفق بيانات معهد بيو للأبحاث. وقد ارتبطَ هذا الانفصال بالارتفاع المُقلق في حالات القلق والاكتئاب بين الفئة العمريّة 12-18 عاماً، حيث سجَّلت منظّمةُ الصحّة العالميّة ارتفاعاً بنسبة 52 في المائة في اضْطرابات الصحّة النفسانيّة بين المُراهقين خلال العَقد الماضي.
ثاني التحدّيات هو الانفصال بين المدرسة والمُجتمع. فالمناهج، في كثير من الأحيان، تُدرِّس مفاهيم عالَميّة مجرَّدة، لكنّها تَفشل في ربْطها بالواقع المحليّ، بالهويّة، بالقيَم السائدة. وقد أَظهر تقريرٌ للبنك الدوليّ أنّ نسبة الطلّاب العرب الذين يرون أنّ المَناهج لا تَعكس ثقافتَهم أو قيَمَهُم تَصل إلى 68 في المائة، ما يولِّد شعوراً بالاغتراب. ثالث التحدّيات هو الضغط الأكاديميّ المُفرط، الذي حوَّل الطالِبَ إلى «مُنتجٍ» يجب أن يُحقِّق أقصى عائدٍ من المعرفة في أقصر وقت. ولتجاوُز هذه التحدّيات، لا بدّ من بناء أنموذجٍ تربويّ إنسانيّ متكامل، يقوم على إعادة تعريف نجاح الطالَب، بحيث لا يُقاس بالدرجات فقط، بل بالاستعداد للعطاء، والقدرة على التعاطُف، ومستوى المُشارَكة المجتمعيّة. وقد أَظهرتْ دراسةٌ لمنظّمة التعاوُن والتنمية الاقتصاديّة أنّ الطلّاب الذين يتلقّون تعليماً مُرَكّزاً على المهارات الاجتماعيّة والعاطفيّة يُسجّلون تحسُّناً بنسبة 13 في المائة في الأداء الأكاديميّ، وتقلّ لديهم السلوكيّات السلبيّة بنسبة 27 في المائة.
الأنْسَنة في العصر الرقميّ
ولا يُمكن تجاهُل ضرورة دمْج القيَم الإنسانيّة في جميع الموادّ، لا كمُقرَّرٍ مُنفصل، بل كإطارٍ مفاهيميّ يُستخدم في تدريس التاريخ، والعلوم، والرياضيّات. كما أنّ التعليمَ القائم على المشروعات الخدميّة هو وسيلةٌ فعّالة لربْط المدرسة بالواقع، حيث يُشارِك الطلّاب في حلّ مُشكلاتٍ مجتمعيّة حقيقيّة، ما يُشعرهم بالانتماء والقدرة على التأثير. وقد أَظهر تقييمٌ لبرنامج «التعلُّم من أجل السلام» المُشترَك بين اليونيسيف ومفوّضيّة الأُمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين أنّ 83 في المائة من الطلّاب المُشارِكين في مشروعاتٍ تطوّعيّة تَحسَّنَ لديهم الشعور بالمسؤوليّة، وانخفضتْ حالاتُ التنمُّر المدرسيّ بنسبة 44 في المائة.
إنّ الأنْسَنة في التربية ليست تَرَفاً فكريّاً، بل استراتيجيّة حضاريّة للبقاء؛ ففي عالَمٍ يُهدِّد فيه الذكاءُ الاصطناعيّ بتجاوُز الإنسان، تُصبح القيَمُ الإنسانيّة هي الميزة التنافسيّة الوحيدة للبشر. فالإنسان لا يَتفوَّق على الآلة بسرعته في الحساب، بل بقدرتهِ على الشعور، والحبّ، والتسامُح، والابتكار الأخلاقيّ. ومن هنا، فإنّ بناء الإنسان المُتكامل - الذي يَجمع بين العِلم والروح، وبين العقل والقلب - ليس رفاهية تربويّة، بل ضرورة وجوديّة. فالتربية التي لا تُؤنْسِن، تُنتِج كائناتٍ فاقدة االلهويّة، مُفكَّكة القيَم. أمّا التربية الإنسانيّة، فهي تُعيد للإنسان كرامته، وتُعيد للمُجتمع تماسُكَه، وتُعيد للحضارة إنسانيّتَها. في النهاية، لا يُمكن أن نبني مُدناً، ثمّ نُهمل بناء الإنسان الذي يسكنها. فالحضارة الحقيقيّة لا تُقاس بارتفاع الأبراج، بل بعُمق القلوب، ونقاء النوايا، واتّساع الأُفق. والتربية، في هذا المعنى الأسمى، ليست نقلاً للمَعرفة، بل إشعال روح.
* أستاذ أصول التربية - جامعة الإسكندريّة
(يُنشر هذا المقال بالتزامن مع دورية «أفق» الإلكترونيّة الصادرة عن مؤسّسة الفكر العربيّ)