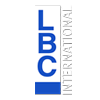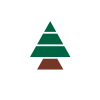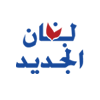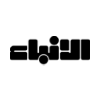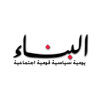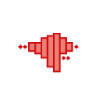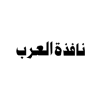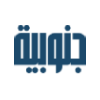اخبار لبنان
موقع كل يوم -نداء الوطن
نشر بتاريخ: ٢٣ نيسان ٢٠٢٥
ليست الإصلاحات التي قادها البابا فرنسيس مجرّد تغييرات إدارية أو تعديلات تنظيمية في بُنية الكنيسة، بل هي وقفة نبوية وسط ضجيج العالم، تُعيد قراءة الإيمان من موقع الألم الإنساني والتاريخ الجريح. البابا، اليسوعي المتشبع بلحم الأحياء في شوارع بوينس آيرس، لم يأتِ إلى الفاتيكان من برج أكاديمي أو دير معزول، بل حمل معه لهاث المقهورين، وقراءة نقدية لتاريخ الكنيسة المتشابك مع سلطات العالم ومؤسساته.
فرنسيس لا يُصلح، بل يُعيد التأسيس. لا يُجمّل، بل يكشف. يرى أن الإصلاح ليس 'عملية'، بل موقف وجودي ولاهوتي في قلب العالم. الإصلاح عنده يبدأ من السؤال: 'من أجل من الكنيسة؟'؛ فإذا لم تكن من أجل الإنسان، في هشاشته، في تهميشه، في صراخه، فلا حاجة لها. هذا المبدأ البسيط ظاهرياً، هو في جوهره ثورة فلسفية ولاهوتية على نموذج كنسي هرمي مغلق، وعلى لغة سلطة استعلائية فصلت الروح عن الجسد، والطقس عن التاريخ.
من هنا نفهم أن إصلاح الكوريا الرومانية، وإنشاء هيئات الشفافية، وضبط إدارة المال الكنسي، لم تكن خطوات تقنية باردة، بل محاولات لتفكيك البنية السلطوية التي حجبت الله عن الناس. السلطة، في فكر فرنسيس، لا تُفهم إلا كخدمة، والإيمان لا معنى له إن لم يُترجم عدالة ورحمة. هذا ما جسّده في وثيقته Evangelii Gaudium حيث لا يدعو فقط إلى 'كنيسة فقيرة من أجل الفقراء'، بل إلى كنيسة تخرج من ذاتها وتلتحم بالهامش، كنيسة لا تخاف من 'رائحة الخراف'.
البعد الثوري لمشروع فرنسيس يرتبط بجذوره اليسوعية – حيث الحرية الداخلية، والتفكير النقدي، والرسالة في قلب العالم – كما يرتبط بروحه اللاتينية المتأثرة بلاهوت التحرير، ذاك اللاهوت الذي لا يرى الله في السماء وحسب، بل في دموع الأطفال، وجوع العمال، وقهر النساء. ليس عجيباً إذاً أن تُحدث وثيقته Laudato Si صدمة في دوائر الاقتصاد العالمي، لأنها لا تتحدث عن البيئة كموضوع بيئي، بل كموضوع عدالة كونية، حيث صرخة الأرض تتماهى مع صرخة الفقير.
البابا فرنسيس لا يقدّم وصفات إصلاحية، بل يفتح جراح التاريخ ويدعو الكنيسة إلى التعرّي أمامها. يدعوها إلى سؤال الذات لا الدفاع عنها، إلى السير مع الشعوب لا فوقها. وهو حين يطلق السينودسية كنمط حياة كنسي، لا يسعى إلى توزيع الأدوار، بل إلى تأسيس نمط جديد من التفكير، تشاركي، أفقي، يُنصت أكثر مما يقرر، يُرافق أكثر مما يحكم.
في العمق، مشروع فرنسيس ليس مؤسساتياً بقدر ما هو أنتروبولوجي-لاهوتي: إعادة بناء الكنيسة انطلاقاً من نظرة مختلفة إلى الإنسان. الإنسان ككائن في مسار، في صراع، في جوع إلى المعنى. بهذا المعنى، فإن كل إصلاح قام به البابا فرنسيس هو علامة نبوءة في عالم يتفكك تحت ثقل الفردانية، والتهميش، وعبادة السوق.
قد لا تُرضي هذه الإصلاحات جميع التيارات، وقد لا تذهب إلى حيث يطمح الراديكاليون، لكنها كشفت بوضوح أن الكنيسة ليست حصناً مغلقاً بل ساحة حريّة ولقاء، وأن الإيمان الحقيقي لا ينعزل عن التاريخ بل يُخضِعه لسؤال الإنجيل: 'أين أخوك؟'.
ومع رحيل البابا فرنسيس، لا تفقد الكنيسة مجرد حبر أعظم، بل تخسر صوتاً نادراً جعل من السلطة فعلاً للتجرد، ومن الكرسي الرسولي منبراً للصراخ في وجه الظلم. ستفتقد الكنيسة راهباً حمل في عباءته همّ العالم بدل أوسمة المجد، وعقلاً آمن أن الإيمان لا يحيا إلا إذا سار في طرق الفقراء. ستفتقد قلباً لا يخاف الحقيقة، حتى حين تجرح المؤسسة، ورؤيةً كانت تحلم بكنيسة لا تتزين بالخوف بل بالحرية.
بموته، لا ينتهي مشروع الإصلاح، بل يدخل امتحان التاريخ: هل نملك نحن الجرأة لمواصلة المسيرة؟ هل نصغي حقاً إلى ما بشّر به، لا بالكلام، بل بالحضور؟ وهل نجرؤ على أن نُتمّم تلك النبوءة: أن تكون الكنيسة بيتاً مفتوحاً لكل الجائعين إلى العدالة؟
رحل البابا، لكن سؤاله لا يزال حياً فينا: ماذا يعني أن نكون كنيسة في قلب العالم؟