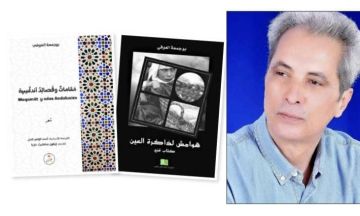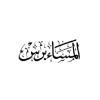اخبار اليمن
موقع كل يوم -شبكة الأمة برس
نشر بتاريخ: ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥
حاوره: عبد اللطيف الوراري
في سياق التحول الشكلي والجمالي الذي يشهده شعرنا المعاصر، وبموازاة مع صعود قصيدة النثر والتأثر بنماذجها الكبرى، أخذ الوعي لدى الشعراء بِشَرط كتاباتهم الكتابي يتقوى ويبرز بشكل أكثر حدة، حتى وجدنا لديهم ضروبا من الكتابة التي لا تخضع لقواعد، أو على الأقل تفرض قواعد خاصة بها تُفجرها من داخلها، وإلى تشظية وعي الأنا بنفسها وبالعالم، مثلما عملت على تشذير البناء النصي، وأولت الدال المادي للكتابة الأسبقيةَ في تشييد متخيلها وتفجيره في آن. من اللعب باللغة إلى تفضئة الصمت والفراغ وشعرنة الأثر، صار هذا الشعر، في المغرب كما المشرق على حد سواء، يطرح جماليات مغايرة وجديدة في فهم العلامة الشعرية وتأويلها، من منطقٍ يُحطم العلاقات التقليدية لبعدي الزمان والمكان، ويُفجر وحدة الدليل اللغوي وانسجامه العقلاني، فيما هو ينتهك احتمالات الدلالة ويعطي أسبقية لمحسوسية الدال وامتداده في الكتابة باعتبارها نصا ديناميا مفتوحا يتجاوز حدود النوع. ينبغي أن تقرأ الكتابة كعلاقات حادة تتم في اللغة وعبرها، كما لم تُقرأ من قبل. من الكتابة إلى إعادة الكتابة، ليس ما يُكتب هو ما يهم داخل فضاء الصفحة، بل ما يُشكل ويُعاد توزيعه خطيا ومقطعيا، متوترا في البياض والفراغات والخطوط، كما في علامات الترقيم التي تستعيض عن البعد الشفاهي- الإنشادي لنص الكتابة في ماديته وانشراحه الأيقوني.
بموازاة مع هذا القلب الكتابي، لم تعد مثل هذه الكتابة مجرد شكل أو أسلوب، وإنما هي تحمل محتوى يعكس فلسفة ما، وفهما خاصا للذات والكتابة واللغة والعالم، إذ تطبعه روح المفارقة، ويقف ساخرا أو لَوْذعيا أو غير مُبالٍ من حياتنا المعاصرة في شكل ومضات وتشذرات تفكك وهم الواقعي وترصد منطق الخلل الذي يهيمن على تلك الحياة ويدمرها.
في طليعة شعرائنا المعاصرين الذين أَوْلوا البعد البصري – التشكيلي قيمة قصوى، في ممارسته الإبداعية ودراساته النقدية، نجد الشاعر المغربي بوجمعة العوفي. فهذا البعد حمل ـ في نظره- آثارا جمالية جديدة إلى الشعر المعاصر، الذي لم يعد مجرد كلام يُقال، بل صار تجربة شاملة للحواس، تعيد بناء معطيات العالم وكشفه في آن.
■ كيف جاء بوجمعة العوفي إلى الشعر، وعقد عليه زمام كينونته؟ هل تذكر واقعة من ماضيك الشخصي شدتك إلى هذا الكائن الغامض؟
□ أعتقد أن الشعر، في تجربتي، لم يكن خيارا عابرا، بل رغبة باكرة متجذِرة، ككائن غامض أخط إليه منذ الطفولة. ربما لم تكون هناك «واقعة واحدة» حاسمة تقف عندها البداية، بقدر ما هي سلسلة من اللحظات الصغيرة التي شكلت مكامن الحضور الشعري في داخلي. أذكر، حينما كنت شابا، أن أول تجربة لي مع الشعر لم تكن كتابة فحسب، بل قراءة: كلمات تأتيني في لحظات ما بين الحلم واليقظة، أقرأها في الكُتب والقصائد القديمة، أو في دفاتر مهملة، وأستشعر فيها نداء باطنيا، شعورا بأن هناك لغة أعمق، لغة لا تكفيها الكلمات العادية. هذه اللحظات الأولى علمتني أن الشعر ليس فقط التقاط ما يُرى، بل كشف ما يُخفى كذلك: الأحاسيس، الذكريات، الصمت، الضوء والغياب. ومع مرور الزمن، نشأت علاقة مزدوجة مع الشعر، فهو من جهة ملجئي وملاذي الرحيم، ومن جهة أخرى هو المرآة التي أحدق فيها لأقتنص الدهشة والفرح. هو الملجأ لأنه يعطيني مساحة لأعبر عن ذاتي بأصدق ما يكون، والمرآة لأنه يعيدني إلى نفسي، يُظهِر لي خبايا روحي ويكشف ما يغفو فيها من تساؤلات ولحظات وحالات الفرح والخيبات كذلك. هذه العلاقة صارت «عِقْدا كينونيا» عندما اكتشفتُ بأن الكتابة الشعرية هي طريق غير قابل للتخلي، مهما كلفني ذلك من وقت ومن مكابدات.
في ديواني الأخير «يدي تضيء الأفق بمصباح كفيف»، يبدو هذا العِقد واضحا جدا: إنه المصباح الذي أضيء به الأفق، وهو إما ضوء داخلي، أو بقايا يقظة في عالم غامض، وهو لا يرى الخارج فقط، بل يُرى في داخلي، كأن الطريق الشعري هو نور داخلي يكتشف مدارات الذات والمكان. أما هل من ماضٍ شخصي شدني إلى هذا الكائن (الشعر)؟ فربما كان حبي للبياض: البياض في العنوان، في الصورة، في الفراغ الدلالي. في ديواني «البياض يليق بسوزان»، أرى البياض ليس لونا فقط، بل رمزا لحالة روحية، لحالة انتظار، لحالة فراغ البوح التي تحتاج إلى أن يُطرزها الشعر. هذا البياض جعلني أتساءل: ما الذي يمكن قوله في الفراغ؟ كيف يُمكن للكلمات أن تسكن الصمت؟ كيف أتمثل الضوء في الظلام، أو الغياب في الحضور؟ هذه الأسئلة كانت ولا تزال محفزا لي لأستمر في الكتابة.
كما أن دراساتي في النقد الفني، كانت جزءا من هذا العقد: عندما قرأت التجارب التشكيلية، زاد افتتاني بنقاط التقاء الشعر بالتشكيل. هذا التلاقح بين الصور البصرية والكلمات، جعل الشعر بالنسبة لي ليس مجرد كلام، بل بنية فنية مرئية، جمالية تتوسط اللفظ والصورة، وتعيد تشكيل العالم من الداخل. بالتالي، أعتقد أن بدايتي مع الشعر كانت تكوينا تدريجيا، كانت قراءة، تأملا، بحثا، كتابة، ثم نقدا ووعيا. ليس حادثة مفاجئة، بل مسارا من الرغبة والبحث والاستكشاف. إن ارتباطي وتورطي مع الشعر هو عِقد وجود: أنا في الشعر، والشعر في داخلي، وفي هذا الترابط الغامض أجد كينونتي.
■ صار من الدارج أن جيل الثمانينيات الذي تمثل أحد شعرائه، حقق طفرة أساسية في سياق تحديث الشعر المغربي. في نظرك، ما هي أهم المكاسب والآثار التي تنسب له؟ وماذا تذكر من علامات تلك الحقبة؟
□ جيل الثمانينيات، كما أراه اليوم، لم يكن مجرد مرحلة في مُدونة الشعر المغربي، بل كان أشبه ببابٍ يُفتح على ضوء جديد. كُنا نكتب وكأن اللغة تتعلم معنا كيف تُعيد ترتيب العالَم، وكيف تلتقط هشاشته في لحظاتٍ صغيرة، لا تكاد تُرى. لم نبحث عن الطفرة، لكنها جاءت من تلقاء نفسها، كأن القصيدة كانت تنتظر هذا الجيل كي تنفض عنها غبار الخطابة، وتدخل زمنا آخر تُكتب فيه التجربة بعمقها الإنساني لا بشعاراتها. وأهم ما تركه ذلك الجيل هو هذا التحول العميق في الحساسية الشعرية: الانتقال من القصيدة التي تُعلن، إلى القصيدة التي تُكتب. تحول الشعر مع هذا الجيل من القصيدة بمعناها التقليدي إلى الكتابة بمعناها المتشظي و»حداثة السؤال»، من البنية السماعية والإنشادية إلى بنية البصر والعين، من المنبرية إلى النصوص الشعرية، التي تُقرا بفروض الفكر والبصر، من الصوت العالي إلى الهمس، من البلاغة الجاهزة إلى لغة تصنع بلاغتها وهي تتشكل فوق الصفحة. كانت الذات في تلك الفترة أكثر حضورا، لكنها ليست ذاتا مغلقة أو مكتفية، بل ذاتٌ تبحث عن وجودها عبر علاقتها بالأشياء، بالغياب، بالضوء الذي يتسلل من شقوق التجربة. ومع كل ديوان كتبتُه، كنت أشعر بأنني أواصل ذلك النفس الجيلي الذي بدأته يومها. في ديواني «البياض يليق بسوزان»، كنت أبحث عن هذا البياض الذي يسكن خلف اللغة، عن المسافة التي تتكون فيها القصيدة قبل أن تُكتب. كنت أستعيد الأمكنة والروائح والأزمنة التي مررتُ بها، المدن التي لم نعش فيها إلا لحظات عابرة، لكنها حفرت فينا أثرا لا يزول. هكذا كنتُ أواصل ذلك الحفر في الذاكرة الداخلية للقصيدة، وفي علاقتها بما يتساقط منا وما ينهض فينا كذلك.
إن علامات تلك المرحلة لا تُختصر في أسماء ولا ظواهر، بل في الروح التي سكنت الكتابة: روح تُغامر باللغة، تبحث عن شكل آخر للنص الشعري وتنقله من المعنى إلى الدلالة، لترى في التفاصيل الصغيرة حياة كاملة. كانت المجلات الأدبية والصفحات الأدبية والملاحق الثقافية للصحف المغربية والعربية، آنذاك، بمثابة مختبر مفتوح، نتبادل فيه القصائد والرؤى، ونتعلم من اختلاف الأصوات، أن الشعر لا يُبنى على اتفاق، بل على المغامرة، وعلى الرغبة في فتح بابٍ لم يُفتح من قبل. لم يكتب جيل الثمانينيات قصيدة جديدة فقط، بل كتب وعيا جديدا بالشعر. وها أنا، كلما عدتُ إلى الكتابة، أشعر بأنني أعود إلى تلك الشرارة الأولى، إلى تلك الرغبة التي جعلت القصيدة، يوما، قدرا ودربا علينا أن نواصل السير معه حتى النهاية.
■ صدرت ديوانك الأول «بياضات شيقة» حتى عام 2001؟ لماذا تأخرت عن النشر، بخلاف أبناء جيلك؟ وكيف تستعيد تلك اللحظة وحماسة الشاب الذي يولد من جديد؟
ـ حين أعود بالذاكرة إلى ديواني الأول «بياضات شيقة» (جائزة الشارقة للإبداع العربي في الشعر ـ الدورة الرابعة 2001)، أرى أن تأخر صدوره لم يكن نسيانا ولا ترددا، بل كان تأملا طويلا في اللغة، وفي نفسي، قبل أن أُقدم للعالم ما يختبئ بين يدي. كنتُ أكتب، أصقل اللغة وأمارس من خلالها التجريب والتحليق في سماء الشعر، وأعيد النظر، كأن كل كلمة، كي تولد، لا بد أن تأخذ حقها الكامل في الدلالة والصورة الشعرية التي تشبهني بشكل أساس، وكأن البياض نفسه يحتاج إلى وقت ليكتمل في الوعي قبل أن يتحول إلى قصيدة. وحين كان أبناء جيلي في سباق إلى النشر، كنتُ أعيش القصيدة كرحلة داخلية، أكثر من كونها مشروعا خارجيا للظهور. لكن حين جاء عام 2001، ومع صدور الديوان، شعرتُ بأن الولادة الحقيقية لم تكن في اليوم الذي كتبت فيه الكلمات، بل في اليوم الذي انفتحت فيه الصفحات على القراء. كان الحماسُ الذي يعيشه الشاب في أول قصيدة له حاضرا كما لو أن الزمن لم يمر: فرحة الاكتشاف، وهلع المسؤولية، وشغف الحلم بأن تظل الكلمات صافية، ناصعة، قادرة على الاحتفاظ بقدرتها على المفاجأة.
في «بياضات شيقة»، كان البياض هو البداية والمرايا والفراغ، الذي يطل على كل شيء بعده: على المدن، على الذاكرة، على الصمت. كان ديواني الأول إعلانا خافتا، ولكنه واثق من نفسه وتجربته: يؤمن بأن الشعر ليس مجرد كتابة، بل مساحة لتكوين الذات، ولإعادة اكتشاف العالم، وللسير مع اللغة حتى نهاية الطريق. وكلما أستعيد تلك اللحظة، أشعر بأن الصوت الذي كتب آنذاك لا يزال يسير معي، حريصا على أن يبقى البياض حيا، وأن تظل الشرارة الأولى للكتابة متقدة في القلب والصفحة معا.
■ في سياق انشغالك الأكاديمي بالفن التشكيلي، اهتممت في شعرك كما في دراساتك بالبعد البصري للقصيدة. ما هي الآثار الفنية والجمالية التي يتركها هذا البعد على شعرنا المعاصر؟ وهل بوسعه إنتاج معرفة جديدة بالشعر وتشييد رؤيته الخاصة للذات والأشياء والعالم في عصر يضج بحضارة الصورة؟
□ إن اهتمامي بالبعد البصري في الشعر ليس مجرد انبهار بصور لوحات أو ألوان، بل هو مسعى لفهم كيف يمكن للقصيدة أن تُرى قبل أن تُسمع أو تُقرأ، وكيف للغة أن تتحول إلى تجربة حسية ممتدة تتعدى الحروف والكلمات. في دواويني الشعرية، من: (البياض يليق بسوزان)، إلى (أصدقاء يغادرون حنجرتي)، إلى (هوامش لذاكرة العين)، إلى (مَقــامات وقصائد أندلسية) (ديوان شعري بالعربية والإسبانية)، إلى ديواني الأخير (يدي تضيء الأفق بمصباح كفيف)، حاولت أن أصنع فضاءات لا تُختصر في المعنى وحده، بل تُفتح أمام العين والذاكرة والروح على دلالات وعوالم متعددة، كي تُشعر القارئ بأن الصفحة ليست سطحا، بل عالما ينبض بالضوء والظل والحركة والسكون. أما بخصوص الآثار الجمالية لذلك البُعد في الشعر المعاصر فهي واضحة فيما أعتقد: لم يعُد الشعر مجرد كلام يُقال، بل صار تجربة شاملة للحواس، تجربة تُحفز الذهن كما تُثير المشاعر، تجربة ترى العالم كلوحة متحركة، كفضاء تتسرب فيه الصور إلى الكلمات وتنسج معنى مزدوجا بين البصر والسمع والوجدان. وذلك يسمح للشعر بأن يُعيد إنتاج المعرفة: ليس معرفة تاريخية أو فلسفية فقط، بل معرفة ذاتية وجمالية، معرفة بالذات والعالم والعلاقات بينهما، معرفة ترتكز على الملاحظة الدقيقة والتأمل العميق والتخييل الحي.
وفي عصر تضج فيه الصورة من كل جانب، يصبح هذا البعد البصري أكثر حيوية. فالقصيدة قادرة على أن تُنتج رؤية جديدة للعالم، رؤية تتجاوز السطح، وتفتح للمشاهد فضاء داخليا يمزج بين ما يُرى وما يُشعر به وما يُفكر فيه. إنها لغة تجعل الشعر معرفة قائمة على التجربة البصرية والوجدانية، لا على النقل أو التقليد، لغة تشيد رؤية مميزة للذات والأشياء، وتجعل القارئ شريكا في البناء الشعوري والجمالي للقصيدة، تماما كما تفعل اللوحة أو الصورة المتحركة، لكن ضمن خصوصية اللغة الشعرية التي تظل تحافظ على صوتها الخاص، على وهجها الداخلي، وعلى قدرة الكلمات على أن تضيء الظلال قبل أن تضيء المعنى بشكل أساس.
■ ما هي طقوسك الخاصة أثناء الكتابة؟ وهل تعود إلى تنقيح ما تكتبه؟
□ ليست لي طقوسٌ ثابتة بالمعنى المتعارف عليه، فالكتابة عندي لا تأتي بإشارة، ولا تستجيب لزمن معين، بل تنبثق حين تتوافر لحظتها الداخلية، حين يتقد في الجسد والروح شيء يشبه الارتعاشة الأولى للقصيدة. أحتاج فقط إلى مساحة من الصمت، صمت يسمح لي بأن أصغي جيدا لذلك الصوت الخافت الذي يبدأ عادة بكلمة، بصورة، بشعور يمر مثل ظلٍ خفيف ثم لا يريد أن يغادر. هناك لحظات لا يكون فيها العالَم مرئيا إلا بالكلمات، عندها أعرف أن القصيدة بدأت تناديني وتبحث عني. أحيانا أكتب ليلا، لأن الليل أكثر اتساعا من النهار، وأكثر قدرة على احتضان الصوت الداخلي دون تشويش. وأحيانا أكتب في الصباح، حين يكون الضوء في بدايته، هشا، ناعما، كأنه يطلب منا أن نعيد كتابته في القصيدة. لكنني لا أجلس لأقرر: الآن سأكتب. الكتابة عندي فعل مفاجأة، كاشفة، تأتي وهي تعرف موعدها، حتى لو لم أكن أعرف هذا الموعد بالضبط. أما التنقيح، فهو جزء من العملية الإبداعية لا يمكنني الاستغناء عنه. لا أعود إلى النص لأصححه، بل لأُنصت إليه من جديد. أحيانا يهمس لي أن شيئا ما لم يكتمل، أو أن جملة تحتاج إلى هواء أكثر، أو أن صورة ما كانت تبحث عن ضوء لم يمنح لها في اللحظة الأولى. وفي مرات أخرى، لا ألمس النص إطلاقا، لأن القصيدة تولد مكتملة مثل ومضة لا يمكن تعديلها دون أن تفقد بريقها الأصلي. الكتابة، في النهاية، ليست قرارا ولا عادة، بل حالة: حالة إنصات لما يجري في الداخل، لما يتشكل في العتمة والبياض، لما ينضج في الروح قبل أن يظهر على الصفحة. وكلما شاركتني القصيدة لحظتها الحاسمة، أحاول فقط أن أكون جديرا بثقتها، وأن أفسح لها الطريق كي تُتم نفسها كما تريد، لا كما أريد أنا بشكل أساس.
■ بإيجاز، لماذا تكتب؟ ولمن تكتب؟
□ أكتب لأن الكتابة هي المكان الذي أجد فيه نفسي، المكان الذي أستطيع فيه أن أرى العالم كما هو، لا كما يُفرض عليّ أن أراه. الكتابة بالنسبة لي ليست مجرد ترتيب للكلمات، بل حوار مع الوجود، محاولة لفهم ما لا يُفهم، لمسك شيء من الضوء في وسط الظلام، أو شيء من الصمت في وسط الضجيج. كل كلمة أكتبها هي صدى لما يمر في داخلي، انعكاس لشعور ما، لفكرة، لوميض يطرق أبواب الروح. أكتب لنفسي أولا، لأظل صادقا مع ذاتي بالأساس، لأحتفظ بمسافة بيني وبين العالم تمكنني من مراقبته، من إعادة اكتشافه، من فهمه في تفاصيله الصغيرة، كما فعلت في ديواني (البياض يليق بسوزان)، حين تحول البياض إلى فضاء للذاكرة والخيال. لكنني أكتب أيضا للقارئ المفترَض، لمن يستطيع أن يلتقط شيئا من هذا الصمت، أن يراه كما أراه، أن يعيش معه تجربة اللغة كما تعيش التجربة الأولى للضوء بعد الظلام. أكتب إذن لأن اللغة هي البيت الذي يجمعني بالآخر، ولأن الشعر وحده يستطيع أن يجعل الصمت والبياض يَسمعان، والغياب حاضرا، والفراغ مشبعا بالحياة. أكتب لمن يود أن يجد في الكلمات مرآة لحظة وجوده، لمن يريد أن يرى العالم من زاوية لم تُرَ من قبل، ولمن يؤمن أن كل قصيدة تحمل في طياتها ضوءا صغيرا يمكن أن يضيء شيئا في عينه ودواخله، مهما كانت اللحظات هاربة ومنفلتة من الزمن.