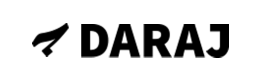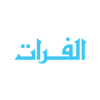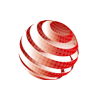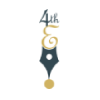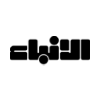اخبار سوريا
موقع كل يوم -درج
نشر بتاريخ: ١٩ أيار ٢٠٢٥
شكّل لقاء ترامب والشرع لحظة مفصلية لا تخص سوريا وحدها، بل تعكس انقلاباً أوسع في النظرة الأميركية إلى العالم: من تبني المشاريع القيمية إلى التماهي مع منطق القوة والوقائع.
لو سئل عشرة محللين سياسيين قبل عشرة أيام إن كانوا يرون أن لقاء يجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع ممكن، لأجاب تسعة منهم على الأقل بأن ذلك مستحيل أو بعيد المنال.
ومع ذلك، في الثالث عشر من أيار/ مايو، فاجأ ترامب المحللين ومعهم العالم بلقائه مع الشرع في العاصمة السعودية الرياض، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شخصياً، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان افتراضياً. وتلا اللقاء إعلانه قرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا. وكان سبق ذلك اللقاء، وربما مهد له، لقاء جمع الشرع بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.
جاء هذا التطور في لحظة حرجة من تاريخ سوريا والمنطقة، بعد أكثر من عقد من العزلة والعقوبات والانقسامات والصراعات الإقليمية والدولية على الساحة السورية. لم يكن اللقاء مجرد حدث بروتوكولي عابر، بل تجلياً لتحوّل استراتيجي كبير في السياسة الأميركية تجاه الملف السوري، قد تكون له تداعيات بعيدة المدى. وهو بالتأكيد لم يأت من فراغ، بل كان – على الأرجح – نتيجة أسابيع من الحراك الدبلوماسي المكثف، أعادت خلاله قوى إقليمية أساسية، في مقدمها الرياض وأنقرة، وضع الملف السوري على طاولة البحث كأولوية سياسية مشتركة. في هذا السياق، يمكن القول إن قرار رفع العقوبات لم يكن أميركيا صرفاً، بل ثمرة توافق إقليمي – دولي على إعادة دمج سوريا في النظام الإقليمي ضمن معادلات جديدة تراعي المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة.
لا بد أن للرئيس ترامب حساباته الخاصة، فهو آخر من يهتم فعلاً لحال السوريين، وقد لعب – كعادته – لعبة ماكرة جعلت منه حديث العالم مجدداً. أما بالنسبة الى السوريين، فقد كان رفع العقوبات مطلباً محقاً، ولذلك انفجر الشارع السوري بفرحة عارمة فور سماعهم بالخبر، فهم يدركون أن من دون رفع العقوبات لن تكون هناك مساعدات ولا كهرباء ولا إعمار ولا وظائف.
أما الأميركيون، فهم منقسمون بين ثلاث فئات: فأنصار ترامب يسيرون معه بعيون مغمضة، لا يناقشون أياً من أفعاله؛ في حين ينقسم الآخرون بين من يتعامل مع رفع العقوبات بتسامح، آملا بأن يخفف ذلك من معاناة السوريين، وبين من يرى أن ترامب قد صافح فعلياً 'إرهابياً' على يديه آثار دماء جنود أميركيين سقطوا في العراق.
ولسنا نعرف، على وجه اليقين، ما إذا كان الشرع قد قتل فعلاً جنوداً أميركيين، ولكننا نعلم أنه قاتل في صفوف 'قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين' بقيادة أبي بكر البغدادي، الذي أصبح لاحقاً 'خليفة' الدولة الإسلامية. وبينما يحتاج الجزم بمشاركته في تلك العمليات إلى تحقيقات مطوّلة وأحكام قضائية، فإن افتراض ذلك لا يبدو مبالغاً فيه.
في مقال افتتاحي نشرته 'وول ستريت جورنال' غداة لقاء الرجلين في الرياض، لم تُخفِ الصحيفة – على رغم إقرارها بضرورة الواقعية السياسية – قلقها من انقلاب الخطاب الترامبي وتخلي واشنطن عن مشاريع 'بناء الدولة' والديمقراطية الليبرالية. كما حذرت أصوات داخل الكونغرس والإعلام من أن 'الرهان على جهادي سابق' قد تكون له نتائج عكسية، ما لم يقترن بتغيير جوهري في سلوك السلطة الجديدة.
ونحن نعلم أن الشرع قد واجه تهديداً بالاعتقال في حال حضوره القمة العربية المرتقبة في بغداد، على رغم دعوة رسمية تلقاها من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وهو ما اضطره للاعتذار عن عدم المشاركة.
تحوّل نوعي في المقاربة الأميركية
ما حصل لم يكن مجرد تعديل عابر في مقاربة واشنطن للملف السوري، بل تحولا جذريا في العقيدة التي حكمت سياساتها في الشرق الأوسط منذ عام 2011. فبعد سنوات من تبني نهج العزلة والعقوبات القصوى، جاءت مقاربة ترامب لتقلب المعادلة، مستبدلة خطاب بناء الدولة ونشر الديمقراطية بسياسة واقعية لا تقيس المواقف بالقيم بل بالنتائج.
ولم تكمن المفاجأة في رفع العقوبات فحسب، بل في هوية الطرف الذي استُقبل بهذا الانفتاح: رجل سبق أن صنّفته الولايات المتحدة كقيادي في جماعة جهادية، ورصدت مكافأة بملايين الدولارات للقبض عليه، ولا تزال حركته مدرجة على قوائم الإرهاب. واليوم، تصفه الإدارة الأميركية بأنه قائد قوي يملك فرصة حقيقية لإعادة الاستقرار إلى سوريا. هذا التحول الحاد في الخطاب والتوصيف يكاد يعلن نهاية فعلية لمرحلة 'الحرب على الإرهاب' كنموذج ناظم للسياسة الأميركية، وبداية زمن جديد تُقدّم فيه البراغماتية على ما سواها.
شكّل لقاء ترامب والشرع لحظة مفصلية لا تخص سوريا وحدها، بل تعكس انقلاباً أوسع في النظرة الأميركية إلى العالم: من تبني المشاريع القيمية إلى التماهي مع منطق القوة والوقائع.
لم تعد واشنطن تسعى إلى تشكيل أنظمة على صورتها، بل باتت تقبل التفاهم مع أي سلطة قائمة، ما دامت قادرة على ضبط الأرض وتحقيق التوازنات التي تخدم مصالحها. لقد غادرت دورها كمشرّع ومعيار، لتغدو شريكاً في إدارة الأمر الواقع، أياً كانت هويته.
ولا ينبغي أن يُفهم لقاء الرياض على أنه نتاج مبادرة أميركية منفردة، بل هو ثمرة ترتيب دبلوماسي واسع شاركت فيه أطراف إقليمية ودولية وازنة، في مقدمها السعودية وتركيا وفرنسا. فقرار رفع العقوبات عن سوريا لم يصدر من فراغ، بل جاء تتويجاً لأسابيع من الحراك المنسّق، هدفه إعادة دمج سوريا في النظام الإقليمي ضمن معادلة جديدة تراعي مصالح الشركاء وتضمن استقرار المنطقة. بهذا المعنى، لم يكن ما حصل في الرياض مجرد لقاء ثنائي، بل محطة فاصلة في صفقة دبلوماسية جماعية أعادت رسم شروط الانخراط الدولي في الملف السوري، وفتحت الباب أمام إعادة تأهيل النظام الجديد وفق ضوابط إقليمية دقيقة.
ارتباك حكومي وتضخيم شعبي
على رغم أهمية الحدث، بدا في الأيام الأولى أن الحكومة السورية الانتقالية غائبة عن إدارة الخطاب السياسي والإعلامي المصاحب لقرار رفع العقوبات، فلم تُصدر أي بيانات فورية توضّح طبيعة القرار أو ترسم ملامح خريطة طريق لكيفية الاستفادة منه. وبدلاً من ذلك، تُرك المجال مفتوحاً لخطاب شعبي احتفالي، بلغ في بعض جوانبه حدّ الشماتة والاستعراض، ليملأ الفراغ ويعيد إلى الأذهان أنماطاً سلطوية سابقة كرّست منطق الغلبة على حساب منطق الشراكة.
وعلى رغم ظهور الرئيس أحمد الشرع بعد أيام من إعلان قرار رفع العقوبات وإلقائه خطاباً مطولاً وجّه فيه رسائل شكر وتقدير لشعوب وقادة دول عربية وغربية دعمت سوريا الجديدة، بدا الخطاب أقرب إلى مهرجان شعاراتي منه إلى بيان سياسي رصين يُفترض به أن يحدّد ملامح المرحلة المقبلة. فقد غلبت عليه العبارات العاطفية والإنشائية، وتكرّرت فيه صيغ المديح والمبالغات، من دون أن يتضمن تصوراً واضحاً لخطة العمل المقبلة أو برنامجاً عملياً لمعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية والمؤسساتية الجسيمة التي تواجه البلاد. اكتفى الشرع بعرض علاقاته مع قادة دول الجوار، والاحتفاء برفع العقوبات، من دون أن يتطرّق إلى سبل ترجمة هذا التحوّل إلى سياسات ملموسة داخلية، أو إلى تقديم رؤية متماسكة لبناء دولة جامعة تتجاوز منطق الفصائل، وتؤسس لعقد اجتماعي جديد.
وبذلك، لم يساهم الخطاب في تبديد القلق الداخلي والدولي، بل ربما عمّق الشعور بأن السلطة الجديدة ما زالت تفتقر إلى خطاب دولة، وتكتفي بخطاب وجداني إنشائي لا يقدّم إجابات عن الأسئلة الكبرى.
كان الشرع، في خطابه ذاك، أقرب ما يكون إلى صورة الرئيس الهارب، وأشبه ما يكون بزعيم حزبي قديم، يستخدم اللغة نفسها والشعارات نفسها. فقد خاطب 'الشعب السوري العظيم'، واستعاد صور المرحلة 'المأساوية تحت حكم النظام الساقط'، حيث 'قُتل الشعب، وهُجر الناس، وغُيّب الآلاف في سجون الظلام، وهُدمت مقدّرات الدولة، ونهبت بأيدي القتلة والسراق، وتحوّلت سوريا إلى بلد طارد لأبنائها وجيرانها'. ثم تحسّر على 'سوريا الحضارة' التي باتت 'غريبة عن تاريخها، وبعيدة عن أصالتها'، بينما 'هناك في إدلب العز… كان يُبنى مستقبل سوريا الجديدة'، وقد 'تحررت البلاد، وفرح العباد، وفرح معهم أشقاؤنا، بل والعالم بأسره، وعادت روح الانتماء لشعبنا، وظهر جلياً حرصه على دولته الجديدة'.
ومثل خطابات سابقة، غابت عن حديثه مفاهيم المواطنة والديمقراطية وتداول السلطة وحقوق الإنسان، في مقابل تكرار لافت وذي مغزى لكلمات من قبيل 'الجوار' و'الجوار،' وكأنه يُسدّد ديناً أو يُوفي نذراً سياسياً. أما المديح، فقد توزّع على قادة المنطقة والرئيس الفرنسي ماكرون، واختُتم بالإشادة الخاصة بترامب، الذي 'استجاب مشكوراً لهذا الحب، فكان قراره التاريخي الشجاع برفع العقوبات، باعثاً على نهضة الشعب، وأساساً لاستقرار المنطقة'.
صحيح أن رفع العقوبات عن سوريا مناسبة تستدعي الفرح، لكن الشجاعة السياسية كانت تقتضي من رئيس البلاد في خطابه أن يدعو إلى الوحدة لا أن يتعامل معها كأمر مفروغ منه، وأن يتعهد بفعل ما يلزم لتحقيقها، بما في ذلك محاسبة الجهات التي تفرّط بها وتهدّد مستقبل البلاد ككيان موحد ومستقل. فقد بدا الخطاب الذي تحدث فيه الشرع بعد رفع العقوبات، أقرب إلى نموذج بشار الأسد أو صفوان قدسي، لا إلى خطاب رجل يُفترض به أن يقود بلداً نحو تحوّل تاريخي. وبدلاً من تقديم صورة عن دولة تتجه نحو التعددية والمساءلة، صُوِّر القرار وكأنه 'نصر' سياسي لطرف على حساب باقي الأطراف. هذا التوظيف الشعبوي للقرار يهدّد بتقويض الفرصة المتاحة، ويثير قلق الداخل والخارج من نوايا السلطة الجديدة.