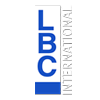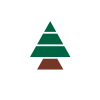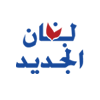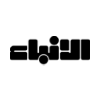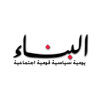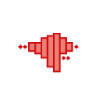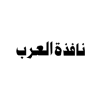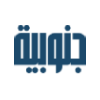اخبار لبنان
موقع كل يوم -جريدة اللواء
نشر بتاريخ: ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥
أحمد فرحات*
في السادس من حزيران/ يونيو من العام 1982، أَمسك الشاعرُ اللّبنانيُّ خليل حاوي ببندقيّةِ صيدٍ كان يَحتفظ بها تحت سريره، ثمَّ أدارَها في اتّجاه رأسه مُطلِقاً النار على الدّماغ.. فنالَ منه بعدما اخترقَ الطَّلقُ العيْنَ اليسرى.. ليَنامَ بعد ذلك فَوق دَمِهِ إلى الأبد.
ما أَقدم عليه شاعرُنا الكبير في مثل هذا الوقت منذ 43 عاماً، أي في زمن الغزو الإسرائيليّ للبنان، واحتلاله بيروت أوّل عاصمة عربيّة، كان أشْبه بتوكيدِ انتصار الذّات على مَوتِ المكان وترهُّلِ الزمان.
كان صاحب ملحمة «ليعازر» قَبلها يؤسِّس لانتحارِه العنيد العتيد، حيث لم يُرِد لنصِّه الشعريّ البتّة أن يفلتَ من جاذبيّة الدلالات الحيّة، فكَتَبَ بنفسهِ قصيدةَ النهاية التي تَستجيب لضروراتِ البداية.
لكأنّ خليل حاوي صبَّ «فِعْلَتَهُ المَوتيّة» في خدمة التّملْملِ نحو الجديد الذي لا بدّ هو آتٍ، كياناً وحضارة. لقد أَوقف الشاعرُ توتُّرَه عامداً، وانساقَ لهديرٍ روحيّ هو بمثابة دفْعٍ كيانيّ احتجاجيّ على استمرارِ المُشارَكةِ في مهرجان الهزائم العربيّة المفتوح.
خليل حاوي طاقةٌ كان لا بدّ في النهاية من أن تَستثمِرَ قلقَها بالموتِ الإراديّ.. الفرديّ والاجتماعيّ في آنٍ معاً.. إذ إنّ التزاميَّتَهُ كشاعر، لم تكُن سياسيّة واجتماعيّة فحسب، وإنّما كانت أيضاً التزاميّةً وجوديّةً وماورائيّةً اشتَهت اكتساحَ رؤيتها الغامضة بعيداً من نصّ الصيرورة البليد.
هذا الشاعر المُتصالِب، المُنشطِر، العصابيّ، قامَ بمُصالَحةٍ قَبل الأوان لحريّته مع الأقدار. ولأنّه كان يَنفعل أوّلاً ثمّ يُفكِّر، ولأنّ ذاتيَّتَهُ كانت مُمتزجةً بنَوعٍ من الكبرياء الخصوصيّ، ولأنّه ظلَّ على الرّغم من تحوّلاتِه الثقافيّة المطّردة شخصيّةً بريّة فطريّة تُطالِبُ لنفسِها بلمِّ الانفلاتِ كلّه.. ولأنّه أيضاً كان مُحافظاً في التوكيد على جوهر الإبداعيّ الصلب فيه.. ولأنّه كان لا يَطمئنّ في ظلّ الصراع إلّا لانطوائيّتِه.. ولأنّ فوّهة اللّغة لديه ضاقت في النهاية حتّى ملَّت تكرار الندْبِ والصراخ، أَلهب خليل حاوي رأسَهُ بطلقةٍ واحدة شكَّلت في ما بَعد جِسراً وطيداً، لعلّه يُبرِق نحو شرقٍ جديد ولو بَعد ألفِ عام.
توسَّل خليل حاوي في شعرِه قضيّةَ التجسيد، أي تلك الحال التي تَنقل المُعاناة من النفسانيّ إلى الحسيّ دفعةً واحدة. ولذا كانت لغته إرغاميّة «قوانينيّة»، «فكريّة»، إيقاعيّة وموثَّقة بالثبات المَلحميّ المُتّجه دوماً للقبضِ على الكليّات.
ولأجل ذلك رأيناه يتنكّب الأسطورة، باعتبارها لغة المُفارقات التي تَنهض بالكائن إلى البطولة المُنتصِرة على الخوارق، وكذلك على الهزائم الكبرى والإحباطات المُستعصيَة.. وكانت أسطورة تمّوز هنا دليله الأقوى والأنْفذ في اتّجاه الانبعاث الحضاري وغلبة منطق الحياة، فإنساننا كما قال لي يوماً «ليس بضعيف، وإنّما يَجهل أحياناً مَواطِنَ قوّته وشعلاتِه النورانيّة الأشْرس من رشْدِ الأقدار».
صحيح أنّ الشاعر الكبير بدر شاكر السيّاب كان قد استخدَم أسطورة تمّوز من قَبل، واشتهرَ بها، ما فَتَحَ لشُعراء الحداثة الآخرين استخدامها في قصائدهم، حتّى تولَّد لدينا لاحقاً ما سُمّيَ بـ «الشعراء التمّوزيّين»، لكنّ الشاعر خليل حاوي تمرَّس أكثر من الجميع بتوكيدِ «القصيدة التمّوزيّة» وفرْضِها فرْضاً ذاتيّاً مَلحميّاً، حتّى صارت وكأنّها «علامة» مسجّلة باسمه، وذلك منذ ديوانه الأوّل «نهر الرماد» الصادر في العام 1957.
ثمّ إنّ شاعرنا ظلّ يَغرق في الرموز أكثر فأكثر، ودوماً انطلاقاً من دمْجِ همومه الذاتيّة بهموم أمّته المصيريّة؛ ولعلّه كان الشاعر العربيّ الحديث الوحيد الأكثر لجوءاً في شعره للاحتشاد بالرموز وتفتيقِها.. ورموزه في الإجمال عربيّة تراثيّة، منها على سبيل المثال لا الحصر: رمز السندباد، ورمز البصّارة، ورمز البدويّة السمراء، ورمز جنيّة الشاطئ، ورمز النّاسك.. علاوةً على رمز الناي، ورمز الريح.. ثمّ رمز النار الذي يَأخذ حيّزاً ساحقاً جارفاً، بخاصّة في قصيدتَيْه «سدوم» و»عودة إلى سدوم» في ديوانه «نهر الرماد».
وهكذا فالرموز لديه هي وليدة الرؤيا التي تَستكنه الأعماق في النَّفس والوجود، وتُجسِّدُها بصورٍ حسيّة محدَّدة، وإنْ كانت توحي باستمرار بأمْداءٍ لا حدودَ لها.
الإقامةُ في المستقبل.. وتجاوُزُهُ
آمَنَ خليل حاوي أنّ الشاعر الكبير هو مفكّر كبير أيضاً. لذا امتزجَ فيه كشاعرٍ هذا الموقفُ الفلسفيّ التساؤليّ عن معنى الإنسان والكينونة. وكان يَرفض الاستنقاع في الخَيْبةِ والمرارة؛ ودعوته كانت دائمة للإقامة في المستقبل.. وتجاوزه.
هل كان انتحار خليل حاوي مثابة احتجاجٍ على تفاقُمِ الهزيمة العربيّة ووصولها حدّ الذلّ والعار متجسّداً باحتلال إسرائيل لبنان ووصولها إلى قلْب العاصمة بيروت؟
أَسأل هذا السؤال لأنّ البعض، صراحةً، لا يزال يُشكِّك، وحتّى اللّحظة، في الدّاعي الأساسي لإقدام الشاعر خليل حاوي على الانتحار، وخصوصاً لهذا السبب.. كبؤرة مركزيّة طبعاً، آخذين بالاعتبار أسباباً شخصيّة أخرى مُقلِقة جدّاً له، تتعلّق مثلاً بفشلِه العاطفي مع المرأة التي أَحبّته وأحبَّها حتّى الجنون، ثمّ فجأة تخلّت عنه.. (لا أذيع سرّاً إذا قلت هنا إنّها الأديبة العراقيّة ديزي الأمير).. علاوةً على إحساسه الحادّ بالعزلة وطعْمها العلقم المرّ، وفقدانه الثقة بكلّ شيء من حواليه... ولطالما كان يُردِّد أمامي: «أنا جئتُ من حيث لا أدري، وسأمضي أيضاً إلى حيث لا أدري».
وجوابي عن السؤال: نعم انتحرَ خليل حاوي، وكان انتحارُهُ احتجاجاً فِعلاً على «الغزو الإسرائيليّ السهل» للبنان وقتها. نعم لم يَتحمّل هذا الشاعر المُتبرِّم بكلّ شيء، حتّى بنفسه.. لم يتحمّل مَشهدَ العار والذلّ... لم يتحمّل حتّى الصمت العربيّ عن وضْعِ حلولٍ لمشكلة حرب لبنان الأهليّة، والتي كان قد مرَّ عليها حتّى ذلك الوقت سبعةُ أعوام.
وقَبل انتحاره بشهورٍ ثلاثة أو أكثر بقليل، كنتُ التقيتُ به شخصيّاً في أحد شوارع منطقة رأس بيروت؛ وتمشّينا حوالى الساعة تقريباً، قال لي من ضمن ما قاله وقتها وبلهجته القرويّة الشويريّة (هو ابن بلدة الشوير في جبل لبنان): «شو هيدا يا أحمد؟!.. شو هالحالة المرتّة التعبانة اللّي عَم نتخبّط فيها.. مين بدّو يشيل حمل هالعار الكبير عنّا.. وين العرب؟.. ليش ساكتين ما بيتدخّلوا لفضّ هالمهزلة اللّبنانيّة المُستمرّة؟... شوف.. شوف هولي المجانين بلبنان، كيف عَم يتقاتلوا ويدمّروا بعضهم البعض.. ولحساب مين؟.. لحساب إسرائيل، والأضرب من هيدا كلّه إنّو مِش دريانين بالمسألة من أوّلها لآخرها».
كانت تربطني بالشاعر خليل حاوي علاقةٌ متينة جميلة، لكنّها في الوقت نفسه متقلّبة.. من جهة مزاجه هو رحمَه لله. فأنا أحد تلاميذه في الجامعة اللّبنانيّة، ثمّ انخرطتُ في سِلك الصحافة الثقافيّة في ما بَعد، حيث توطّدت العلاقة به أكثر، وخصوصاً أنّها اتَّخذت هذه المرّة منحىً أكثر من مجرّد علاقة تلميذ بأستاذه... وكنت أتردَّد على مَكتبه في الجامعة الأميركيّة في بيروت (مركز عمله التدريسيّ المركزيّ في ما بَعد). ومرّة احتدمَ النقاشُ بيني وبينه حول شِعر أدونيس وأنسي الحاج، إذ كان يَعتبر شِعرَهما مثابة تخريبٍ للشعر العربيّ وللذائقة الشعريّة العربيّة. وكنتُ، ولم أزَل، على الضدّ من رأيه هذا تماماً.. قلتُ له ونحن في حمّى المناقشة وقتها: أتركْ شِعرَهما يا رجل، وتدبَّر أمرَ شعركَ أنت.. حَرِّر قصائدكَ من هذا التراكُم الإيقاعي الذي لكثرتِه، صراحةً، باتَ يُسيء إليها ويُسقطها في رتابةٍ آليّة لذاتها... وما سوى لحظات حتّى كانت صاعقةٌ منه نزلتْ عليّ.. غَضِبَ غَضباً شديداً ورَمَقني بنظراتٍ حمراء زرقاء شزراء، ثمّ قامَ بعدها ورماني بمحبرةٍ كانت أمامه على الطاولة، فأصابتْ منّي الكَتف.. والأنكى أنَّ سُدّتها الصغيرة انفتحتْ، فسالَ الحبرُ على قميصي وشيء من وجهي. ولمّا قمتُ بعدها أتدبّر أمري للمُغادرة كيفما اتّفق، فإذا به يَقف على باب غرفة مكتبه بعدما أغلقه بإحكام قائلاً: «لن تُغادر هذا المكان.. أنا أعتذر عمّا بَدَرَ منّي.. أرجوك لا تغادر هذا المكان.. سنَتدبّر أمرَ القميص.. لا مشكلة».. غير أنّني أَجبرتُ هنا نفسي على القبول بالبقاء بعض الشيء، وذلك كرمى للمعانِ عينَيْه بدموعٍ حرّى، صافية أكّدت لي شعريّتَه العميقة، بل والأكثر عُمقاً وصدقاً من العُمق نفسه.. وولَّيت بعدها الأدبار من دون أن أحرجه، ولا أُحرج نفسي أيضاً من رقّة وطهارة ما أبداه تجاهي.. لكن وما سوى أسابيع فقط حتّى التقينا مجدّداً، وفي مكتبه بالتحديد وكأنّ شيئاً لم يكُن. ولا يفوتني هنا ذكر أنّني إنّما تجرّأتُ على نقْدِ قصائده أمامه لِعِلْمه هو سلفاً بأنّني أُقدّره حقّ قدره، ليس كشاعرٍ عربي كبير فقط، وإنّما كناقدٍ عربيٍّ كبيرٍ أيضاً.. ولطالما ردّدتُ أمامه، وكتبتُ أيضاً، بأنّ حضورَه في المشهد الشعريّ العربيّ الحديث يكاد يُوازي حضورَ الشعراء/ النقّاد الكبار في العالَم من طراز «إزرا باوند» في الولايات المتّحدة الأميركيّة، وت. أس. إيليوت في بريطانيا، وقَبله مواطنه الشاعر/ الناقد البريطاني الكبير توماس إرنست هيوم.
كان خليل حاوي، رحمه لله، شخصيّةً حادّة، عنيفة، ممزَّقة من داخل شرّ تمزّق.. وعرفَ مراراً نوباتِ صَرَعٍ وتوتّراتٍ استثنائيّة خطرة. كانوا يشبّهونه بشريط الفولاذ، فهو مِثل هذا الشريط فعلاً.. شخص دقيق وقويّ ومتوتّر في استمرار.
الأمور الكبيرة كانت تُشغله دوماً.. وكان كفردٍ يَشعر أنّه المسؤول الأوّل عن أمّةٍ بأكملها، وعن تاريخٍ بأكمله، وخصوصاً في الفترة التي كان يرى نفسَهُ فيها أنّه انتقلَ، ونهائيّاً، من الشعور بالعَدميّة إلى اكتشاف قيَمِ الحضارة العربيّة، وصارتِ الوحدةُ العربيّة بالنسبة إليه أمراً يُمكن ترجمة مبادئه وتحقيقها.
لكنّه وعلى الرّغم من ذلك كلّه، ظلَّ نهباً للتناقضات في حياته الشخصيّة، وفي شِعره.. وهو تناقض مُستمَدّة مصادره من حركة الواقع المأسويّ المُبرْقَع الذي كنّا، ولا نزال، نتخبّط فيه عَرباً جميعاً. يقول خليل حاوي في دراما الهزائم العربيّة وقد تقطّرت مُتكاثِفةً فيه:
«ما لثقْلِ العار/ هل حملته لوحدي؟/ وهل وحدي ترى كفّنت وجهي بالرماد؟!».
«الجنازات التي يحملها الصبح/ تدوّي في جنازات السهاد/ الجباه انطفَأت وانطفأ السيف/ وأضواء البروج/ ليس في الأُفق سوى دخنة فَحم/ من مُحيطٍ لخليج».
كان خليل حاوي في الواقع يُعاني موتَ وعيٍ لا يموت، وولادةَ وعيٍ لا يولد.. وكان فيه - كما يقول شقيقه النّاقد الصديق إيليا حاوي - الشاعر والثّائر والشهيد... وهذه التجارب الأقنوميّة المُتداخِلة تلازَمت في شِعره وحياته، وكانت تَحتضن فيه الفاجعة على وسعِها. وحينَ وَضَعَ حدّاً نهائيّاً لنفسه ولسائر المُحبّين من حوله، كنّا نُدرك سلفاً أنّه آلَ إلى ذلك كلّه من حال انفصام الكلمة والفعل، ومن خمول الإرادة، ومن غياب ذلك الكائن الذي يُعرّي الفعل عن اسمٍ وظرفٍ وقِناع.
والخليل حين مات انتحاراً، ماتَ بالتأكيد عن نفسه، لكنّ الأكثر تأكيداً أنّه ماتَ عنّا جميعاً.
(يُنشر هذا المقال بالتزامن مع دورية «أفق» الإلكترونيّة الصادرة عن مؤسّسة الفكر العربيّ)