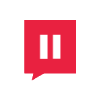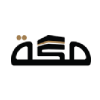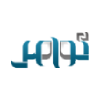اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ٢٥ تموز ٢٠٢٥
ابتسام المقرن
يشكو كثير من الكتّاب، وبخاصة الروائيين، من غياب النقد الجاد في المشهد الثقافي، ويطالبون باستمرار بقراءات عميقة تُنير ما كتبوه، وتفتح النصوص على أفق أوسع. وحين يتلقون قراءة عميقة من قارئ «واعٍ» أو ناقد خارج الدائرة الأكاديمية، يُقللون من شأنه أو يُنكرون عليه صفة الفهم والقدرة على التقييم. فمتى بالضبط يُسمح بالنقد؟ ومن الذي يملك رخصة شرعية لتقديمه؟ هذه الأسئلة تكشف أن الشكوى من غياب النقد ليست دائمًا تعبيرًا عن رغبة حقيقية به، بل قد تكون أحيانًا تعبيرًا عن توق داخلي للثناء المختلف أو «الموافقة المقنّعة»، لا النقد بمعناه الحقيقي: المراجعة، التساؤل، تسليط الضوء على الفجوات أو الزوائد. وهنا يظهر السؤال الحقيقي: هل المشكلة في غياب النقد أم في غياب قابلية الكتّاب لسماعه؟
من المؤسف أن علاقة الكاتب بالنقد تبدو أحيانًا كعلاقة مشروطة: هو يريده، لكن بشرط أن يمدحه. يريد من الناقد أن يرى ما أراد هو أن يراه، لا ما رأى النص فعليًا أن يقوله. هذه العلاقة غير المتزنة تجعل النقد الصادق يبدو وكأنه اعتداء شخصي، لا ممارسة طبيعية للحوار مع النص. ولعل هذا ما جعل بعض الكتّاب يتحولون إلى خصوم صامتين لأي قراءة لا تضع النص في إطار المديح. تتكرر هذه الإشكالية حتى مع كتاب لهم حضور واسع. الشاعر نزار قباني، على سبيل المثال، كان منفتحًا على النقد ويعده مساعدًا له في تطوير شعره، ولكنه بعد ذلك أصبح حساسًا جدًا للنقد، ويدافع عن نفسه بشراسة ضد منتقديه ويصفهم بالرجعيين والتقليديين، ويتهمهم بأنهم يغارون من شهرته ونجوميته، رغم تأكيده الدائم أنه لا يكتب إلا من أجل القارئ.
في المقابل، نجد كاتبًا مثل جبرا إبراهيم جبرا، استقبل النقد بانفتاح وتسامح، ويؤكد على أهمية النقد في تطوير الأدب والفن ويرى فيه وسيلة لتجاوز المألوف.
في عصرنا، تصاعدت هذه الحساسية، وأصبحت «النجومية» تحصّن بعض الكتّاب من أي مراجعة، فيكتفون بمتابعة منشورات الإعجاب، ويحظرون أو يهمّشون كل من يقرأ نصهم بنَفَس تأملي لا انبهاري.
النقد ليس نفي لجمال النص او عداوة بل قد يكون النقد في أحيان كثيرة هو أجمل أشكال الحب، حين يدلّ القارئ الكاتب على مناطق لم يكن يراها، أو على إمكانات خفية في نصه. ومن يحب الكتابة حقًا، يحب أن تُقرأ بأشكال متعددة من القراءات: تلك التي تُضيء، وتلك التي تُراجع، وتلك التي تُثير أسئلة لا إجابات لها. أما من يكتب ليُصفق له الجميع، فربما لا يحتاج ناقدًا بل جمهورًا فقط.
غالبًا ما يتعامل الكاتب مع نصه كامتداد شخصي، لا كنتاج منفصل قابل للقراءة النقدية. ما يكتبه ليس فكرة فحسب، بل قطعة من ذاته، ولذا يصبح نقد النص في نظره نقدًا له هو. وهنا تبدأ الأزمة: فبدل أن يرى الكاتب في القارئ ناقدًا مشاركًا في إعادة إنتاج المعنى، يراه خصمًا يهدد سلامة النص و»كرامة» صاحبه. في هذا السياق، لا عجب أن يرفض البعض أي ملاحظة تمسّ الصياغة أو البنية أو حتى العنوان. ومع ذلك، لا يمكن أن يصبح «عدم نضج بعض النقد» ذريعة لرفضه كله. لذا على الكاتب الذي يهمه ما يكتب، ويرغب حقًّا في التطور وتقديم الأفضل، أن يفرق بين النقد الصادق والنقد المؤذي، ويميز صوت الناقد المتعالي الذي يصدر أحكامًا كسولة أو هجومية بلا تحليل حقيقي، عن صوت القارئ الذي يقدم تشريحًا عميقًا للنص، وليس رأيًا عابرًا متعجلًا. وبالتأكيد أن الكاتب الذي يتسلّح بمرونة ذهنية سيعرف كيف ينتقي من النقد ما يصقله، ويرمي ما لا يستحق، دون أن يتحول إلى عدو لكل رأي مختلف. ويجب أن ندرك جميعًا أن سهولة النشر هذه يجب أن يترافق معها نمو مماثل في قابليّة تلقي الملاحظات، وسهولة تلقيها كذلك. في السابق قد يظهر النقد بعد سنوات، وربما بعد وفاة الكاتب. أما اليوم فنحن في عصر السرعة في النشر والتلقي معًا. وقد تكون هذه ميزة للكاتب إذا أراد الاستفادة منها حقًا، والاستماع لجميع الآراء ومحاولة تطوير أعماله وتجويدها قبل النشر المتعجل.
ربما حان الوقت لنتأمل جميعًا – قرّاءً وكُتابًا ونقّادًا – كيف نتعامل مع النصوص. أن نمنحها حريتها، ونفصل بينها وبين حساسيات كُتابها. فالنص لا يُقدّس، ولا صاحبه. والنقد ليس سيفًا موجهًا إلى قلب الكاتب، بل مرآة مخلصة تنعكس فيها قوة النص وضعفه، عمقه وتردده. وإن لم نستطع تقبّل هذه المرآة، فلن نتمكن من تطوير كتاباتنا ولا ذائقتنا، وسنظل عالقين في ترديد سؤال قديم لا إجابة له: أين النقد؟!