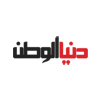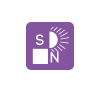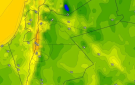اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٥
في الجريمة التي تتجاوز حدود الموت وتخترق كرامة الإنسان حتى بعد استشهاده، تكشف مشاهد جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين أعادهم الاحتلال مؤخراً في غزة عن مستوى غير مسبوق من الانحطاط الأخلاقي والوحشية المنهجية، أجساد منهكة، مقيّدة بالأغلال، تحمل آثار التعذيب والتشريح والنهب، لتتحول من رمزٍ للفداء إلى وثيقة إدانة مكتوبة على لحم الضحايا أنفسهم.
تضع هذه الجريمة المجتمع الدولي أمام مرآته المشروخة، أين القانون الدولي الإنساني الذي نصّ على حرمة الجسد البشري بعد الموت؟ وأين العدالة التي تغيب كلّما كان الجاني صهيونياً والمجني عليه فلسطينياً؟
إن ما يمارسه الاحتلال من تشويهٍ للجثامين، وسرقةٍ للأعضاء، واحتجازٍ للموتى في ثلاجات أو مقابر الأرقام هو سياسة ممنهجة تقوم على تجريد الفلسطيني من كرامته في الحياة والممات معاً، وبينما تنصّ اتفاقيات جنيف بوضوح على وجوب احترام الجثامين وتسليمها لذويها دون انتقاص، تصمت العدالة الدولية صمتاً يرقى إلى حدّ التواطؤ، لتبقى جثامين الشهداء شاهدة على انهيار المنظومة الأخلاقية التي تتزيّا بثوب القانون الدولي.
الجريمة الموثقة؛ حين يتحول الجثمان إلى شاهدٍ على العذاب
صور جثامين الشهداء الفلسطينيين التي أعادها الاحتلال في غزة كانت شهادة بصرية موثّقة على أحد أبشع وجوه الجريمة المنظمة التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطيني حيّاً وميتاً، فالأجساد التي وصلت بعد احتجازٍ دام أسابيع، كانت تحمل بصمتها الصارخة، من قيودٌ حديدية على المعاصم، وجروحٌ مفتوحة لم تُضمّد، وآثار تشريحٍ وتفريغٍ للأعضاء تُحشى بعدها الجثامين بالقطن، وآثار جنازير الدبابات على أجسادهم، في انتهاكٍ فجّ لكل ما هو إنساني أو قانوني.
الصور التي نقلتها وزارة الصحة في غزة كانت أرشيفاً دامغاً لجريمةٍ مركّبة تبدأ بالإعدام الميداني وتنتهي بالتنكيل بعد الموت، فبعض الجثامين أظهرت آثار إطلاق نار من مسافاتٍ قريبة، وأخرى تُركت تنزف حتى الموت، في حين تعرّضت أجساد أخرى لعمليات نهبٍ للأعضاء الحيوية كالقُرنية والكِلية والكبد في سلوكٍ يعبّر عن تطبيع الاحتلال مع فكرة انتهاك الجسد الفلسطيني كأرضٍ مباحةٍ للتجريب الطبي والانتقام السياسي.
ولم يعد الأمر مجرّد اتهامات فلسطينية، فشهادات الأطباء والباحثين الغربيين أزاحت الغطاء عن منظومةٍ سرّية محمية بقرارٍ سياسي وعسكري، فقد كشفت تقارير دولية منذ التسعينيات أنّ 'إسرائيل' تمتلك أكبر بنك جلود في العالم، تأسّس بإشراف الطبّ العسكري عام 1986، وتغذّيه جلود وأعضاء فلسطينيين تُنتزع قسراً من جثامين الشهداء، هذه المنشأة التي تُقدّم خدماتها لدولٍ غربية تحت شعار المساعدة الطبية، تُدار في الحقيقة كأحد مظاهر الاستعمار الجسدي الذي يمارسه الاحتلال، حيث يتحوّل الجسد الفلسطيني إلى مادة خام في اقتصاد التشريح الصهيوني.
وتكشف الباحثة الأنثروبولوجية مئيره فايس، في شهادةٍ موثّقة أنها شاهدت بنفسها كيف تُؤخذ القرنيات والجلد وصمامات القلب من الفلسطينيين، بينما تُترك جثث الجنود الصهاينة سليمة، وتصف كيف تُعوّض القرنيات المسروقة بعدسات بلاستيكية حتى لا يلاحظ الأهل شيئاً، وكيف تُستخدم جثث الشهداء في كليات الطب الصهيونية لأغراضٍ بحثية، في تجسيدٍ صادم لما يمكن تسميته بالاستعمار الطبي للجسد الفلسطيني.
هذه الجرائم هي سلوك مؤسسي مبرمج تؤكده تقارير منظمات مثل 'Organs Watch' التي أسستها الباحثة الأمريكية شيبر-هيوز عام 1999، والتي وثّقت شهادات حول سرقة الأنسجة والأعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين، ومنذ ذلك الحين ظلّت هذه السياسة تسير في الظل، محمية بجدار من الصمت الدولي والتواطؤ الغربي الذي يبرّر للقاتل كلّما رفع راية الأمن.
حتى الصحفي البريطاني أوين جونز، المعروف بمواقفه المناهضة للاستعمار، كتب أنّ 'إسرائيل' لم تكتف بتعذيب الأسرى حتى الموت، بل لم تتكلّف عناء إخفاء فعلها لأن الإعلام الغربي سيتجاهله، وهي شهادة تفضح التحالف غير المعلن بين آلة القتل وأجهزة التبرير الأخلاقي التي تغطي جرائم الاحتلال بعبارات حق الدفاع عن النفس.
إنّ المشاهد التي خرجت من غزة كانت مشهداً مكثّفاً لانهيار الحضارة الغربية أمام اختبار العدالة، فالجسد الفلسطيني في رحلته الأخيرة، قد تحوّل إلى وثيقة اتهامٍ مفتوحة، وشاهدٍ على منظومةٍ استباحت كلّ ما يمسّ كرامة الإنسان، وفي لحظةٍ كان يُفترض فيها أن يصمت الجسد، تكلّم الشهيد بلغته الخاصة، كاشفاً عن وجه الاحتلال حين يخلع قناع الديمقراطية، ويظهر على حقيقته، كياناً يمارس التعذيب كعلم، والتشريح كعقيدة، وسرقة الأعضاء كامتدادٍ لعقيدة النهب الأصلية التي قامت عليها 'إسرائيل' منذ نشأتها.
القانون الدولي الإنساني وحرمة الجثامين
في فلسفة القانون الدولي الإنساني، يُعامل الجسد البشري بعد الموت كأثرٍ للكرامة الإنسانية يجب صونه من أي امتهان، وقد جاءت اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 لتضع هذا المبدأ في صلب موادها، مؤسِّسةً قاعدة واضحة لا لبس فيها، أنّ للموتى حقًّا في الاحترام، كما للأحياء حقٌّ في الحياة.
تنصّ المادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى على وجوب أن تتخذ أطراف النزاع 'كلّ ما في وسعها لمنع تدنيس جثث الموتى أو سرقة أمتعتهم الشخصية'، وأن يُدفنوا باحترام وفق طقوسهم الدينية، كما تلزم اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 130) بأن يُعامل الموتى كضحايا محميين، لا يجوز المساس بجثامينهم أو استخدامهم في أي أغراض بحثية أو سياسية.
أما البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، فقد شدّد على 'احترام رفات الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في النزاعات المسلحة، وجمعها وإعادتها إلى ذويهم دون تأخير'، مؤكداً أن أي إخلال بهذا الواجب يُعد انتهاكاً جسيماً يرتقي إلى جريمة حرب.
وبالعودة إلى الواقع الفلسطيني، فإن ما تمارسه 'إسرائيل' من تشويهٍ لجثامين الشهداء، وسرقةٍ لأعضائهم، واحتجازٍ طويلٍ لهم في ما يُعرف بمقابر الأرقام أو ثلاجات الاحتلال، يمثل انتهاكاً متعدّد الطبقات لكل هذه المواد مجتمعة، بل يرقى إلى جريمة ممنهجة ضد الكرامة الإنسانية، ففي اللحظة التي يُمنع فيها ذوو الشهيد من وداعه، ويُحرم من دفنه، يُرتكب فعل مركّب من التعذيب النفسي والاجتماعي، تتواطأ فيه المؤسسة العسكرية والطبية والقضائية الصهيونية معاً، في خرقٍ سافرٍ لروح القانون الدولي ومقاصده الإنسانية.
ويؤكد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8) أن 'الاعتداء المتعمد على الكرامة الشخصية، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية، يعد جريمة حرب'، وهي صيغة تنطبق نصاً وروحاً على ممارسات الاحتلال بحق جثامين الشهداء، فحين يُستخرج العضو من جسدٍ ميتٍ دون إذنٍ أو غرضٍ طبي مشروع، وحين يُحتجز الجثمان كورقة مساومة سياسية، لا يكون ذلك مجرد تجاوزٍ إنساني، بل جريمة مكتملة الأركان يُعاقب عليها القانون الدولي باعتبارها انتهاكاً لجوهر الحق في الكرامة.
ومع ذلك فإن الصمت الأممي المستمر إزاء هذه الانتهاكات يُثير سؤالاً جوهرياً حول عدالة القانون حين يكون الخصم محصناً بامتياز القوة، فلقد تعاملت الأمم المتحدة في سوابق تاريخية مع جرائم مشابهة، كما في البوسنة ورواندا وسيراليون، باعتبارها انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف، وجرى إنشاء محاكم دولية خاصة لمحاكمة المسؤولين عنها، أما في الحالة الفلسطينية، فإن الجريمة ذاتها تُعامَل كملفٍّ إجرائي مؤجّل، وكأنّ القانون فقد ذاكرته حين وصلت الضحية إلى فلسطين.
إن المفارقة الموجعة هنا هي في تطبيع المجتمع الدولي مع تكرارها، فحين تُنهب أعضاء الشهداء، وتُحرق كرامتهم بعد موتهم، ثم تُقابل الجرائم بتقارير قلقٍ عميق وبياناتٍ رمادية، فإن العدالة لا تكون غائبة فحسب، بل متواطئة بصمتها.
لقد تحوّل القانون الدولي الذي أُريد له أن يكون مظلة الإنسانية إلى وثيقةٍ انتقائية تُفعَّل حين يكون الجاني ضعيفاً، وتُجمَّد حين يكون القاتل محصناً بدعم غربي، ولذلك فإن جريمة انتهاك جثامين الشهداء هي فضيحة قانونية ضد النظام الدولي ذاته، الذي لم يعد قادراً على حماية ما تبقّى من معنى الكرامة الإنسانية في نصوصه.
صمت العدالة وتواطؤ المؤسسات الدولية
الصمت الدولي تجاه جريمة انتهاك جثامين الشهداء الفلسطينيين أضحى سياسة مقصودة تُدار بذكاءٍ بارد من داخل منظومةٍ تدّعي حماية القانون بينما تمارس وأدَه عند حدود فلسطين، فكلّما انكشفت جريمة جديدة تُدين الاحتلال، يتوارى الخطاب الأممي خلف مفرداتٍ رمادية من قبيل التحقيق، والقلق العميق، ودعوات ضبط النفس، في الوقت الذي تُنهب فيه الأعضاء وتُحرق الكرامة وتُخرق الاتفاقيات على مرأى المؤسسات التي يفترض أنها وُجدت لحمايتها.
لقد تحوّل مجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى مسرحٍ للبيانات الشكلية التي تساوي بين الجلاد والضحية، بينما تُعطَّل لجان التحقيق أو تُفرَّغ تقاريرها من مضمونها بمجرد أن تقترب من خطوط 'تل أبيب' الحمراء، أما الأمم المتحدة التي طالما تباهت بميثاقها الإنساني، فقد اختارت أن تُبقي جريمة الجثامين الفلسطينية خارج نطاق التوصيف القانوني الصريح، خشية الاصطدام بجدار الفيتو الأمريكي والأوروبي الذي يحرس الاستثناء الصهيوني في القانون الدولي.
بهذا الاستثناء صار الاحتلال محميّاً بما يمكن تسميته بـ الفيتو الأخلاقي، تلك الآلية غير المكتوبة التي تمنح 'إسرائيل' حصانة مسبقة ضد المحاسبة، وتمنع توصيف جرائمها بالاسم الحقيقي خوفاً من كسر السردية الغربية المعلّبة حول الضحية الدائمة، وفي ظل هذا الفيتو، تُدفن الجرائم في أرشيف الأمم المتحدة كما تُدفن الجثامين في مقابر الأرقام، وتتحول العدالة من منظومة قيمية إلى إدارةٍ انتقائية للمشروعية، تُقرّر من يستحق العدالة ومن يُحرم منها.
ازدواجية المعايير هنا صارت بنية مؤسسية متجذرة في النظام الدولي نفسه، الذي يوزّع التعاطف بميزان القوة لا بميزان الحق، فحين وقعت جرائم في البوسنة أو أوكرانيا، تحركت المحاكم الدولية خلال أسابيع، واستُدعيت المفردات الكبرى: جرائم حرب، تطهير عرقي، عدالة دولية، أما حين يكون الجاني صهيونياً، تُستبدل هذه المفردات بأخرى مُخففة: تصعيد، حوادث مؤسفة، مخاوف إنسانية، وكأن الدم الفلسطيني يُقاس بميزانٍ لغويّ خاص لا يعترف بإنسانيته الكاملة.
وإذا كانت جثامين الشهداء قد عادت من ثلاجات الاحتلال محمّلة بآثار التشريح، فإن ضمير العالم خرج من ثلاجات العجز محمّلاً بآثار التجمد الأخلاقي، وهكذا يكتب صمت العدالة فصلاً جديداً من الجريمة، جريمة شراكة بالصمت، وتواطؤ بالمصطلح، وتجميلٍ قانونيٍّ لوحشيةٍ عارية لا يمكن تبريرها، ففي عالمٍ تُحاكم فيه الأمم الضعيفة على أنفاسها، وتُكافأ 'إسرائيل' على جرائمها، يصبح الصمت الدولي الوجه الأنيق للجريمة نفسها.
الجثمان الفلسطيني كرمزٍ للمقاومة والذاكرة
احتجاز جثامين الشهداء هو استراتيجية استعمارية تستهدف محو الذاكرة الوطنية وتجريد الفلسطيني من رمزية استمراره بعد الموت، فالجثمان في الوعي الفلسطيني يُمثّل أرشيف الوجود المقاوم، وشاهدٌ على السردية التي يحاول الاحتلال محوها من التاريخ، ويدرك الاحتلال أنّ الفلسطيني لا يُهزم بالرصاص، لذلك يحاول قتل رمزيته بعد استشهاده، فيمنع الجثمان من الدفن، ويحتجزه في ثلاجاتٍ أو مقابر أرقام بلا أسماء، كأنّ الهدف ليس الانتقام من الجسد بل عزل الذاكرة عن الأرض، وكسر الرابط بين الشهيد وجماعته، وبين الفعل المقاوم والمكان الذي وُلد منه، وهكذا تتحوّل مقابر الأرقام إلى مختبرٍ سياسيٍّ للطمس الممنهج، حيث تُستبدل الأسماء بالأرقام، والدم بالملف.
لكن ما غاب عن الاحتلال أنّ كل جثمان محتجز يصبح وثيقة حيّة للمقاومة، وأنّ محاولاته إخفاء الشهداء لم تُنتج النسيان، بل رسّخت الحضور، فكلما استعاد الفلسطيني جثماناً من ثلاجات الاحتلال، كان كمن يستعيد جزءً من ذاكرته المسلوبة، ويعيد دفنها في التراب الذي لم يُفرّط به، بهذا المعنى لم تعد الجثامين في الوعي الفلسطيني أجساداً راحلة، بل أيقونات مستمرة في الوعي، تنقل الذاكرة من جيلٍ إلى آخر، وتحمل الحكاية حيث يعجز الكلام.
لقد استخدم الاحتلال سياسة الجثامين كسلاح ردعٍ نفسي، أراد به أن يزرع الرعب في الوجدان الفلسطيني، وأن يجعل الموت ذاته مصدر خوفٍ وانكسار، لكن النتيجة جاءت عكسية، فالجثمان الذي أرادوه وسيلة إخضاع تحوّل إلى رمزٍ لتحرير الوعي، والموت الذي أرادوه نهايةً صار شكلاً جديداً من أشكال الحياة في الذاكرة الوطنية، هكذا فشل الاحتلال في معركته الرمزية، لأنّ الفلسطيني أعاد تعريف الموت كامتدادٍ في الوعي المقاوم.
أما الإعلام الفلسطيني في ساحته الحرة، وعلى امتداد المنصات والمخيمات والمنافي فقد أدّى دوراً حاسماً في كسر الصمت حول هذه الجريمة، وفي تحويل الجثمان من ضحية إلى وثيقة، فكل صورة لجسدٍ محمولٍ على الأكتاف صارت شهادةً بصريةً على بقاء الوعي، وكل تقريرٍ كشف آثار التعذيب صار صفعةً على وجه الرواية الصهيوينة التي تحاول تلميع نفسها بلغة القانون الزائف، بهذا، لم يعد الإعلام الفلسطيني مجرّد ناقلٍ للحدث، بل فاعلاً في إنتاج المعنى المقاوم، إذ يواجه السردية العسكرية الصهيونية بسردية الذاكرة والإنسان، في النهاية، حين يحتجز الاحتلال الجثمان، يظن أنه يحتجز الجسد؛ لكنه في الحقيقة يؤسّس لمعنى أعمق للمقاومة.
حين تصمت العدالة، تتكلّم الجثامين
تتحدّث الأمم المتحدة عن “القلق”، وتتلو بياناتٍ باهتة أمام شاشاتٍ تكتفي بالتنديد، بينما تستمر الثلاجات الإسرائيلية في احتجاز أجسادٍ باردةٍ لكنها أكثر حرارة من ضمائرهم، إنّ ما يجري ليس فقط خرقاً لاتفاقيات جنيف ولا انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، بل هو امتحان أخلاقيّ للبشرية جمعاء، فحين يُترك الجثمان الفلسطيني في ثلاجةٍ لسنوات، ولا تهتزّ المؤسسات الدولية، فإنّ السؤال لم يعُد: أين العدالة؟ بل هل ما زال لهذا العالم ضمير؟ هكذا تنتهي الحكاية لا بنهاية، بل ببدايةٍ جديدة، حيث يصبح الجثمان الفلسطيني شاهداً على موت العدالة وولادة الوعي.
ما بين المقصلة والميثاق، يظلّ الجثمان الفلسطيني وثيقةً مفتوحة على العالَم، تنطق بما عجزت عنه المؤتمرات والقرارات، إنّ ما فعله الاحتلال في أجساد الشهداء هو محاولة لاغتيال المعنى الذي يحمله هذا الجسد في ذاكرة الأمة؛ فحين يُفرَّغ الجسد من أعضائه، يُراد تفريغ القضية من روحها، وحين يُكَبَّل الشهيد بعد موته، يُراد تكبيل الحكاية قبل أن تصل إلى العالم.
لكنّ ما لم يُدرِكه الجلاد أنّ الجثمان الفلسطيني لا يُدفن في التراب، بل في الضمير، وأنّ كلّ عضوٍ نُهب، وكلّ جلدٍ سُلِخ، سيبقى شاهداً على سقوط منظومةٍ تدّعي حماية الإنسان بينما تغضّ طرفها عن أبشع امتحان لإنسانيّتها.
لقد اختبر الاحتلال القانون الدولي فوجد فيه هشاشةَ الميثاق أمام صلابة المقصلة، واختبر العالم فوجد فيه عجزَ الضمير أمام جسدٍ فلسطينيٍّ ممزّقٍ لكنه لا ينكسر، فهنا في هذه البقعة التي تتحدّى الموت بالموت، يُعاد تعريف العدالة لا في قاعات المحاكم، إنّما في صمت الجنازات التي تهتف: إنّنا لم نُخلق لنُدفن، بل لنُذكّر هذا العالم بما نسيه من معنى الإنسان.