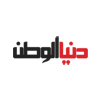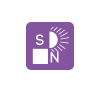اخبار فلسطين
موقع كل يوم -وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
نشر بتاريخ: ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥
الكاتب:
د. محمد عودة
لم تكن البداية في تحوّل الخلاص من نمطٍ سلطوي إلى نمطٍ آخر عند مارتن لوثر كينغ، فمنذ فجر التاريخ لم يكن الصراع حول الحقيقة صراعًا معرفيًا فحسب، بل كان في جوهره صراعًا على السلطة؛ فالذي يملك تفسير المعنى يملك الإنسان.
ولأن المقدّس والغيبي كانا دائمًا المدخل إلى الوعي الجماعي، فقد سعت القوى المهيمنة عبر العصور إلى احتكار القداسة بوصفها مصدرًا للشرعية، من المعابد القديمة إلى الكنيسة الوسيطة، ومن خطاب الإيمان إلى خطاب الدولة الحديثة. ظلّ المقدّس هو الواجهة الأنيقة للهيمنة، فحين ترتدي السلطة ثوب القداسة، تصبح الطاعة واجبًا، والعنف خلاصًا، والسيطرة ضرورة.
هذا الالتباس في العلاقة بين القداسة والسلطة بلغ ذروته في لحظة الإصلاح الديني الأوروبي، حين تزعزعت أركان الكنيسة الكاثوليكية، وبرز مارتن لوثر بوصفه حامل مشعل الحرية الروحية، بينما كان، في العمق، يمهّد لولادة شكلٍ جديد من الهيمنة أكثر خفاءً واتساعًا.
عندما طرح الراهب الألماني مارتن لوثر أطروحاته الخمس والتسعين عام 1517، بدا في الظاهر كأنه يفتح بابًا للحرية الروحية وتحطيم فساد الكنيسة الكاثوليكية، لكن ما بدا كصرخةٍ للضمير الفردي تحوّل بسرعة إلى إعادة إنتاج للسلطة تحت غطاءٍ أخلاقي وديني.
فالإصلاح الديني، الذي وُصف بالتحرري، أصبح أداة في يد الأمراء الألمان لتقويض نفوذ روما ونقل السلطة إلى الدولة الناشئة، مع إبقاء خطاب القداسة والخلاص كغطاءٍ أخلاقي يمنح الهيمنة الجديدة شرعيتها المزعومة.
طروحات لوثر، التي هاجمت فساد الكنيسة وبيع صكوك الغفران، رُوّج لها على أنها تحريرٌ للضمير والعقيدة، لكنها في الواقع كانت أداةً سياسية بامتياز. دعم الأمراء لفكرة لوثر لم يكن بدافع الإصلاح الروحي، بل لتحرير أنفسهم من النفوذ الاقتصادي والسياسي للكنيسة. حتى مارتن لوثر نفسه وضع نفسه في موقفٍ متناقض، إذ دعا إلى قمع الفلاحين المتمرّدين في حروبٍ دامية، مما كشف زيف الأهداف المعلنة، عندما تحولت أفكاره من دعوة إلى الحرية إلى أداةٍ لإنتاج قمعٍ من نمطٍ جديد. لقد أعاد الإصلاح توزيع السلطة لا أكثر، لكنه أبقاها ترتدي ثياب القداسة والخطاب الأخلاقي.
الخطاب الذي أنتجه لوثر صنع 'حقيقةً' دينية جديدة، لكنه في جوهره أعاد إنتاج سلطةٍ مركزية أقلّ وضوحًا من الكنيسة القديمة. الخطاب الأخلاقي سمح بتحديد العدو المشترك، سواء كان الكنيسة الكاثوليكية أو الفلاحين المتمرّدين، لتعبر السلطة السياسية الجديدة عن وجودها بالعنف المبرّر دينيًا. وهو منطق نجده مكرّرًا في الدولة العميقة الحديثة، وفي مشاريع استعمارية معاصرة مثل الكيان الصهيوني، حيث يُستخدم خطاب الشرعية لتبرير التوسّع والسيطرة على حساب الآخرين.
الدولة العميقة في صيغتها الحديثة تعتمد على الآليات نفسها التي استخدمها مارتن لوثر: إنتاج خطابٍ شرعي يخلق 'حقيقة' تخدم السلطة، وابتكار عدوٍّ لتبرير القمع، وصناعة هويةٍ نقية تُقصي الآخر.
ذريعة الإصلاح الديني ودعوات الحرية والخلاص، في غالب الأحيان، تتحوّل بسرعة إلى أدواتٍ لإعادة إنتاج السيطرة، وهو النموذج الذي تكرّر عبر التاريخ في أشكالٍ مختلفة من السلطة.
يُعتبر الكيان الصهيوني نموذجًا معاصرًا لهذا المنطق، فخطاب 'أرض الميعاد' و'حق العودة' يُستخدم لتبرير الاستيطان وتهجير الفلسطينيين، وخطاب الخلاص التاريخي يخفي مشروعًا استعماريًا مدعومًا بقوى غربية لتحقيق مصالح جيوسياسية.
العدو المفترض الفلسطينيون يُستغل لتبرير العنف، والخطاب الأخلاقي يُخفي الهيمنة والاضطهاد، وما يُقدَّم على أنه حق تاريخي وديني هو في الجوهر آلة لإنتاج السيطرة والإقصاء، تمامًا كما حوّل إصلاح لوثر الحرية الفردية إلى أداةٍ لإحكام السلطة.
ما حصل مع روزا باركس، رغم أنه أسهم في تغييرٍ في سلوك السلطة، إلا أنه لم يُغيّر السلطة نفسها. روزا باركس، المرأة الأمريكية التي رفضت التخلي عن مقعدها في الحافلة لأحد البيض في ألاباما عام 1955، لم تكن قد خططت لهذا التصرف مسبقًا، بل جاء مصادفة نتيجة إرهاقٍ طويل من الظلم المستمر.
لحظة المقاومة الصغيرة هذه لم تكن مجرد تصرفٍ فردي، بل كانت مواجهة مباشرة لمنطق الهيمنة الذي حاول تقديم الفصل العنصري كـ “نظام طبيعي' و'أخلاقي'. تمامًا كما حاولت بعض الخطابات التاريخية تقديم السيطرة باسم الروحانيات، كشفت مقاومة روزا باركس هشاشة هذه الخطابات، وأثبتت أن السلطة ليست مجرد فرضٍ مادي، بل إنتاجٌ للمعنى، وأن التحدّي للخطاب الأخلاقي الزائف قادرٌ على إحداث تغييراتٍ كونية في وعي المجتمع.
وإذا تأملنا هذا المسار، يتضح أن التلاقي بين إصلاح لوثر والهيمنة الحديثة لم يكن مجرد صدفةٍ تاريخية، فهناك منطقٌ ثابت يحكم العلاقة بين الخطاب والسلطة: استخدام الشعارات المثالية غطاءً للهيمنة، وإنتاج العدو لتبرير التجاوزات، وإضفاء الشرعية الأخلاقية على العنف، وصناعة هويةٍ خالصة النقاء لتبرير الإقصاء.
هذه القواعد تجعل من الإصلاح الديني نموذجًا قابلًا لإعادة الإنتاج، من الكنيسة إلى الدولة، ومن لوثر إلى المشروع الصهيوني، ومن الإصلاح إلى ما يُسمى اليوم بالأمن القومي والدفاع عن النفس.
إن ما يجعل هذا المسار التاريخي مستمرًا هو الضمير الجمعي الغربي الذي تشكّل منذ الإصلاح على فكرة الخلاص الفردي كتبريرٍ للهيمنة الجمعية. فالإيمان، الذي كان في الماضي طاقةً روحية، تحوّل إلى أداةٍ سياسية لفرض الطاعة والخنوع.
لقد نجح الغرب في نقل القداسة من الكنيسة إلى الدولة، ومن النص المقدّس إلى الخطاب المدني، دون أن يفقد روح السيطرة. وهكذا ظلّ العالم يسير وفق معادلةٍ واحدة: قناعةٌ داخلية بأن السيطرة ليست خطيئة، بل رسالة، وهذه، في جوهرها، هي الخديعة التي بدأها لوثر ولم تنتهِ بعد.