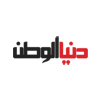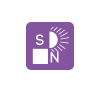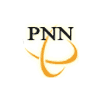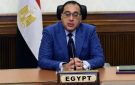اخبار فلسطين
موقع كل يوم -وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
نشر بتاريخ: ١١ تشرين الأول ٢٠٢٥
الكاتب: هديل ياسين
تمثل الحرب الأخيرة على غزة واحدة من أكثر النزاعات المسلحة المعاصرة تعقيداً من الناحية القانونية والسياسية والإنسانية. فهي لم تكن مجرد مواجهة عسكرية تقليدية بين جيش نظامي وفصائل مقاومة، بل كانت معركة على مفهوم الشرعية ذاته: من يملك حق الدفاع، ومن يُحاسب على العدوان، ومن يحق له استخدام القوة. لقد كشفت هذه الحرب عن فجوة كبيرة بين نصوص القانون الدولي وممارسات القوى الكبرى، وعن مدى عجز المنظومة الأممية في حماية المدنيين وضمان احترام القواعد الإنسانية. ومن خلال هذا التقييم، يظهر أن المقاومة الفلسطينية حققت مكاسب سياسية وقانونية تتجاوز حدود الميدان، بينما وجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه في مأزق قانوني وأخلاقي رغم تفوقه العسكري الظاهري.
إن تقييم نتائج الحرب يستوجب أولاً تحديد الإطار القانوني الذي يحكمها. فالقانون الدولي الإنساني، المستمد من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، يفرض على جميع أطراف النزاع التزامات محددة تهدف إلى حماية المدنيين وتقنين استخدام القوة. وتنص المادة الأولى المشتركة على أن احترام هذه القواعد واجب 'في جميع الأحوال'، سواء كانت الدولة طرفاً في النزاع أم جماعة مسلحة غير دولية. وبذلك، فإن الأعمال العسكرية في غزة تخضع لتلك المعايير، بما في ذلك مبادئ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والتناسب في الرد، والضرورة العسكرية، وحظر العقاب الجماعي. وبهذا المعنى، فإن أي تقييم قانوني للحرب يجب أن يُقاس بمدى التزام كل طرف بهذه المبادئ الأساسية.
في ضوء ذلك، يصبح من المشروع بحث ما إذا كانت المقاومة الفلسطينية تمارس فعلاً مشروعاً في مقاومة الاحتلال. فميثاق الأمم المتحدة في مادته الحادية والخمسين يمنح الدول حق الدفاع عن النفس ضد العدوان المسلح، غير أن تطور الفقه الدولي بعد الحرب العالمية الثانية أضاف بعداً آخر يتمثل في 'حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي في تقرير مصيرها ومقاومة السيطرة الأجنبية'، كما نصت عليه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة مثل القرار 37/43 لعام 1982 الذي أكّد صراحة مشروعية نضال الشعوب ضد الاحتلال بكل الوسائل المتوافقة مع القانون الدولي. من هذا المنطلق، فإن المقاومة الفلسطينية لا يمكن توصيفها كجهة إرهابية، بل كفاعل مشروع يرد على احتلال عسكري مستمر، خصوصاً وأن قطاع غزة ما زال خاضعاً لسيطرة إسرائيلية غير مباشرة في مجالات الجو والبحر والمعابر والاقتصاد، وهو ما يجعله وفق القانون الدولي 'إقليماً محتلا'ً بحكم الأمر الواقع.
أما إسرائيل، فبصفتها قوة احتلال، فهي ملزمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بحماية السكان المدنيين وعدم اتخاذ إجراءات تؤدي إلى تدمير البنية التحتية المدنية أو المساس بحقوق الإنسان الأساسية. غير أن الوقائع الميدانية، كما وثقتها منظمات مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، تشير إلى استخدام مفرط وغير متناسب للقوة، واستهداف واسع للمناطق السكنية والمستشفيات والمدارس. مثل هذه الأفعال تقع ضمن تعريف 'جرائم الحرب' وفق المادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لأنها تشكل هجمات متعمدة ضد المدنيين وتخالف مبدأ التناسب. كما أن استمرار الحصار على غزة يمثل صورة واضحة من صور العقاب الجماعي المحظور في المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، ما يجعل إسرائيل في مواجهة مسؤولية قانونية دولية يصعب التنصل منها.
من الناحية النظرية، تحاول إسرائيل تبرير أفعالها بذريعة 'حق الدفاع عن النفس' المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، لكنها بذلك تخلط عمداً بين الدفاع عن النفس والعدوان الاستعماري. فالمادة المذكورة تفترض وجود اعتداء من دولة ذات سيادة على أخرى، وليس من شعب محتل على قوة احتلال. وعليه، لا يمكن لإسرائيل أن تستند إلى هذا الحق وهي التي تمارس الاحتلال ذاته. بل على العكس، فإن الاحتلال هو العدوان الأصلي، والمقاومة هي الفعل الدفاعي المشروع في مواجهته. إن استخدام مبدأ الدفاع الشرعي لتبرير الحرب على شعب خاضع للاحتلال يشكل انتهاكاً جوهرياً لروح القانون الدولي ويفقد إسرائيل أي غطاء قانوني لأفعالها.
أما المقاومة، فرغم خضوعها بدورها لمعايير القانون الدولي الإنساني، فإنها حرصت في معظم عملياتها على استهداف مواقع عسكرية ومستوطنات تُعتبر امتداداً مباشراً للبنية الاحتلالية. وباستثناء حوادث محدودة يجري التحقق منها، لم تُسجَّل ضدها أنماط ممنهجة من استهداف المدنيين أو تدمير البنى الإنسانية. كما أن خطابها السياسي أكد التزامها بحقوق الأسرى ومعايير التبادل الإنساني. هذا السلوك، رغم محدودية الإمكانات، يعزز شرعيتها القانونية ويميزها عن قوة الاحتلال التي تمارس سياسة تدمير شامل بلا تمييز. ويُعد ذلك تحولاً مهماً في إدراك العالم لطبيعة المقاومة بوصفها فاعلاً سياسياً منضبطاً بالقانون وليس مجرد تنظيم مسلح.
سياسياً، نجحت المقاومة في فرض معادلة جديدة على الأرض، حيث لم تتمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها المعلنة بالقضاء على الفصائل المسلحة أو إسقاط حكمها الإداري في غزة. بل على العكس، استمرت المقاومة في القتال لأشهر طويلة رغم القصف المكثف، وأجبرت إسرائيل على القبول بمفاوضات بوساطة دولية، ما يعني أنها استطاعت تحويل الضغط العسكري إلى مكسب سياسي ودبلوماسي. فالصمود ذاته، في ظل حصار خانق وعدوان متواصل، يُعد انتصاراً استراتيجياً في منطق حروب التحرر، إذ يُبقي القضية الفلسطينية حيّة في الوجدان العربي والعالمي، ويمنع الاحتلال من فرض تسوية بالإكراه.
على الصعيد الدبلوماسي، أفرزت الحرب تحولات ملحوظة في المواقف الدولية. فقد أعادت القضية الفلسطينية إلى جدول أعمال الأمم المتحدة، وشهدنا موجة جديدة من الاعترافات أو التأييد المبدئي بدولة فلسطين من عدد من الدول الأوروبية واللاتينية. كما تصاعدت المطالب الشعبية في الغرب بفرض عقوبات على إسرائيل ووقف تصدير السلاح إليها. هذه التغيرات، وإن كانت رمزية، إلا أنها تعكس تآكل الرواية الإسرائيلية التقليدية التي طالما نجحت في احتكار الخطاب الإعلامي والسياسي في الغرب. لقد تحولت المقاومة من “موضوع إدانة” إلى “موضوع نقاش قانوني” يفرض نفسه في المحافل الدولية، وهو تحول بالغ الدلالة على المستوى المعنوي.
في المقابل، يعيش نتنياهو مأزقاً سياسياً داخلياً خانقاً. فالحرب التي كان يهدف من خلالها إلى توحيد الجبهة الداخلية الإسرائيلية وإعادة الاعتبار لهيبة الجيش تحولت إلى عبء ثقيل عليه. الانقسامات داخل ائتلافه الحكومي بين اليمين الديني واليمين القومي بلغت ذروتها، والمظاهرات في تل أبيب وغيرها تطالب بمحاسبة القيادة العسكرية والسياسية على الفشل في تحقيق أهداف الحرب. كما أن الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم حرب قد تلاحقه سياسياً، وربما قانونياً، خاصة بعد أن باتت المحكمة الجنائية الدولية تتابع عن كثب الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.
من جهة أخرى، أدت هذه الحرب إلى تآكل متزايد في شرعية إسرائيل الدولية. فقد صدرت تقارير متتالية من مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة تدين الاستخدام المفرط للقوة وتدعو إلى تحقيقات مستقلة. كما ازداد عزل إسرائيل في الرأي العام العالمي، وأصبحت حليفتها الكبرى، الولايات المتحدة، في موقف دفاعي متكرر في مجلس الأمن باستخدامها المتكرر لحق النقض لحمايتها. هذا العزلة ليست فقط دبلوماسية، بل قانونية أيضاً، إذ باتت الجرائم الموثقة تُؤسس تدريجياً لملف قانوني يمكن أن يُستخدم ضدها في المستقبل في محكمة الجنايات الدولية أو أمام محاكم الدول التي تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية.
ومن الزاوية المقارنة، فإن سلوك المقاومة يمكن اعتباره ضمن نطاق “الضرورة الدفاعية”، بينما يتجاوز سلوك الاحتلال هذا الإطار إلى “العدوان غير المتناسب”، وهو ما يجعل الأولى أقرب إلى المشروعية، والثانية أقرب إلى الإدانة. فالمقاومة، في حدود إمكاناتها، تمارس دفاعاً عن وجودها وحق شعبها في التحرر، بينما تمارس إسرائيل سياسة إخضاع ممنهجة تهدف إلى كسر الإرادة الشعبية عبر التدمير الشامل. إن هذا الفرق الجوهري بين الغاية والوسيلة هو ما يمنح المقاومة بعدا قانونياً وإنسانياً متماسكاً، ويجعل أفعال الاحتلال فاقدة لأي غطاء شرعي مهما كانت تبريراتها.
وعلى المدى البعيد، يمكن القول إن هذه الحرب أسست لمرحلة جديدة في تطور مفهوم “حق المقاومة” في الفقه الدولي. فالتجربة الفلسطينية أعادت تعريف هذا الحق بوصفه ليس مجرد عمل مسلح، بل منظومة دفاع سياسي وأخلاقي تحتمي بالقانون الدولي الإنساني وتُطالب العالم بتطبيقه بإنصاف. كما كشفت عن قصور النظام الدولي في فرض المساءلة على القوى المحتلة، الأمر الذي يفرض مراجعة عميقة لآليات العدالة الدولية لضمان عدم الإفلات من العقاب. لقد أصبحت غزة مختبراً حقيقياً لاختبار صدقية القانون الدولي نفسه.
إن النتائج النهائية للحرب تتجاوز الأرقام والإحصاءات. فإسرائيل خرجت مثقلة بالأزمات السياسية والعزلة الأخلاقية، فيما خرجت المقاومة أكثر حضوراً في الوعي الدولي وأكثر ثقة بقدرتها على فرض معادلة الردع. لقد تغيرت معايير النصر: لم يعد النصر مرتبطاً بعدد الطائرات أو حجم القوة التدميرية، بل بقدرة الطرف الأضعف على الصمود والبقاء والتأثير في المعادلة الدولية. وبهذا المعنى، تمثل الحرب على غزة لحظة فاصلة أعادت تعريف مفهومي الشرعية والعدالة في النزاعات المسلحة، وأثبتت أن الشعوب التي تملك الإرادة والحق يمكنها، حتى في ظل الحصار والدمار، أن تفرض وجودها كفاعل قانوني وسياسي لا يمكن تجاهله.