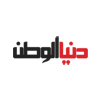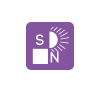اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥
في كل مرحلة تتزاحم فيها الأفكار، وتشتدّ فيها حركة الواقع، يحتاج الإنسان –فردًا كان أو مفكرًا أو صاحب رأي– إلى محطة يعود فيها إلى صفاء الميزان. وتأتي هذه الآية لتكون واحدة من تلك المحطات: ‘’تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ’’هذه الآية ليست خطابًا للعابدين وحدهم، ولا للسياسيين وحدهم، ولا للزهاد وحدهم؛ إنها خطابٌ للإنسان بما هو إنسان: بما يحمل من فكر، وبما يسعى إليه من تأثير، وبما يتفاوت فيه من قدرات ومسارات وظروف.
‘’لا يُريدون عُلوًّا’’ تطهيرٌ لمقاصد العقل والقلب
العلوّ الذي تذمه الآية ليس مجرد استبداد أو تسلط؛ إنه ميلٌ داخلي قد يتسلل حتى إلى المثقف الرصين والمفكر الهادئ: الرغبة في أن ينتصر رأيه، أو أن تُقبل كلمته، أو أن يُشار إليه دون غيره، أو أن يحظى بفوقية فكرية على من حوله .ومشكلتنا ليست في أن تكون لدينا آراء، ولا أن نبحث عن الحقيقة؛ بل في أن نخلط بين طلب الحق وطلب الارتفاع. التصوف هنا ليس طريقةً خاصة، بل هو فنّ تنظيف البواعث: أن تسأل نفسك قبل أن تكتب أو تتكلم أو تحلل: هل أقول هذا لأجل الحقيقة… أم لأجل نفسي؟ فالعلوّ يبدأ همسًا في القلب قبل أن يصير موقفًا في الواقع.
‘’ولا فسادًا’’ الفساد الأعمق هو فساد النظرة
الفساد ليس بالضرورة تدميرًا أو ظلمًا ظاهرًا؛ قد يكون في طريقة الفهم، أو في أسلوب النقاش، أو في نزعة الاستخفاف بالآخرين، أو في تحويل الفكر إلى مطرقة. المثقف قد يُفسد –دون أن يشعر– حين يجعل من رأيه ميزانًا للناس، أو حين يدخل في حالة من “الاحتكار المعرفي”، أو حين يتحول الخطاب إلى تجريح مستتر باسم النقد. الفساد الذي تحذر منه الآية هنا هو فساد الميزان الداخلي: فسادٌ لا يراه الناس، لكنه يجرّ صاحبه عن جادة العدل والإنصاف. والله لا يجعل الدار الآخرة لهؤلاء، ولو نطقوا بحِكمٍ، وكتبوا صفحاتٍ.
الآية ميزان للمفكر قبل أن تكون منهجًا للعابد
هذه الجملة “لا يريدون علوًّا” لو وضعت فوق رأس كل صاحب قلم، وصاحب رأي، وصاحب تحليل؛ لأصلحت كثيرًا من مسار الفكر العربي والإسلامي. ليس المطلوب أن ينخفض الإنسان عن الحق، بل أن ينخفض عن نفسه. أن يتعلم أن يزن كلامه بميزان الورع، وأن يفتح عقله دون أن يغلق قلبه، وأن يكون فكره واسعًا وقصده نقيًا. فالآية لا تمنع الاجتهاد، ولا الفكر، ولا النقد، ولا التحليل؛ بل تمنع النبرة التي تُلبس الفكر لباس العلوّ.
‘’العاقبة للمتقين’’ وعدٌ يزيل توتر المثقف ويضبط مسيرته
كثير من المفكرين والمثقفين يعيشون حالة من القلق: قلق من ضياع الصوت، أو غياب التأثير، أو انتشار السطحية، أو تقدّم الصخب على الحكمة. هذه الآية تقول: لا تهتمّ بنتائج اليوم… اهتمّ بصفاء القصد. العاقبة ليست لمن يعلو في لحظة، بل لمن يصبر، ويصدق، ويعمل دون أن يلوّث قلبه. المتقون ليسوا طائفة من المنقطعين؛ بل هم كل من جمع بين الفكر والنية، وبين العقل والورع.
هذه الآية ليست وعظًا تقليديًا، ولا درسًا أخلاقيًا عابرًا؛ إنها قاعدة كبرى لبناء الإنسان – أيًّا كان مجاله – على ميزانٍ رباني يدقق في الداخل قبل الخارج. فمن طهّرت نيته من إرادة العلوّ، وسلمت فكرته من إرادة الفساد، وثبت قلبه على التقوى… كان من أهل العاقبة، مهما اختلفت عليه الظروف وتفاوتت الأزمنة.
أحيانًا لا يكون خصمُ الإنسان هو العالم من حوله، ولا الأفكار المضادة، ولا ضجيج السطحية... بل يكون خصمه الحقيقي هو قلبه حين يطلب العلوّ وهو لا يشعر.ولحظات الصدق مع النفس قليلة، لكنها تغيّر العمر كله. يأتي عليك وقتٌ تجلس فيه وحدك، بعد ضوضاء الكتابة، ومقارعة الآراء، وتقلّب المواقف… فتسمع في داخلك صوتًا خافتًا يقول:’’ يا هذا… لمن تكتب؟ لمن تغضب؟ ولمن تنتصر؟ ألهذا الكلام قيمة عند الله إن لم يزكّ قلبك؟’’ ثم تدرك –بصمتٍ يشبه البكاء– أن الله لا ينظر إلى صفحاتك، ولا إلى عدد قرائك، ولا إلى حجم مكانتك، بل ينظر إلى الذرة الخفية من النية التي لا يراها أحد. هناك، في تلك اللحظة، يسقط من القلب كل ما ظُنَّ أنه علوّ، وينطفئ وهج “الأنا”، ويشعر الإنسان أنه أقرب إلى الله من كل كتبه ومقالاته وخطاباته. لهذا كان أهل المعرفة يقولون: ‘’ما أفسد الأعمال مثل رؤية النفس، وما أصلحها مثل شهود الله.” ومن ذاق هذه اللحظة، لم يعد كما كان؛ صار كلامه أرقّ، وفهمه أصدق، ونقده أنقى، وتواضعه أعمق، لأنه لمس الحقيقة الكبرى: أن الدار الآخرة لا تُعطى إلا لمن خفَّ قلبه من العلوّ، وثقل من التقوى.