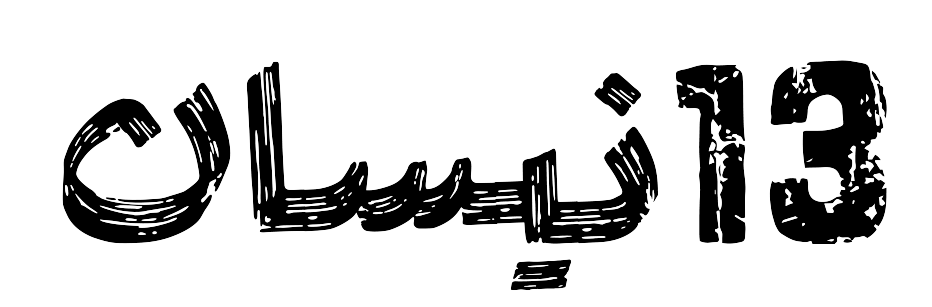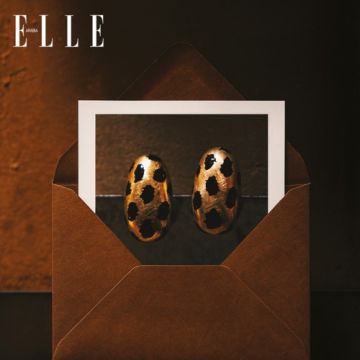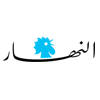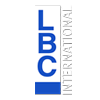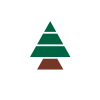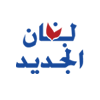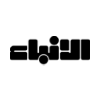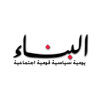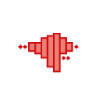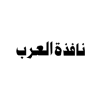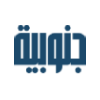اخبار لبنان
موقع كل يوم -نداء الوطن
نشر بتاريخ: ٨ نيسان ٢٠٢٥
في أسبوع «خمسينية» الحرب اللبنانية نجول على ما كان يُسمى «محاور». واليوم نتوقف في المتحف. فماذا في تفاصيل الذاكرة والحاضر؟
داخل المتحف الوطني في بيروت، وسط مقتنيات التاريخ التي خلفتها اثنتا عشرة حضارة مرت على لبنان، تظهر فجوة في لوحة فسيفسائية عزلت مع مجموعة قطع أثرية أخرى بغرفة لا يسمح باجتياز عتبتها. الفجوة هي من مخلفات الأحداث التي رافقت بداية الحرب اللبنانية الطويلة منذ العام 1975، والتي تبقي الجرح مفتوحاً على مآسي خط تماس نشأ عند «نقطة المتحف». كان يمكن لهذه المآسي أن تمحو كل أثر للحضارة اللبنانية المختزنة في هذه المنطقة، وتختزل تاريخها بمرحلة تقطع شرايين الوطن بين «شرقية وغربية»، لولا أن «المتحف الوطني» نفض عنه غبار الحرب الأليمة، واستعاد إشراقة صرح رسّخ ثقافة الحياة التي تغلبت على الحروب والموت.
تغيب ملامح الحرب الأهلية التي استمرت خمس عشرة سنة عن منطقة المتحف. والذكرى الخمسون لأحداثها الأليمة، تتغلب عليها الذكرى الـ 150 لنشأة الجامعة اليسوعية في المنطقة. على الأعمدة الممتدة من الصرح الجامعي المقابل للمتحف، وحتى المستديرة المجاورة له ارتفعت الصور. لا ليست صور الشهداء الذين قضوا في هذه المنطقة. إنما هي لتكريم خريجي الجامعة اليسوعية الذين لمعوا في الحياة العامة والخاصة بإنجازاتهم الإنسانية، فكانوا رواداً في مختلف المجالات التي برعوا بها.
بين من يتميّز بإنجازاته ومن يعتبر الموت إنجازاً
على أعتاب حرب عاشها لبنان في العام الماضي، وتكررت بأشكال مختلفة طوال الأعوام الخمسين الماضية، أتت مبادرة الجامعة اليسوعية في منطقة «خطوط تماس المتحف» برفع (صور) كل من خريجيها: البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، رئيس الوزراء الأسبق عبدالله اليافي، كمال جنبلاط مؤسس الحزب «التقدمي الاشتراكي»، جان دوكرويه رئيس جامعة القديس يوسف منذ بداية الحرب اللبنانية وحتى العام 1995، الشاعر والكاتب جورج شحادة، وغيرهم الكثيرين من النقباء والمهندسين والكتاب والأطباء الذين برعوا في حياتهم. فتماهت هذه الصور مع نفض آثار الحرب المدمرة عن المتحف ومعبره نهائياً، لتترجم مضي معظم اللبنانيين بالكفاح من أجل الحياة. لكنها ظهّرت، عن قصد أو عن غير قصد، الهوة الكبيرة التي تحكم الخلفيات الفكرية والعقائدية لمكونات المجتمع اللبناني، بين من يعمل لاكتساب شهرته من إنجازاته، ومن يعتبر الموت إنجازاً.
ذاكرة مغبّرة
بين المتحف المستعيد بريقه، وجاريه التربويين، الصرح المركزي للجامعة اللبنانية وصرح الجامعة اليسوعية، مركز المديرية العامة للأمن العام، السفارة الفرنسية والمؤسسات التربوية التابعة لها والتي باتت تعرف بـ Institut Français، والمطرانية الكاثوليكية، يصعب التصديق أن طريق الشام - المتحف هو المكان نفسه الذي تحول خلال الحرب الأهلية إلى مكان للانتظارات الطويلة والخطف والقتل أحياناً.
تخون الذاكرة من عايشوا هذه الأحداث بين العامين 1975 و1990، أما الأجيال الأصغر، فلا تعرف عنه سوى بعض ما كان يردده أهلهم.
هكذا تشعر وفاء كبي بارتياح كبير لدى اجتيازها المكان في رياضتها اليومية، وتعتبرها منطقة آمنة جداً، غير متأثرة بتاريخها الذي صنفها قبل خمسين سنة «خط تماس».
فيكتور فخر الدين السبعيني لا يذكر الكثير عن المكان أيضاً، مع أنه عايش الأحداث، وكان يضطر للانتقال أحياناً عبر خط تماس المتحف إلى مركز عمله في بدارو. يقف فيكتور إلى جانب المتحف ليخبرنا أنه «هنا كانت الشرقية حيث تسيطر مجموعة سريانية عرفت بـ «التيوس» وهناك الغربية حيث عرف الحاجز باسم «العجة». يذكر فيكتور أيضاً كيف كان النواب المسيحيون يحضرون من الجهة الشرقية والإسلام من الجهة الغربية ليجتمعوا في قصر منصور الموجود في المحلة أيضاً. ويصف فخر الدين بدارو حالياً بمنطقة جميلة ومتنوعة لينهي كلامه كما معظم من التقيناهم بـ «تنذكر ما تنعاد».
خالد سبليني كان عسكرياً يخدم في المستشفى العسكري في تلك المرحلة. فيذكر أنه كان هناك حاجز أمام القصر الفرنسي - بيت السفير، وآخر بين المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، وكان ممنوع اجتيازهما بالبزة العسكرية، لذلك كان يعبر إلى عمله كمدني. لم يفقد خالد المسلم ابن الاشرفية والذي يسكن في بيروت» إيمانه بلبنان على الرغم مما قاساه خلال مرحلة الحرب. يقول «الشعب اللبناني ينسى سريعاً» ولا يريد سوى بعض الطمأنينة، حتى يتحول اختلاف المذهب أمراً غير مهم بالنسبة له.
البروفسور ملحم شاوول كان هنا
الميزة في معبر المتحف خلال الأحداث أنه كان الوحيد الذي يفتح بين وقت وآخر. وبالتالي كان الناس يتدفقون إليه لحاجات متنقلة بين شطري المدينة. وفي بعض الأحيان «يكون الدم فاير» فيتعرض المارون عليه لمضايقات كثيرة.
تروي الدكتورة ندى شاوول، الأستاذة في كلية الحقوق في الجامعة اليسوعية، عن حادثة تعرض لها زوجها البروفسور في علم الاجتماع ملحم شاوول الذي سيطلق اسمه على شارع في زحلة قريباً. يومها كان يحاول اجتياز المتحف مع سائق نواف سلام، رئيس الحكومة حالياً، والدكتور أحمد بيضون، الذي كان أستاذاً بالجامعة أيضاً، فصودف مرورهم مع خطف شاب من الطائفة المسلمة ونزول حاجز خطف على الهوية، وكان حظ زوجي أنه المسيحي الوحيد في السيارة، فوضع في صندوق سيارة أخرى وخطف إلى مكان مجهول. تضيف شاوول «كنت خارجة من محاضرة لي في الجامعة اليسوعية عندما سمعت عن خطف زوجي من الإذاعة، والحمدالله أنه كان له طلاب من عائلة الخاطف، فعاد في اليوم نفسه سالماً».
تقول شاوول «ذكرياتنا عن المكان بشعة جداً. لأن خطوط التماس كانت أيضاً مناطق للخطف. وعليه لم يكن يقصد هذه المناطق إلا من هو مضطر لعبورها، وكان العبور محفوفاً بالمخاطر، ويحتاج إلى وسيط يعلم بالثغرات الموجودة». شارحة «أن خط التماس هو الذي يفرق بين منطقين، وكأنهما شعبان وثقافتان، فيشعر من ينتقل إلى المنطقة الثانية أنه تحت خطر الموت أو الخطف، وبالتالي تصبح المنطقة عدوة، والعكس صحيح. وهذا ربما ما ولّد ذكريات مدمرة يصعب محوها بسهولة، وخصوصاً لمن عاشوا مآسي هذا العبور».
طوينا صفحة ولكن لم ننهِ حرباً
تبدو الذاكرة وتوعيتها إذاً أمراً أساسياً. والتذكر ليس للانتقام، إنما للمرور بمراحل معالجة الذاكرة الأساسية، التي تتطلب أولاً الاعتراف ثم الاعتذار ثم المصالحة. بالنسبة لشاوول «لا يكفي أن نطوي الصفحة، يجب على كل فريق أن يعترف بأخطائه، ومن ثم يسامح الآخر على أخطائه. وإلا فإن هذه الأحداث ستبقى راسخة في لاوعينا لنعبّر عنها بكلمات لا نزال نستخدمها كالشرقية والغربية وخط التماس».
إذاً لا تزال الحروب والمتاريس حية في لاوعينا. ربما لأنه طويت صفحة الحرب الأهلية التي استمرت من العام 1975 إلى 1990، لكنها فعلياً لم تنته، إذ أن الحرب ليست بالضرورة متاريس وقصفاً، إنما تعتبر شاوول «أنها عنف يمارس أيضا على شكل سيارات مفخخة واغتيالات تطال الآخرين بسبب هويتهم السياسية».
إلا أن الحرب انتهت في العام 1990 بالنسبة لرئيسة لجنة مهرجان بيروت للأفلام الفنية الثقافية أليس مغبغب، لذلك هي ترفض القول إننا نعيشها منذ 50 عاماً، وبرأيها «حزب الله» وحده هو من ينقلنا من حرب إلى أخرى.
يتماهى كلام مغبغب مع شعار المهرجان بنسخته العاشرة لهذا العام بعنوان «أوقفوا الحرب»، والتي أتت برأيها غير عادية وسط التغيرات الكثيرة التي حصلت في المنطقة.
اجتهاد ونبل في زمن الحرب
الاجتماع حول الذاكرة والتراث هو هدف الجمعية، خصوصاً من بعد حرب أوجعت كل اللبنانيين. لذلك اختارت الجمعية «المتحف» لنسخة المهرجان الذي نظم في العام 2021 خلال جائحة كورونا، فأضاءت عليه من خلال وثائقي بعنوان Le Musée National, défi à loubli للمخرج بهيج حجيج، وعلى ما آل إليه من نقطة دمار وخراب وعذاب خلال الحرب وصولاً إلى إعادة الإعمار ونفض الغبار عن تاريخ لبنان المحفوظ في متحفه الوطني.
ثمة من اجتهد حتى في وسط تلك الحرب لتقديم ثقافة الحياة على ثقافة الموت. وإذا كانت هذه الثقافة تتجسد في صور مبدعي الجامعة اليسوعية، فإنه في زمن الحرب أيضاً، كانت هناك شخصية، سيبقى التاريخ مديناً لها، لأنها حفظت شواهد هذا التاريخ، ومنعت الإخوة المتقاتلين من تشويهها. إنه موريس شهاب المدير السابق للمتحف الوطني.
مما لا شك فيه أن للرجل سيرة تتخطى مرحلة الحرب، لكننا في الذكرى الخمسين لهذه الحرب نتوقف عند ما حققه خلالها تحديداً. نستعين بفيلم حجيج عن المتحف الوطني، بما يختزنه من سيرة مرحلة الحرب الأهلية تحديداً في هذه المنطقة.
تداعي المتاريس وانهيارها
يوثق حجيج لعذابات المواطنين في عبورهم على خط تماس المتحف، وما قاسوه من عذابات. لكن الفيلم يصور بشكل حي، طريقة تحطيم جدران الباطون السميك التي حفظت بداخلها الآثار التاريخية الثمينة داخل المتحف الوطني. ويرتقي تحطيم تلك الحيطان في زمن السلم إلى مستوى تعبيري عن انهيار المتاريس التي ارتفعت بين الإخوة، وذلك قبل الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار.
يقول حجيج «عند انتهاء الحرب كان المتحف بحالة مزرية. اتصل بي حينها كل من كميل الأسمر المدير العام السابق للآثار ورئيسة اللجنة اللبنانية للمتاحف سوزي حكيميان لتصوير مراحل إعادة الحياة إليه. عندما دخلت المتحف الذي كان قد تحول إلى خط الفصل بين الشرقية والغربية، كان فارغاً من الآثارات. لم أجد فيه سوى نحو عشرين مكعباً من الإسفلت تقريباً، إلى ان اكتشفت أن المدير السابق للمتحف موريس شهاب كان صاحب فكرة حفظ النواويس الثمينة جداً بداخلها، إلى جانب حفظه القطع الأثرية الصغيرة خلف بابين أغلقا عليها في الطابق الأرضي، وكانت فكرة رائعة لأنها نجّت التاريخ من جرائم الحرب».
كانت التجربة مؤثرة لحجيج الذي يعتبر أن أثر الحرب كان كبيراً وعميقاً. وبالتالي كان من الضروري أن يكون هناك عمل يشارك به في حفظ الذاكرة التي يقول إننا ننزع كلبنانيين دائماً إلى إزالتها من ذاكرتنا بسرعة.
أهمية الحرب في الأعمال السينمائية وفقا لحجيج «أننا ما زلنا نعيش تداعياتها. كانت مسألة تاريخية ومؤلمة بشكل لا يصدق وطبعتنا. فالحرب موجودة في خلايا كل من عايشها. وهذا لا يعني أننا نريد الحرب، إنما نحتاج لأن نتذكر كيف عشنا ما عشناه، ولماذا حصل ما حصل، وما هي نتيجته».
هذا ليس تاريخنا
بفضل حكمة موريس شهاب خلال الحرب إذاً، يستطيع اللبنانيون أن يتعرفوا إلى تاريخ بلدهم الحقيقي كما تقول بربارة مطران، المرشدة السياحية التي كانت تجول في المتحف مع قريبة لها. ترفض مطران أن يقترن تاريخ هذا المكان بسنوات الحرب التي حولت المتحف إلى منطقة تماس، «لأن قيمة هذا الصرح في هذه المنطقة كما تقول هي في ما يختزنه من حضارات على امتداد ستة آلاف سنة، بالإضافة إلى ضمه أكثر من 12 حضارة مرت على البلد. المتحف هو خلاصة لبنان».
بعد سكوت صوت المدفع تقول مطران إن الكثيرين كان لديهم الحشرية لمعرفة حجم الدمار الذي خلفته الحرب، كما أن الكثيرين كانوا معجبين بعملية الإعمار السريعة التي كان قد بدأ بها الرئيس رفيق الحريري حينها، إذ كنا بين أسبوع وآخر نشهد على تبدلات مختلفة.
لذلك تعتبر أن الإعمار السريع كان له فضل في إخفاء معالم خطوط التماس، بالإضافة إلى الزمن الطويل الذي بدأ يفصلنا عن الحرب. فخلال خمسين عاماً كانت هناك أجيال جديدة قد ولدت ولم تعش ما عايشه جيل السبعينات. لكن هذا لا ينفي أن هناك ذكريات مؤلمة اختزنها الموقع. ومن دمر بيته أو خطف أو قتل له أحدهم لا يمكنه أن ينسى.
فمتى تتغلب ذاكرة المكان على ذاكرة خطوط التماس التي خلقهتا الحرببين الشرقية والغربية؟
لنُسكت كل قرقعات الحروب
تعتبر مطران أن استمرار الأحداث اللبنانية يبقي خطوط التماس في القلوب. «فلبنان عملياً بلد بأربعة شعوب تختلف في نظرتها إلى الوطن. وربما يكون الله وحده قادراً على محو الأحقاد بما يحفظ تاريخ هذا البلد الحضاري».
تأسف مغبغب في المقابل أنه إلى الآن لم يأت من يملأ الفراغ الثقافي الذي خلفته الحرب. وتعتبر «أنه عندما يأتي وزير للثقافة كالوزير السابق، متشبع بلغة الحرب، ومديريات لا تقوم بعملها بالشكل اللازم لتنشيط الحركة الثقافية، فإنه من الطبيعي أن تتغلب ذاكرة الحرب على الذاكرة الحضارية للمكان».
السؤال نفسه طرحناه على حجيج أيضاً، فحرك مشاعرنا بسيناريو للتعافي، يجعل من منطقة المتحف، وخصوصاً الباحة المقابلة له، منطقة خالية من السيارات، ومستثمرة كمسرح للتلاقي الثقافي في أمسيات موسيقية راقية، تضيء على قيمة المتحف كصرح تراثي وطني وتاريخي، وتسكت قرقعات المعارك السياسية والعسكرية التي نعايشها منذ خمسين سنة... ألا يشبه هذا تماماً لبنان الذي نريده؟