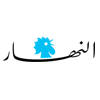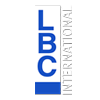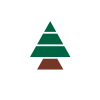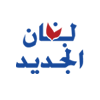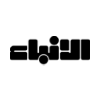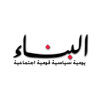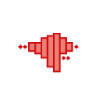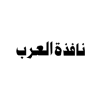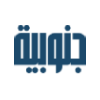اخبار لبنان
موقع كل يوم -المرده
نشر بتاريخ: ١٨ تموز ٢٠٢٥
من الضروري أن نفهم طبيعة الفكر النيوليبرالية التي تهَيمن على السياسات الاقتصادية العالمية. تقوم النيوليبرالية على تمجيد السوق الحرّة باعتبارها العقل المدبّر والكيان الأذكى القادر على تنظيم الاقتصاد والمجتمع، في مقابل تصوير الدولة كعائق بيروقراطي متطفّل ومزعج لا ضرورة لها. وفقاً لهذا المنطق، يخضع كل شيء إلى قانون العرض والطلب، الذي يُعتبر حجر الأساس في الاقتصاد الليبرالي، ويُفترض فيه أنّ السوق قادرة على تنظيم نفسها تلقائياً من دون أي تدخّل خارجي.
لكنّ هذه الرؤية الاقتصادية القائمة على الفلسفة البراغماتية، المرتكزة على القيمة العملية والمنفعة المادية المتوفرة في المجتمع وعند الأفراد، تحوّلت إلى أداة تسيطر على العقول والنفوس والعادات، وأوقعت بالإنسان ليُخضِعَ حياته إلى نمط من الحياة الموجّهة باستمرار، نحو ما تفرضه السوق الحرّة وفقاً لقانون العرض والطلب، الذي لا يأخذ في الإعتبار عملية التلاعب بماهية السلع أو تحديد الأسعار المرتفعة، ولا حتى يطرح مسألة العدالة الاجتماعية.
أصبحت الفردانية المتطرّفة Individualisme المبدأ الحاكم للتعامل بين أفراد المجتمع الواحد. كذلك، اقتصرت قيمة الفرد بما يمتلك لا بما يفكّر أو ينتج. فقد تحوّلت مقولة ديكارت «أنا أفكر إذاً أنا موجود» إلى «أنا أملك إذاً أنا موجود»، فتراجعت القيم الأخلاقية والإنسانية إلى الهامش.
من أبرز مُنظّري هذا الاتجاه الاقتصادي، «ميلتون فريدمان»، مؤسس المدرسة النقدوية في جامعة شيكاغو، الذي لعب دوراً محورياً في ترسيخ مفاهيم الاقتصاد النيوليبرالي. في كتابه الشهير «الرأسمالية والحرّية»، الذي يشكّل حتى اليوم رافعة الاقتصاد النيوليبرالي، يربط بين السياسة والاقتصاد الرأسمالي. ويشدّد على ضرورة إطلاق العنان للأنانية الفردية، باعتبارها دافعاً أساسياً للنشاط الاقتصادي، بل ويعتبر الجشع فضيلة لا رذيلة، هو المحرّك الأول للنجاح وليس الطموح. رفض مبدأ إعادة توزيع الثروات أو تدخّل الدولة في تنظيم السوق. واستخدم بشكل مفرط الطموح إلى الحرّية الذي عبّرت عنه أبرز شخصيات فلسفة التنوير والفلاسفة الليبراليِّين الإنكليز الكبار.
في جوهره، قانون العرض والطلب، أداة اقتصادية لتنظيم الأسعار في السوق الحرّة: كلما زاد الطلب وقلّ العرض، إرتفع السعر. والعكس صحيح. فلا يوجد معيار أخلاقي يَحكم على إذا ما كان هذا الارتفاع أو الانخفاض عادلاً أو إنسانياً. لكن عندما يُطبّق قانون العرض والطلب في سياقات استثنائية كالكوارث الطبيعية أو الحروب أو الأوبئة…، يطرح إشكالية وجودية أخلاقية: هل يجوز استغلال معاناة الآخرين لزيادة الأرباح؟ وهل يمكن اعتبار السوق عادلة عندما يُجبر على القبول بأسعار باهظة من لا حول له ولا قوة؟
إشكالية تضع الاقتصاد في تقاطع مع الأخلاق، لأنّها تتجاوز تطبيق شرعية التبادل الحرّ، لتلامس مفاهيم العدالة والضمير الإنساني والمسؤولية الاجتماعية. وتنهار التوازنات الطبيعية للسوق، ويصبح السعر انعكاساً لحالة اليأس. تنقلب السوق من فضاء للاختيار الحرّ إلى ساحة للإبتزاز الوجودي، حيث تُفرض الأسعار وفقاً لمبدأ «إدفع ولو مجبراً». من هذا المنظور، لا تكون السوق على حياد، بل تتحوّل إلى وسيلة للاستغلال الممنهج للبؤس.
فرص ذهبية للجشع
في السنوات الأخيرة، رأينا أمثلة صارخة. أثناء جائحة «كوفيد-19»، استُغِلّ الخوف الجماعي. إرتفعت أسعار الكمامات وأجهزة التنفّس بشكل جنوني، وانتشرت الأدوية واللقاحات في السوق السوداء. كذلك، بعد زلزال تركيا والمغرب ارتفعت أجور المبيت والنقل قرب مناطق الكارثة بشكل غير مبرّر. لم يتاجر أصحاب الأوتيلات، أو مطاعم، أو بائعو سلع أساسية في السلع فقط، بل في معاناة الإنسان نفسه. إنّها فرصتهم الذهبية لتحقيق أكبر ربح بأسرع وقت ممكن.
في بعض مناطق النزاعات، مثل غزة وسوريا، تضاعفت أسعار المواد الأساسية يومياً، ممّا عمّق الجوع والفقر، وزاد من معاناة السكان. في لبنان، استُغلت الحاجة إلى السفر في ظل محدودية الخيارات. مثلاً، فقد تمّت الاستفادة من اضطرار الآخرين للسفر من خلال فرض أسعار باهظة على تذاكر الطيران من دون حسيب أو رقيب.
من هنا، الفيلسوف الأميركي، جون رولز، في نظريّته عن العدالة الاجتماعية، يرى أنّ استغلال الأزمات لرفع الأسعار يتنافى مع المبادئ الأساسية للعدالة. ويؤكّد أنّ المجتمع العادل هو الذي يعمل على حماية الأضعف، لا تمكين الأقوى على حساب الآخرين. أمّا كارل ماركس، فيعتبر أنّ السوق الحرّة ذاتها، مهما بدت «عادلة»، تخفي علاقات غير متوازنة من الهيمنة والاستغلال. حتى من داخل الفكر الليبرالي، نجد جون ستيوارت ميل وسواه من المفكّرين، ينتقدون غياب البُعد الأخلاقي في تطبيقات السوق، مؤكّدين ضرورة تدخّل الدولة والضمير الجماعي لضبط الممارسات التي تستغل الفئات الضعيفة، لضمان العدالة الاجتماعية.
الربح في ذاته ليس محظوراً، لكنّه يصبح غير مشروع حين يُبنى على استغلال ممنهج، ولو كان ذلك ضمن منطق السوق أو في إطار القانون. وإذا كنّا نسعى إلى بناء مجتمع أكثر عدالة، فلا يكفي أن نُنظّم السوق، بل علينا أن نُعيد تأسيسه على قيم أخلاقية وإنسانية. فالسعر العادل ليس فقط ما يحدّده العرض والطلب وحدهما، بل ما تحدّده أيضاً الرحمة والضمير، خصوصاً في زمن المحنة.
وعليه، على الدولة ألّا تتراخى أمام هذه المشهدية، بل العمل على كبح جماح الجشعين، وضع سقف للأسعار، تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتعزيز الوعي الأخلاقي لدى الأفراد والمؤسسات، فتنتفي مقولة «مصائب قوم عند قوم فوائد». وحبذا لو ندرك أنّ دمار العالم يبدأ بانهيار الأخلاق.