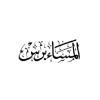اخبار اليمن
موقع كل يوم -شبكة الأمة برس
نشر بتاريخ: ٩ تموز ٢٠٢٥
فاروق يوسف*
عبد الأمير الحصيري والسيدة الغريبة
لم التفت إلى عوينات آسيا، لأنني لم أعد في حاجة إلى نظارة طبية. «لكنك لا ترى؟» قال عبد الأمير الحصيري، وكان واقفا عند باب حانة شريف وحداد. التفت إليه ضاحكا. «هل قررت أن تكون أعمى في بلد العميان؟» قلت له. «قل إني رأيت ما يكفي» شعرت بأنه يبكي، «صرتُ شاعرا من غير ملائكة»، سألته «ومن هم ندماؤك الآن؟»، «كل الصعاليك الذين أجلسوني على عرش مملتكهم». صمتَ. «سأعبر جسر الأحرار ألا ترافقني إلى الصالحية؟» «ما الذي سأفعله هناك. حتى جبار الغزي مات». تركته وأنا أفكر بالغزي الذي مات في ليلة ممطرة تحت جسر الجمهورية. صرت أغني «غريبة الروح» بعد أن وقفت تحت تمثال الملك فيصل. كان غريبا مثلي ولم يملك لعلاج غربته سوى أن يُحب امرأة غريبة مثله. دُفنت في بغداد لتكون قريبة منه ودُفن في بغداد ليكون قريبا منها. ذلك بلد للغرباء. فيه جاذبية مغناطيس لا يشعر بها سوى الغرباء. كان عبد الأمير الحصيري هو الآخر قد مات غريبا في الشارع الذي أحبه.
حسونة المصباحي وهند ستم
قال لي حسونة المصباحي «أريد أن اكتشف بغداد بعينيك»، قلت «لنذهب إلى سوق الصفافير» قال وسط موسيقى الطرق المنتظم على النحاس «فقدت حاسة السمع» قلت له «لنذهب إلى شارع النهر» تمتع كثيرا بالنظر إلى النساء العراقيات الجميلات، فقال «فقدت حاسة البصر» قلت له «نذهب إذن إلى سوق الشورجة» غمرته روائح البهارات فقال «فقدت حاسة الشم» قلت له «نذهب إلى باجة الحاتي في شارع الشيخ عمر»، بعد أن التهم طبقه قال «حاسة الذوق تخونني» قلت له «لم يبق لديك سوى حاسة اللمس. سأعيدك إلى فندق ميليا منصور بها». بعد ثلاثين سنة قضينا ثلاثة أيام في تيرانا. هربنا من مؤتمر للمعارضة الإيرانية وصرنا نتجول بين الساحات والحانات والحدائق والمطاعم. أخبرني يومها أنه لم يستعد حواسه، إلا بعد أسابيع من عودته إلى ميونيخ. قال ضاحكا «كانت بغدادك شبيهة بهند رستم». مات حسونة المصباحي في القيروان التي ولد فيها، وفيه شيء من قناوي الذي كان يبيع الجرائد في محطة باب الحديد في القاهرة.
موسى كريدي بين موته وحياته
يحب موسى كريدي قراءة الروايات، غير أنه لا يكتب سوى القصص القصيرة. سألته وكنا في مقهى البرلمان «لمَ لا تكتب رواية؟» ابتسم على طريقته الساحرة وقال «كيف أكتب رواية وأنا قصير». يقع مقهى البرلمان مقابل جامع الحيدرخانة. قلت له ذات مرة «مللت النظر إلى ذلك المشهد المضجر»، قال لي «هل تتخيل الحياة في مقبرة. النجف ليست مدينة. مقبرة السلام هي التي صنعت مدينة اسمها النجف»، يومها فهمت لمَ يتخذ حميد المطبعي من شقة كريدي في الكرادة مقرا لمجلة «الكلمة» التي تصدر من النجف. سألته «ألا يستحق ذلك العالم أن يكون ملهما للكتابة عنه؟» نظر إليّ بشفقة وقال «لقد هربت من الموت إلى الكتابة لماذا تريد أن تعيدني إليه؟ أنقذتني الكتابة من الموت». مات صديقي في سن السادسة والخمسين بعد أن اكتشف أن الكتابة التي أنقذته من الموت لم تكن على استعداد لإنقاذه من الحياة.
في انتظار جبرا
أحلى ما في جبرا إبراهيم جبرا علاقته بالكلمات. كان يتكلم مثلما يكتب وهو يكتب مثلما يتكلم. ومن قرأ كتبه لا بد أن يتخيل متعة الإنصات إليه. في مقابل تشاؤمي المتقطع كان جبرا متفائلا دائما. لديه قاموس غزل شخصي وهو الذي اختصر كل نساء الكون في واحدة هي لميعة العسكري. ما من امرأة التقت جبرا إلا وأحبته. أتذكر أن مرشدتنا السياحية وكان اسمها أحلام، وضعت رأسها على صدره ونامت. كنا ذاهبين إلى الموصل من أجل رؤية آثار النمرود. في تلك السفرة حدثني عن توفيق صايغ. لم أخبره أنني قرأت أعمال صايغ الكاملة لكي لا أشعره بأنني أعرف أنهما متشابهان. لم يحدثني جبرا يوما ما، عبر سنوات علاقتنا الطويلة عن نفسه وعن كتاباته. لم يكن متواضعا بالمعنى المبتذل. كان رفيعا وعفيفا ونزيها في علاقته بنفسه. حتى في مواجهة المديح كان يشعر بالحرج، كما أن ما يُقال يدفعه إلى الهروب. في كل أربعاء كنت التقيه في بيته. غير أنه مات في الثلاثاء التي سبقت الأربعاء الأخيرة. في الخميس جلسنا شاكر حسن آل سعيد وعلاء بشير وأنا في الغرفة التي كان يستقبلنا فيها جبرا ونحن في انتظار أن يطل علينا.
*كاتب عراقي