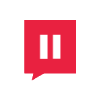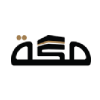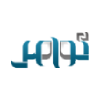اخبار السعودية
موقع كل يوم -اندبندنت عربية
نشر بتاريخ: ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٦
البر يعد ملاذاً للهرب من صخب المدن وضجيج الحياة المتسارع
في أحضان الصحراء السعودية يأخذ الصمت بيدك لترافقه في رحلة وجدانية تتجرد فيها النفس من ضجيج المدن وصخبها، فيما تنساب الرياح حاملة عبق الماضي وتلامس القلب، فتشعر أنك محاط بلوحة السكون والجلال، وفي البر تتلألأ النجوم مثل اللؤلؤ على بساط أسود، وتقترب منك بالتوازي مع خطى مثقلة بأتعاب الحياة لتراها الروح بعد العين.
كانت زيارتي للبر رحلة حملت فيها ذكريات الطفولة والصبا يوم كنا صغاراً نتسابق أنا وأقراني على تخطي آثار قوافل الإبل القادمة من الخزعلية إلى حي آل بوجلال بالخفاجية غرب الأحواز، واليوم وبعد ثلاثة عقود أشعر أنني ما زلت أخطو فوق الأثر ذاته، أثر لم تمحه السنوات ولم تبدده المسافات، مشفوع بحنين عميق إلى الأهل وإلى بدايات هجرة الآباء من شبه الجزيرة العربية نحو الأحواز.
نار متقدة تتوهج قبالة خيمة الشعر وكأنها تبوح بسر الشوق في صدر المضيف وهو يترقب قدوم ضيوفه، ويعلو صوت النجر فيمزق سكون الصحراء المهيب معلناً أن للقهوة اليوم مقاماً هنا، وأن للترحاب نداء لا يخطئه السامعون.
لاحقاً حدثني صديق بأن صوت النجر في البادية ليس مجرد صوت بل علامة كرم وراية استقبال، إشارة يعرفها الجيران فيتّبعون نغمتها ويهتدون إلى مجلس يجتمعون فيه على المحبة، وهناك تسكب القهوة لا كمشروب وحسب بل كطقس عريق، تتداخل فيه الأعراف والتقاليد وتتعانق فيه القلوب قبل الحديث.
لم يكن الوصول إلى المكان سهلاً، ففي زمن تختصر فيه الطرق بفضل تطبيقات الخرائط، لا يُهتدى إلى هنا إلا بالوصف وكأن المكان يأبى أن يسلم نفسه للتقنية، فالطريق يُروى ولا يرسم، وتشعر هنا أن الأماكن لا تزال تختار زائريها.
استقبلنا العم عبدالعزيز القحطاني وهو من أصحاب الإبل في منطقة القويعية ومعه أبناؤه في محمية فسيحة للإبل، وكانت الإبل آنذاك قد أوت إلى مضاجعها في مكان بعيد لكن في القرب من الخيمة، ولفت نظري سور يجاورها ويحتضن ناقتين اثنتين بدا حضورهما مختلفاً، وعلمت أنهما أعز ما يملك من إبله وأثمنها، فيحتفظ بهما قريباً من مجلس الضيوف على نحو يشبه عرض الجواهر في صدر المكان، لا للتفاخر بل تعبيراً صامتاً عن علاقة عميقة بين الرجل وإبله، حيث تتحول الملكية إلى مودة والحيازة إلى وفاء.
أتأمل الفتى وهو يسكب القهوة بوقار، شاب من إثيوبيا يناديه مضيفنا بـ 'أبو محمد'، فيمنحه الاسم قبل الأمر والاحترام قبل الطلب، ولاحقاً لفتني أن مثل هذا النداء ينساب على لسانه مع الجميع، فهذا 'أبو حسن' العامل القادم من السودان، وذاك 'أبو حياة' سائقهم من باكستان.
في ذلك المجلس بدا أن الإنسان يُعرف بكرامته قبل عمله، وأن القهوة تسكب محمّلة بمعنى أكبر: معنى الاحتفاء بالإنسانية حيث تتساوى الوجوه تحت سقف خيمة الشعر في المجلس الأصيل.
يتفانى العم عبدالعزيز في رعاية العاملين لديه بعين الأب قبل عين صاحب العمل، فالعامل القادم من باكستان شيخ جاوز الـ 80، يثقل عليه في هذا العمر استكمال أوراق الإقامة وما يتبعها من ضمانات، ومع ذلك تلقى العمُ الأمر بسعة صدر وكأنه يؤدي واجباً إنسانياً لا معاملة إدارية، فعلى امتداد أكثر من 40 عاماً من العمل المشترك لم تبق العلاقة محصورة في حدود المهنة، بل غدت رابطة وفاء عميقة يُقاس فيها الإخلاص وتصان فيها العشرة الطويلة.
حدثني صديق في المجلس بحكاية تلخص معدن الكرم كما هو فقال: ذات يوم قصد العم عبدالعزيز القحطاني أحد المجالس ومعه سائقه 'أبو حياة'، وما إن دخلا حتى بادر أهل المجلس بتقديم السائق وأجلسوه في صدر المجلس، إذ أوحت ملامحه وسمته ولباسه بهيبة شيوخ البادية، ولم يبادر العم عبدالعزيز إلى تصحيح الظن وآثر الصمت احتراماً للموقف، وترك للصدفة أن تأخذ مجراها إكراماً لعامل رافقه عمراً، وحين انكشف الأمر لاحقاً بدت القصة درساً صامتاً في النبل.
قبل أن نخلد إلى النوم دار المضيف في المكان كمن يراجع تفاصيل مشهد أخير، يتأكد أن كل شيء في موضعه ويكرر 'ترى البر ما يرحم'، ثم أخبرنا ببرنامج يوم الغد بصوت واثق لا يحمل استعجالاً، ولاحقاً أخبرني رفاق الرحلة وكانوا تسعة أنهم لن يوقظوا أحداً حتى تستيقظ أنت، قالوها ببساطة وكأن حضورك، بوصفك الضيف القادم من مكان بعيد، هو الذي يحدد بداية اليوم لا عقارب الساعة.
في اليوم التالي من داخل بيت الشعر رأيت العتمة تنسدل ببطء، خفيفة ومترددة، إيذاناً باليوم الجديد، وكان المضيف قد سبقنا إلى اليقظة، رأيته يضيف الحطب إلى النار فاشتعل اللهيب بهدوء وتسلل دفؤه إلى المكان كتحية ليوم جديد، فيما كانت رائحة الخشب ممزوجة بنسيم الفجر والضوء يزداد وضوحاً، وتبدأ الحكاية خارج بيت الشعر.
بعدها كان الموعد مع الإبل في مكان يبتعد قليلاً من بيت الشّعر، فوصلنا ووجدنا العاملين قد سبقونا وفرشوا السجاد بعناية تحت ظل شجرة صامدة، تقف وحدها في قلب الصحراء شاهدة على مرور الأيام، وكانت الإبل تتجول من حولنا بهدوء وكأن المكان يعرفها وتعرفه.
لفتت انتباهي ناقة يتدلى من عنقها جرس صغير دون غيرها، يرن بنغمة واضحة كلما خطت خطوة، وسألت عنها فابتسم العم عبدالعزيز وأوضح لنا أن أصحاب الإبل يعلقون مثل هذا الجرس على ناقة يحبونها كثيراً، لتُعرف من بين القطيع وتلفت الانتباه كلما مرّت، وكأن صوتها إعلان صامت عن مكانتها الخاصة.
كان رفاق الرحلة يتبادلون التحذير همساً، يُذكّر بعضهم بعضاً بأن للإبل ذاكرة طويلة وأنها إن حقدت لا تنسى، وفي المقابل كان العم يتحدث عنها بشغف واضح، فيسهب في التعريف بخصوصياتها ومكانتها في قلبه وكأنها ليست حيوانات وحسب، بل رفقاء العمر.
تمرّ ناقة قربنا فيشير إليها قائلًا إنها 'طيوبة'، ويدعونا إلى الاقتراب منها دون خوف فنفعل وقد سبقنا التردد، ثم تمرّ أخرى فيبتسم ويقول إنها أختها، تشبهها في السكون والطبع، أما الفحل فكان مختلفاً، واقفاً بثبات ومشدوداً من رجليه وقد أُحكم ربطه بحذر، فلا قسوة فيه ولا تراخ، فقط ما يكفي ليظل هادئاً، بعيداً من أي اندفاع قد يفسد اليوم الصحراوي.
وما إن حان وقت الغروب حتى بدا المشهد وكأننا نطوي صفحة درس طويل عن الصحراء وحياة الإبل، وفي تلك الساعة يسود الصمت ويتسع السكون، ووجدت نفسي أتأمل ما عرفته خلال يوم واحد فقط من ألفة صادقة ومحبة بسيطة تحكم هذه البقعة التي لا تظهر في تطبيقات الخرائط الذكية، لكنها في الواقع عالم مختلف له إيقاعه الخاص وعمقه الذي لا يُرى من بعيد، وعندما حان وقت عودتي كان علي التوجه مباشرة إلى المطار عائداً إلى لندن، فيما واصل رفاق الرحلة إقامتهم لليوم التالي.
لم تكن المغادرة سهلة، فقد واجهت صعوبة حقيقية في توديع المضيف والاستئذان بالرحيل، بخاصة مع إصراره الصادق على البقاء وكلماته التي عبّرت عن كرم أصيل، واحتاج الموقف إلى معرفة كيفية الوداع أكثر مما احتاج إلى قرار السفر نفسه، وبمساعدة رفاق الرحلة تمكنت من تجاوز اللحظة والحصول على إذن الرحيل، فغادرت المكان بعد تجربة قصيرة في الزمن عميقة في الأثر، بقيت تفاصيلها محفورة في الذاكرة.