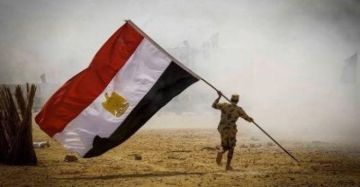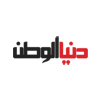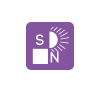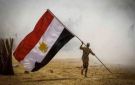اخبار فلسطين
موقع كل يوم -وكالة شمس نيوز
نشر بتاريخ: ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥
كتب: حسن نافعة
في عام 1977، قرر الرئيس السادات زيارة القدس، فجأة ومن دون التشاور مع أحد بمن فيهم أقرب مساعديه. لم يكن بمقدور أحد في ذلك الوقت إدراك حقيقة ما كان يدور في ذهنه، أو معرفة الأسباب التي دفعته إلى القيام بمغامرة بهذه الخطورة.
وبالتدريج، بدأت تصدر عنه تصريحات توحي بأنه بنى قراره هذا على افتراضات عدة، وربما قناعات شخصية، أهمها أن الجزء الأكبر من الصراع العربي- الإسرائيلي يعود إلى عوامل نفسية، وأن الولايات المتحدة 'تملك 99% من أوراق حله'، وأن الدول العربية لن يكون أمامها من خيار آخر سوى سلوك النهج الذي قرر أن يسلكه، والذي يتعامل مع حرب 73 باعتبارها آخر الحروب.
غير أنه سرعان ما تبيّن أن قراره الخطير لم يكن سوى قفزة واسعة نحو المجهول، وأن الافتراضات التي بنى عليها ليست صحيحة، بل وتنمّ عن عدم إدراك لطبيعة المشروع الصهيوني في المنطقة وأهدافه.
كان خطاب السادات في الكنيست ملتزماً بالموقف العربي العام، مؤكداً التمسك بتسوية شاملة تفضي إلى انسحاب إسرائيلي كامل من جميع الأراضي العربية التي احتلت عام 1967 وبإقامة دولة فلسطينية مستقلة، غير أن رد ييغين على هذا الخطاب كان شديد السلبية، وأعاد ترديد مقولة أن 'إسرائيل' لا تحتل أراضي الغير وإنما استعادت حقوقاً تاريخية '.
صحيح أن بيغين بدا رغم ذلك حريصاً على اغتنام الفرصة التي أتاحتها له زيارة القدس، لكن ليس للتوصل إلى تسوية شاملة للصراع، كما أراد السادات، وإنما لإخراج مصر من معادلته العسكرية، كي يتمكن بعد ذلك من تصفية القضية الفلسطينية وفرض شروطه للتسوية على بقية الدول العربية.
وصحيح أيضاً أن الرئيس كارتر سارع في الدعوة إلى مفاوضات تعقد في 'كامب ديفيد'، ما يعني حرصه أيضاً على توظيف مبادرة السادات لصالحه، غير أن مفاوضات 'كامب ديفيد' أعادت التأكيد أن موقف الولايات المتحدة من التسوية لا يختلف كثيراً عن موقف 'إسرائيل'، وأن ضغوطها مورست على الطرف المتلهف للتوصل إلى تسوية بأي ثمن، أي على السادات، ما يفسر قبوله تسوية منفردة.
ما يثير التأمل هنا أن بعض أعضاء الوفد المصري لم يتردد في تحذير السادات من عواقب الإقدام على تسوية منفردة، من منطلق أنها ستؤدي إلى عزل مصر وتآكل قدرتها على التأثير في محيطها الإقليمي والدولي، إلا أنه لم يأبه لهذا الرأي، حتى بعد أن كشف وزير خارجيته وصديقه محمد إبراهيم كامل عن اعتزامه تقديم استقالته، ومن ثم مضى في طريقه نحو تسوية منفردة كانت نتيجتها قطيعة مع مصر استمرت لعشر سنوات (1979-1989)، شهدت المنطقة خلالها أحداثاً جسام، كاغتيال السادات وغزو لبنان وحصار بيروت وإبعاد المقاومة الفلسطينية إلى تونس ومحاولة 'إسرائيل' فرض تسوية بشروطها على لبنان..الخ.
وحين عادت مصر إلى حضنها العربي بعد طول غياب، كانت قد تغيرت كثيراً وفقدت الكثير من قدرتها على التأثير في محيطها الإقليمي والدولي، ومن ثم لم تتمكن من منع وقوع كارثة الغزو العراقي للكويت عام 1991، وما نجم عنها من تحولات استراتيجية مهدت لتدمير العراق واحتلاله والإطاحة بنظام صدام حسين واستبداله بنظام طائفي، ما أفسح الطريق لعواصف عاتية راحت تهب تباعاً على المنطقة إلى أن وصلت إلى محطة 'طوفان الأقصى' بعد المرور على 'ثورات الربيع' المجهضة، والتي ولدت من رحمها حروب أهلية ما تزال مشتعلة حتى الآن.
اليوم، وبعد ما يقرب من نصف قرن، تبدو مصر، حكومة وشعباً ونخباً فكرية وسياسية، في أمسّ الحاجة إلى مراجعة شاملة وعميقة للعلاقة التي تربطها بـ'إسرائيل'، بل ولمجمل السياسات التي أوصلت مصر إلى ما هي فيه الآن. لكن، قبل القيام بهذه المراجعة، علينا جميعاً أن نتذكر أن السادات لم يأل جهداً في بيع أوهام كثيرة للشعب المصري، كي يتمكن من تسويق زيارته للقدس، خصوصاً ما يتعلق منها بتأكيده أن 'السلام والازدهار' سيعمّان مصر عقب إبرام 'معاهدة السلام' مع 'إسرائيل'.
لذا، يحق للشعب المصري، الذي ما زال يعاني مرارة العوز والحرمان رغم مرور كل هذه السنوات، أن يتساءل اليوم: عن أي سلام وازدهار نتحدث، وهل يمكن لأي منهما أن يتحقق في بلد تحيط به الأخطار من كل جانب؟ وهل تساعد العلاقة الخاصة التي ما تزال تربط مصر بـ'إسرائيل' تفاقم هذه الأخطار أم تحد منها أم أنها كانت سبباً رئيسياً فيها؟
تجدر الإشارة هنا أن الأخطار المحدقة بمصر كانت، حتى زيارة السادات للقدس، أو بالأحرى حتى حرب أكتوبر، تقتصر على التهديد القابع وراء حدودها الشرقية، والذي تجسده 'إسرائيل'.
أما اليوم، فقد أصبحت هذه الأخطار تحيط بها من كل جانب. من الغرب: حيث تتصارع على السلطة، من وراء الحدود التي تفصلها عن ليبيا، حكومتان لا تستطيع أي منهما فرض سيطرته على كامل الأراضي الليبية أو حتى حماية الحدود مع مصر. ومن الجنوب: حيث تشتعل، من وراء الحدود التي تفصلها عن السودان، حرب أهلية تهدد بمزيد من الانشطار إلى دويلات عدة تضاف إلى دولة جنوب السودان التي انفصلت عنه منذ سنوات.
وفي أقصى الجنوب، حيث منابع نهر النيل، توجد إثيوبيا التي تنتهج حكومتها الحالية سياسة معادية تستهدف التحكم في تدفق الموارد المائية المتجهة إلى مصر، ما يعني حرمان مصر من حقوقها التاريخية في مياه النهر العظيم، وتسعى في الوقت نفسه للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، ما يشكل خطراً جسيماً يهدد حركة الملاحة المتجهة نحو قناة السويس.
كان يفترض أن تؤدي معاهدة 'السلام' الموقعة مع 'إسرائيل' عام 1979، إلى تهدئة الأوضاع على حدود مصر الشرقية، وإلى تنمية وازدهار سيناء، التي طالما روج عن وجود خطط تنموية تسمح بتوطين ما لا يقل عن 5 مليون مواطن، وبالتالي تخفيف الكثافة السكانية للدلتا المكتظة.
غير أن ما يجري اليوم وراء هذه الحدود يتناقض كلياً مع ما كان يروج له منذ أكثر من 54 عاماً. فقطاع غزة، الذي خضع للإدارة المصرية من 1949-1967، أحالته 'إسرائيل' إلى كومة هائلة من التراب، وقتلت وجرحت ودفنت تحت أنقاض بيوته المهدمة ما يقرب من 10% من سكانه الذين يزيد تعدادهم على 5.2مليون نسمة، أي ما يقرب من ربع مليون شخص معظمهم من الأطفال والنساء، بل وحاولت إخلاء القطاع وتهجير جميع سكانه قسراً إلى سيناء.
ولولا وقوف الرئيس السيسي بصلابة ضد هذا السلوك البربري لكانت مصر اليوم في وضع أمني بالغ السوء. فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن نتنياهو استغل عملية 'طوفان الأقصى' ليس لإعادة احتلال قطاع غزة فحسب، وإنما أيضاً لتصفية محور المقاومة ككل تمهيداً لإقامة 'إسرائيل الكبرى'، بدليل أن آلة الحرب الإسرائيلية الجهنمية راحت تضرب بعنف في كل اتجاه، ووصلت إلى عواصم لبنان وسوريا واليمن وإيران، لتبيّن لنا بوضوح أن التوحش الإسرائيلي أصبح خارج السيطرة، وبالتالي ما لم يتم وقفه الآن فسوف يظل يعيث فساداً ونهشاً في كل جنبات المنطقة إلى أن يتمكن من إحكام سيطرته عليها.
تأمل السلوك الإسرائيلي، منذ زيارة السادات للقدس وحتى اليوم، يظهر بوضوح أن 'إسرائيل' ليست معنية بالتعايش مع شعوب المنطقة، لكنها تصر على الهيمنة عليها وفرض إرادتها على حكوماتها. ولو أنها كانت تبحث حقاً عن التعايش السلمي مع الشعوب، والاندماج مع الدول والحكومات وفق قواعد القانون الدولي، لأمكنها ذلك منذ سنوات بعيدة، خصوصاً بعد أن أكدت قمة بيروت لعام 2002 استعداد جميع الدول العربية تطبيع علاقاتها مع 'إسرائيل' إذا وافقت الأخيرة على الانسحاب من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 وعلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
غير أن 'إسرائيل' تعمّدت إهدار جميع الفرص التي أتيحت أمامها للتوصل إلى تسوية شاملة تحقق الاستقرار في المنطقة. ويكفي أن نتأمل نهجها الحالي في التعامل مع سوريا ولبنان لندرك أنها ما تزال تراهن على الأقليات الطائفية والعرقية كمدخل لفرض هيمنتها على المنطقة، كما يدل قرارها بالاعتراف باستقلال أرض الصومال (صوماليلاند) أنها تسعى لفصل هذا الإقليم عن الصومال، الدولة العضو في جامعة الدول العربية، وتبحث عن موطئ قدم على شاطئ البحر الأحمر، بالقرب من باب المندب بالذات، تقيم عليه قاعدة عسكرية، ما يشكل تهديداً مباشراً لكل الدول الواقعة على سواحله، وبالذات لمصر والسعودية.
مطالبة مصر بإعادة النظر في علاقتها بـ'إسرائيل' لا تعني مطالبتها بإلغاء معاهدة 1979، وإنما بالتعامل مع 'إسرائيل' كعدو، وليس كـ'دولة' تتعامل مع جيرانها بحسن نية، لأن سلوكها يؤكد عدوانيتها ويثبت نيتها وحرصها على إضعاف مصر وحصارها والعمل على تطويقها من جميع الاتجاهات.
لذا، على مصر أن تعاملها بالمثل، وأن تمتنع عن القيام بكل ما من شأنه مراكمة عناصر القوة لدى 'إسرائيل'. وعلى سبيل المثال، فحين تسعى مصر لسد احتياجاتها من الغاز، تقضي مصالحها العليا بأن تمتنع عن شرائه من 'إسرائيل'، حتى ولو كان ذلك يحقق لها فائدة اقتصادية آنية، وأن تستند في تقييم أي صفقة محتملة معها إلى معايير استراتيجية تتعلق بأمن مصر الوطني والقومي، وليس إلى معايير فنية بحتة مثلما حدث عند إبرام صفقة الغاز الضخمة التي بلغت قيمتها أكثر من 34 مليار دولار.
توجد حاجة ملحّة لوقف التوحش والانفلات الإسرائيليين. ولأن مصر هي الدولة العربية الوحيدة القادرة على تعبيد الطريق نحو تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الثمين، عليها إعادة النظر في مجمل السياسات التي بنى عليها السادات قراره بالذهاب إلى القدس. وفي تقديري، أن التصدي لمخططات الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة بات يتطلب تنسيق الجهود مع كل من السعودية وتركيا وإيران للعمل على وضع إطار جديد للأمن الإقليمي.