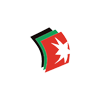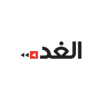اخبار الاردن
موقع كل يوم -صحيفة السوسنة الأردنية
نشر بتاريخ: ١ تشرين الأول ٢٠٢٥
قرن مضى تقريباً على ما طرحه طه حسين في كتابه الإشكالي «في الشعر الجاهلي» (صدر في سنة 1926)، على العقل العربي المثقل باليقينيات بعد فترات الانحطاط المتراكمة، وأحرجه في صمته ويقينياته. أعاده بأسئلته الحادة إلى بداية الأشياء، أي إلى السؤال البسيط والمحرج، إلى ما كان يبدو بديهياً: ما دليلي فيما ذهبت إليه؟ ما يبدو مسلمة، هل هو كذلك؟ لماذا نخاف الأسئلة التي تهز يقينياتنا التي ليست كذلك في جوهرها لأنها تعتمد على مجموعة أفكار جاهزة لم تُختبر داخلياً؟ آمنا بوجود الشعر الجاهلي، وسلمنا به.
درسناها وقسمناها إلى أغراض وقيم فنية، ونسينا أن هذا الشعر يحتاج إلى اختبار داخلي يعيد الأشياء إلى حقائقها الأساسية. ماذا لو لم يوجد أغلبه أصلاً؟ وهو مجرد تأليف في العصر الإسلامي، لأنه يرسم في عمقه الحقبة الإسلامية بمختلف تلوناتها الحضارية وحتى لغتها، ولا علاقة له بالأنماط الحياتية القبلية الجاهلية؟ الشك المنهجي ليس كفراً ولا تعدياً ثقافياً، فهو آلة لاختبار الحقيقة والتفريق بين الغث من السمين.
ومن بين تجليات انهيار هذا العقل الباحث، الرقابة والمصادرة والمنع. وعلى الرغم من أن الرقابة وباء معطل لكل مبادرة حية للقفز إلى الأمام، نفهم جيداً أن يُمنع كتاب أو مقالة أو مجلة لشيء ما قد لا يتناسب سياسياً أو اجتماعياً أو ثقافياً، أو أن الرقيب قرر أن هذه المادة أو تلك ستضر بالشعب أو بأجزائه الهشة، لكن أن يظل كتاب ممنوعاً عشرات السنين، فهذه كارثة.
فقد ظل كتاب «في الشعر الجاهلي» ممنوعاً من 1926 تاريخ صدوره لأول مرة حتى 1996 عندما أفرج عنه الكاتب الكبير غالي شكري، حينما خصص له عدداً مميزاً من مجلة القاهرة التي كان يشرف عليها، وأعاد طباعته في المجلة مع الملف القضائي والسجالي الذي صاحبه.
مع أن صاحب الكتاب مات وتحول إلى رميم، والظرفية التي انتجت الكتاب انتهت وأنجبت أشكالاً تفكيرية أخرى، والذين أمروا بالمنع أو قاوموه قضائياً لم يعودوا بيننا اليوم، والذين برأوا طه حسين من أية تهمة تركوا الحياة وانتقلوا إلى دار البقاء. بينما بقي المنع مستمراً كالوباء إلى وقت قريب، ولم يُرفع قط بشكل رسمي إلى اليوم، مثل سجين تحول مع الزمن إلى علامة لا معنى لها، أو مجرد رقم بليد لا يحيل إلى إنسان يموت كل يوم قليلاً، نُسِيَ في زنزانته إلى يوم موته وعثر عليه بالصدفة الغريبة عمال السجن وهم ينظفون المكان، حفنة من العظام.
مأساة حقيقية شديدة القسوة يقف العربي المفكر أمامها مجرداً من أي سلاح، حتى تحولت الحالة كأنها قدر علينا القبول به، بينما هذه العقلية هي في النهاية صنيعة البشر وليست شيئاً آخر. مشلولون حتى العظم، وأكثر من هذا، نقف ضد كل الوسائط الفكرية التي تزيل هذا الشلل. المشكلة أن لا شيء تغير باستثناء واجهات الكثير من مدننا الجميلة.
العقل الفاعل يراوح مكانه. قرن مضى، أو يكاد، مثقلاً بالأحداث والهزائم وتراجع العقل، وما زلنا نراوح أمكنتنا القديمة. نواجه المعضلة نفسها بنفس الأدوات القديمة وكأن لا شيء تغير في بنياتنا الفكرية، وكأن أسئلتنا الكبيرة والجوهرية ما تزال تراوح أمكنتها.
وكلما حاولت أن ترتقي بأسئلتها الجوهرية، كما في حالة طه حسين وغيره، تُقاوَم وتُمنع قبل أن ترتد إلى الوراء من شدة الضغط والتكفير، لتصبح جزءاً من العاملة. ما تزال العقلية العربية المتسيدة، تخاف من العقل الذي بناه معرفياً رجالات الفكر العرب مثل ابن خلدون، ابن رشد، ابن طفيل، ابن حزم، ابن سينا، الفارابي، الكندي وغيرهم كثير.
هناك خوف مبطن في ثقافتنا يتلخص في الخوف من الخروج عن جادة الصواب؛ أي عن الدين في معناه الأكثر انغلاقاً، مع أن العقل ليس أكثر من جهاز لفهم العالم والسير به قدماً نحو التقدم وسعادة البشر. لن أضيف شيئاً جديداً إذا قلت إنه بعد مضي قرابة القرن على صدور الكتاب: «في الشعر الجاهلي» ومنعه بقرار قضائي، ومحاكمة طه حسين محاكمة قاسية، ما يزال هذا الخوف ماثلاً في ثقافتنا وحواراتنا، كما لو أنه لا قيمة للزمن الذي يحيط بنا ويعيشنا دون أن نتمكن من عيشه، بل إن الزمن الطويل الذي مضى في محاربة العقل وتدجينه، ولَّد لدينا تأقلماً مرضياً لقبول كل شيء، بما في ذلك ما يقف ضد العقل. هذه العقلية المصابة بوجع المسبقات الجاهزة لا تنتج أي فكر، وغير قادرة على إحداث القطيعات التي تفترضها أي حداثة تريد تغيير الأنماط المتسيّدة على مختلف الحقول. هل كان طه حسين متقدماً على عصره؟ الكثيرون يقولون هذا. لا أعتقد، فلا أحد يسبق عصره.
كل إنسان هو ثمرة لمحيط وتحولات قد تتخطاه. ما طرحه طه حسين حول ضرورة تحرير العقل من المسبقات الثقافية والاجتماعية والدينية بإدراج «الشك» ليس جديداً؛ فقد طرحه الكثيرون قبله، الفرق هو أن طه حسين ذهب حتى الأقاصي التي أدخلته في سجال ديني لم يكن ذلك همه الأول. ما كان ينقص تجربة طه حسين هو تكوين تيار عقلاني عربي، يجعل مما كان فردياً سؤالاً عاماً يحترق الثقافة العربية التي كان عليها أن تتغير. ولا غرابة إذا قلنا إن الزمن العربي لا يتحرك، وإذا تحرك لا يفعل ذلك إلا لمزيد من التقهقر إلى الوراء. فكل ما يحدث فيه يؤكد ذلك.
لنتخيل معاً مقدار الغرابة التي قد تصل أحياناً إلى أقاصيها التي لا تطاق، وإذا تحملناها فهذا يعني أن شيئاً مهماً فينا قد مات. ننزعج طبعاً عندما نتحدّث عن تخلفنا الصعب، ولكننا نعرف بشكل صارم وجدي أن الخروج منه يقتضي بالضّرورة استنفاراً حقيقياً لكل الوسائل العقلية.
فالتخلف ليس مرتبطاً دائماً بالفقر أو الحاجة بالمعني المادي. الكثير من الأمم الغنية فقيرة في حياتها اليومية، وشعوبها تموت يومياً بالمئات وربما بالآلاف بسبب الإهمال والأمراض والجريمة الموصوفة، مثل الكونغو الغنية بالذهب والخيرات الباطنية، أو نيجريا إحدى أهم الدول النفطية في إفريقيا.
الغنى موجود، لكن المشكلة الكبيرة تتلخص في سؤال الثروة ومآلاتها ومالكيها. وفي المقابل، الكثير من الدول الفقيرة في مواردها، ولا تملك الشيء الكثير منها حتى لسد استهلاكها الضروري اقتصاديا، بل أكثر من ذلك كله؛ عليها أن تقاوم من أجل وجودها على وجه الكرة الأرضية، لأن الطبيعة وضعتها في عمق بحر متلاطم وجغرافية ممزقة على شكل جزر، وزلازل مدمرة واضطرابات طبيعية اضطرت هذه البلدان للتأقلم مع الطبيعة. اليابان مثلاً، التي لا أحد اليوم يشكك في عبقريتها وقدراتها على تخطي كل الصعاب، بما في ذلك جحود الطبيعة وقسوتها مع إمكانات وخيرات طبيعية منعدمة.
الرهان الأكبر كان على الإنسان، أكبر كنز هو ذلك الشخص الذي يفكر في كيفية إنقاذ أرضه وصناعة مستقبل مشرق تجد فيه المرأة والرجل مكانهما الطبيعي في التطور، ويجد العقل مساحات الإبداع والتجلي بعيداً عن كل قيد.