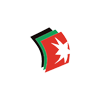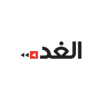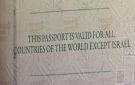اخبار الاردن
موقع كل يوم -جو٢٤
نشر بتاريخ: ٣٠ تموز ٢٠٢٥
د. بني هاني يكتب عن اقتصاديات العقول االمهدورة: إلى كلِ ذي لُب #عاجل
كتب أ. د. عبدالرزاق بني هاني **
أبدأ كلامي بما سميته مفارقة أيثيلبيرغ (The Paradox of Aethelburg)، وهي قصة مستواحة من التراث الإنجليزي، فتحت أمام مُخيلتي سيلاً متدفقاً من الأفكار والتخيلات التي لا نهاية لها، وهي تدور حول زواج فتاة إنجليزية من ملك نورثمبريا (Northumbria)، إدوين (Edwin)، لكن هزيمة الملك إدوين أجبرت أيثيلبيرغ على الهروب، والعودة إلى ما كانت عليه قبل الزواج. وعادة ما يُشبهها المؤرخون الإنجليز بفتاة عاشت في برجٍ عاجي، لكنها حُبسَت، بعد ذلك، في قفص مذهّب. وفي هذا السياق أقدم ما رأيته في خيالي، وعلى أرض الواقع، وما الذي حدث للتعليم العالي في أيثيلبيرغ، وهو بالنسبة لي يُشبه حال الفتاة الجميلة أيثيلبيرغ. واشرح بعد ذلك تداعيات الهبوط من البرج العاجي إلى القفص الذهبي، مع كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. وفي سبيل ذلك اضطررت إلى استبدال أيثيلبيرغ، الفتاة الجميلة، بأثيلبيرغ المدينة، كي تكون المُفارقة واضحة.
حكاية مدينتين:
إن قصة أي مدينة عظيمة هي في جوهرها قصة تطور. أما بالنسبة لمدينة أيثيلبيرغ، فقد كان هذا التطور انحداراً مأساوياً، وحكايةً فيها عبرة عن إمكانات هائلة تم تبديدها. ولكي نفهم أيثيلبيرغ اليوم؛ تلك المدينة التي تختنق بفائضٍ من الشهادات المنزوعة القيمة وخيبات الأمل المهنية، لا بد لنا أولاً أن نتذكر أيثيلبيرغ الأمس. فمنذ زمن ليس بالبعيد، كان اسم أيثيلبيرغ يُذكر بكل إجلال في الأوساط الأكاديمية العالمية، إذ كانت منارة للفكر الدقيق، وجاذبة لألمع العقول في العالم، ومحركاً للابتكار في أمتها. لقد كانت منظومتها للتعليم العالي، التي ترتكز على جامعة أيثيلبيرغ العريقة، والتي يشار إليها غالباً باسم الجامعة القديمة، جوهرة تاجها وحجر الزاوية في ميزتها التنافسية.
وقد استكشفت هذه الكارثة بعدما غادرت مدينة مدينة فيريديا، حيث لاحظت ما أسميته كارثة الطب والقانون، والانحدار في هاتين المهنتين. أما في أيثيلبيرغ فقد لاحظت بأن المأزق الذي تعيشه هذه المدينة هو نتيجة مباشرة لعاصفة هوجاء تلاقت فيها عدة عوامل: هوس مجتمعي بالشهادات الرسمية، والتسليع المنهجي للتعليم على أيدي جهات غير مؤهلة، وتفشي الفساد والمحسوبية داخل المؤسسات الجديدة، وفشل ذريع في الرقابة التنظيمية. وهنا انسكبت دموعي عندما تيقنت، بحكم خبرتي، بأن نزول أيثيلبيرغ من برج عاجي للعلم الحقيقي إلى قفص مُذهب من المؤهلات الفارغة هو بمثابة إنذار شديد لأي مجتمع يُقدّر رموز المعرفة على حساب جوهرها.
العصر الذهبي: إرث من التميّز:
لأكثر من نصف قرن من الزمان، كان اسم أيثيلبيرغ مُرادفاً للتعليم العالي النخبوي. وكانت الجامعة القديمة، بحرمها المترامي الأطراف الذي تكسوه نباتات اللبلاب، القلب الفكري النابض للمدينة. كانت عملية القبول فيها انتقائية إلى أبعد الحدود، ومناهجها الدراسية صارمة، وهيئة تدريسها مكونة من كبار العلماء والباحثين. كان خريجو الجامعة القديمة، والجامعة التي نشأت بعدها، مطلوبين بشدة من قبل كبرى الشركات والمؤسسات البحثية والحكومات في جميع أنحاء العالم. وقد أنتجت كلية الطب فيها جراحين وباحثين رواداً، في حين صممت كلية الهندسة فيها البنية التحتية الحيوية للمدينة.
وقد ازدهرت المنظومة الحيوية للمدينة بفضل هذا الرصيد الفكري. فقد كانت أيثيلبيرغ موطناً للعديد من مختبرات البحث والتطوير، والشركات التقنية الناشئة، وشركات التصنيع التي تعاونت بشكل وثيق مع الجامعة. وكان البحث العلمي يحظى بتمويل سخي، مدفوعاً بسعي حقيقي نحو الاكتشاف والابتكار. وكانت حكومة المدينة، إدراكاً منها لقيمة الجامعة، تحمي استقلاليتها وتضمن تخصيص التمويل على أساس الجدارة وقيمة المشاريع. فسادت في أيثيلبيرغ ثقافة من الثقة الفكرية الهادئة؛ فلم تكن الشهادة من الجامعة القديمة مجرد ورقة، بل كانت دليلاً على اجتياز اختبار عسير، وشهادة على الصلابة الفكرية لصاحبها وإتقانه لمجال تخصصه. كانت هذه السمعة أثمن أصول المدينة، حيث استقطبت الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الدوليين الذين أثروا حياتها الفكرية النابضة بالحياة. كانت تلك هي أيثيلبيرغ التي عرفها العالم، مدينة تخلق القيمة من خلال المعرفة.
بذور الانحدار: صعود مصانع الوجاهة:
يُمكن إرجاع بداية انهيار أيثيلبيرغ إلى فترة من التحرر الاقتصادي المتسارع ورفع القيود التنظيمية، بتخطيطٍ دقيق من شخص كان أهل المدينة يسمونه المُهرج المُبتسم (The Smiling Clown) . وبدافع من أيديولوجية سياسية شعبوية تروج لشعار التعليم للجميع، قامت الحكومات المتعاقبة للمدينة بتخفيف متطلبات إنشاء الجامعات الخاصة بشكل جذري. كان القصد، النبيل ظاهرياً، هو زيادة فرص الحصول على التعليم العالي لجيل الشباب المتنامي. لكن النتيجة كانت أشبه بحمى الذهب (Gold Rush)، الذي ساد في ولاية كاليفورنيا، خلال منتصف القرن التاسع عشر. فقد فُتحت البوابات ليس للأكاديميين الموقرين الذين يسعون لبناء مراكز علمية جديدة، بل لرواد الأعمال الانتهازيين الذين رأوا في التعليم الجبهة التالية لتحقيق الأرباح الطائلة.
هنا تجذّر أول عنصر من عناصر التآكل التي وصفتها بعبارة قاسية: وهي أفرادٌ جاهلون يؤسسون جامعات كمصدر للوجاهة الاجتماعية والدخل المرتفع. رجالٌ جمعوا ثرواتهم من تجارات لا علاقة لها بالعلم، وغالباً ما تكون متواضعة، كتجارة التجزئة، أو الاستيراد والتصدير، وفي إحدى الحالات المشينة، توزيع التبغ والحلويات، وجدوا أنفسهم فجأة يحملون لقب مالك لجامعة، لكنه رئيس فعلي للجامعة. وبسبب افتقارهم لأي خلفية تربوية أو رؤية أكاديمية، كانت مؤهلاتهم الوحيدة هي رأس المال والطموح. ولنتأمل النموذج الأصلي لهذا المؤسس الجديد: شخصية مثل السيد تاجريان، وهو أحد أقطاب تجارة البقالة سابقاً والذي أسس جامعة أيثيلبيرغ الدولية للأعمال والتكنولوجيا. كان دافعه مزدوجاً؛ أولاً، الوجاهة الاجتماعية الهائلة التي تأتي مع لقب مالك جامعة ورئيس جامعة من وراء الستار، وهو لقب يمحو الأصول المتواضعة لثروته. ثانياً، والأهم من ذلك، هو الإمكانات الربحية المذهلة.
هذه المؤسسات الجديدة، التي أطلق عليها السكان المحليون بسخرية اسم مصانع الوجاهة، بُنيت على نموذج عمل يتعارض تماماً مع نموذج الجامعة القديمة:
1.التسويق قبل الجدارة: استثمروا بكثافة في بناء أحرام جامعية حديثة وبراقة بواجهات زجاجية مذهلة، لكن بمكتبات شبه خاوية. كانت موادهم التسويقية تعِد بتعليم عالمي ونجاح وظيفي مضمون، مستخدمين صوراً نمطية لطلاب مبتسمين من خلفيات متنوعة.
2.معايير قبول متساهلة: لتحقيق أقصى عدد من المسجلين، وبالتالي الرسوم الدراسية، كانت معايير القبول شبه منعدمة. لقد أصبح امتلاك دفتر شيكات والقدرة على التنفس هما الشرطان الأساسيان للالتحاق.
3.دافع الربح هو العقيدة الأساسية: كان كل قرار يتم اتخاذه يُنظر إليه من منظور الربحية. فقد تم إنشاء الأقسام ليس بناءً على الحاجة الأكاديمية أو متطلبات المجتمع، ولكن بناءً على أي الدرجات العلمية أقل تكلفة في تقديمها ويمكنها جذب أكبر عدد من الطلاب. فتم إهمال العلوم الإنسانية والعلوم النظرية لصالح إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الدرجات العملية التي تتطلب حداً أدنى من الاستثمار في المختبرات أو المعدات المتخصصة.
لم يكن لهذا السوق الجديد أن يزدهر لولا شرط سادس، وهو سكان مدينة يعشقون الشهادات الجامعية لمجرد التباهي. ففي مجتمع أيثيلبيرغ، أصبحت الشهادة الجامعية هي الرمز الأسمى للمكانة الاجتماعية. وبالنسبة للعديد من العائلات، كان حصول أحد الأبناء على لقب مهندس أو دكتور مسألة فخر اجتماعي، بغض النظر عن جودة المؤسسة أو معرفة الخريج. وهذا الهوس الثقافي خلق طلباً شرهاً وغير حساس للسعر على الشهادات، وكانت مصانع الوجاهة أكثر من سعيدة بتلبية هذا الطلب بكميات هائلة، مما خلق فقاعة من المؤهلات الجوفاء.
تفريغ الأوساط الأكاديمية من جوهرها: فساد ومحسوبية ومهزلة:
بمجرد تأسيسها، أصبحت العمليات الداخلية لهذه الجامعات الجديدة مسرحاً للفساد وسوء الإدارة، وهو ما يعكس بشكل مباشر دوافع مؤسسيها. لم تكن المهمة الأكاديمية ثانوية فحسب، بل كانت غائبة تماماً. وقد تجلى هذا التآكل الداخلي في عدة مظاهر، من الاحتيال المالي إلى الانهيار الكامل للكفاءة الإدارية.
البحث العلمي كصندوق مالي شخصي:
في إشارة ساخرة إلى الوظائف التقليدية للجامعة، أنشأت مصانع الوجاهة جميعها عمادات أو مكاتب للبحث العلمي. وفي المؤسسات الشرعية، يتولى مثل هذا المكتب إدارة المنح البحثية، والإشراف على المراجعات الأخلاقية، وتعزيز ثقافة البحث والاستقصاء. أما في جامعات أيثيلبيرغ الجديدة، فقد أصبحت هذه الميزانية صندوقاً مالياً شخصياً تحت تصرف المالكين وعائلاتهم. فكانت نفقات البحث ذريعة واهية للترف والبذخ. يوافق رئيس الجامعة، ومجلس إدارة المؤسسين للجامعة، على ميزانيات ضخمة للتعاون الأكاديمي الدولي، والذي كان يتجلى في شكل رحلات على الدرجة الأولى إلى مؤتمرات في وجهات استجمامية كبالي أو جبال الألب السويسرية. وكانت الحصيلة الأكاديمية لهذه الرحلات صفراً. لم تُنشر أي أوراق بحثية، ولم تُعقد أي شراكات ذات معنى. وكانت الأموال التي كان من الممكن أن تُستخدم لتوظيف أعضاء هيئة تدريس مؤهلين أو بناء مختبرات حديثة تُنفق بدلاً من ذلك على فنادق الخمس نجوم والجولات السياحية، كل ذلك تحت راية تقدم العلوم الزائفة.
ذروة المحسوبية: رئيس الجامعة غير المؤهل:
كان الرمز الأكثر وضوحاً لهذا الانحطاط الأكاديمي هو تعيين رؤساء الجامعات. في الجامعة التقليدية، يكون الرئيس باحثاً مرموقاً يتمتع بخبرة أكاديمية وإدارية واسعة. أما في مصانع الوجاهة في أيثيلبيرغ، فقد يأتي الرئيس من أي خلفية كانت، شريطة أن يكون موالياً للمالك وألا يتدخل في المشروع الربحي.
وفي بعض الحالات التي لاحظتها في أثيلبيرغ تم تقليص دور الرئيس ليصبح مجرد شخصية رمزية وواجهة للعلاقات العامة. كان المالكون يعينون أفراداً يضفون جواً من الهيبة أو يمتلكون نفوذاً سياسياً، دون أي اعتبار للمؤهلات الأكاديمية. كان من الشائع رؤية خبير آلات الطحين، متقاعد يحمل شهادة دكتوراة من جامعة فيريديا، أو مسؤول سابق ليس له أي منشورات أكاديمية جدية، أو سياسي مُحنك يحمل شهادات دكتوراة، يتم تنصيبه رئيساً لـجامعة علوم الذرة والفضاء. هؤلاء الأفراد لم يكونوا يمتلكون أي فهم لتطوير المناهج، أو حوكمة هيئة التدريس، أو مبادئ الحرية الأكاديمية. كانت وظائفهم الأساسية هي حضور الاحتفالات، واستغلال علاقاتهم السياسية لدرء الرقابة التنظيمية، وتوفير قشرة من الاحترام للمؤسسة. وقد بَعَثت هذه الممارسة برسالة واضحة لجميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب تقول بأن القيادة الأكاديمية لا قيمة لها هنا.
المحاباة كسياسة مؤسسية:
امتدت ممارسة تعيين الشخصيات غير المؤهلة من منصب الرئاسة إلى الأسفل لتشمل الهيكل الجامعي بأكمله. لم يكن نموذج الحوكمة أكاديمياً، بل كان إقطاعياً. وكما أشرت، وظّف المالكون في أيثيلبيرغ أفراد عائلاتهم في مناصب رئيسية، بغض النظر عن مؤهلاتهم. فقد يتم تعيين ابن المؤسس، خريج إدارة الأعمال من نفس المؤسسة المتدنية الجودة، عميداً لكلية الهندسة. ويمكن وضع ابنته، الحاصلة على شهادة في تصميم الأزياء، مسؤولة عن الشؤون المالية أو المشتريات بالجامعة. وقد يصبح أحد أبناء العمومة رئيساً لشؤون الطلاب، وصهرٌ له مديراً للموارد البشرية. والكارثة بأن هذه العدوى قد انتقلت إلى جامعات إثيلبيرغ الرسمية، من غير استثناء. فوزير التعليم العالي في مدينة إثيلبيرغ يتخبط في قمقمه، ولم يتمكن من إصلاح الأوضاع لأنه ضعيف ومغرور، وليس له مصلحة في وقف الحريق والخراب الذي أحدثه أعداء إثيلبيرغ. وقد كانت العواقب فورية وكارثية؛ بقيت المناهج قديمة، وأُسيئت إدارة القرارات المالية، وأصبحت عملية التوظيف مهزلة. وهذه المحسوبية المنهجية، التي توّجها تعيين رئيس غير مؤهل، دمرت أي مظهر من مظاهر بيئة قائمة على الجدارة، ما ضمن أن مؤسسات التعليم العالي لن ترتقي أبداً فوق مستوى الرداءة الذي فرضته قيادتها.
التداعيات الاجتماعية والاقتصادية: فيض من الشهادات، وشحّ في المهارات:
كانت النتيجة الحتمية لإنتاج عشرات الآلاف من الخريجين من مصانع الوجاهة هذه عاماً بعد عام هي التشبع الكامل لسوق العمل المهني والانخفاض الكارثي في قيمة الشهادات الجامعية. وتحولت مدينة أيثيلبيرغ، التي كانت يوماً ما مركزاً للخبرات، إلى دراسة حالة في مفارقة التعليم المفرط والمهارات المتدنية. ويتجلى هذا الواقع بأوضح صوره في مجالي الطب والهندسة.
معضلة الأطباء: من معالجين إلى باعة متجولين:
يحمل لقب طبيب مكانة مرموقة للغاية في ثقافة أيثيلبيرغ. وإدراكاً منها لذلك، سارعت الجامعات، بخاصةٍ جامعات حكومة المدينة، إلى افتتاح كليات للطب. وقد تجاوزت هذه الكليات المعايير الصارمة لبرنامج الطب في الجامعة القديمة، وقدمت القبول لمجموعة أوسع بكثير من المتقدمين، وكثيراً ما اختصرت متطلبات التدريب السريري المكلف. وكانت النتيجة فرطاً هائلاً في إنتاج خريجي الطب.
كما لاحظت بكل حزن وقلق بأن عدد الأطباء أصبح كبيراً لدرجة أنهم بدأوا في الإعلان عن عياداتهم عبر نشرات إعلانية، وكأنهم يبيعون الخضراوات. وهذه الظاهرة هي رمز قوي للانحطاط المهني. ففي سوق العمل السليم، تُبنى سمعة الطبيب على مر السنين من خلال نتائج علاج المرضى، واحترام الأقران، والتميز السريري. أما في سوق أيثيلبيرغ المشبع، فقد اضطر الأطباء حديثو التخرج، غير القادرين على تأمين برامج إقامة تنافسية أو إيجاد وظائف في المستشفيات القائمة، إلى اتخاذ تدابير يائسة.
فتحوا عيادات صغيرة، غالباً ما تكون سيئة التجهيز، في أحياء مكتظة، وتنافسوا بشراسة على مجموعة محدودة من المرضى. أصبحت النشرة الإعلانية التي توضع تحت مساحات زجاج السيارات أو توزع في الأسواق أداتهم التسويقية الرئيسية، معلنة عن فحوصات طبية مقابل 10 قروش، أو خصومات على صحة الأسرة. لم يقتصر الأمر على الحط من مكانة مهنة الطب بأكملها، بل شكل أيضاً خطراً كبيراً على الصحة العامة. فهل كان هؤلاء الأطباء، نتاج نظام أعطى الأولوية للربح على رعاية المرضى، أكفاء حقاً؟ لقد غمرت المدينة الأطباء، لكن جودة الرعاية الصحية كانت في تدهور واضح.
مأزق المهندسين: من بناة للوطن إلى سائقي سيارات أجرة:
وقعت مأساة مماثلة في مجال الهندسة. كانت شهادات الهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية من بين المنتجات الأكثر شعبية التي تبيعها مصانع الوجاهة. بدت هذه الشهادات مرموقة وألمحت إلى مستقبل مهني مستقر ومجزٍ. ولسنوات، أنتجت أيثيلبيرغ مهندسين بمعدل فاق بكثير قدرة الاقتصاد على استيعابهم. وكانت النتيجة أن عدد هائل من المهندسين في جميع التخصصات يعملون كسائقي سيارات أجرة. وهذه ليست مجرد حكاية عابرة؛ إنها سمة نظامية لاقتصاد أيثيلبيرغ. فغالباً ما تكون رحلة في سيارة أجرة بمثابة محادثة مع رجل يحمل درجة الماجستير في الهندسة الإنشائية ولا يستطيع العثور على عمل في مجاله. لقد أمضى هؤلاء الأفراد سنوات من حياتهم ومدخرات عائلاتهم للحصول على شهادة ثبت أنها لا قيمة لها في سوق العمل. ويمثل هذا هدراً مذهلاً للطاقات البشرية والموارد الاقتصادية. فالمدينة لديها فائض من الأشخاص المدربين على تصميم جسور لن يبنوها أبداً وشبكات كهرباء لن يديروها أبداً. إنهم يمتلكون شهادات في العلون الهندسية المُتعددة، لكنهم غالباً ما يفتقرون إلى المهارات العملية ومهارات حل المشكلات التي كان من الممكن أن يوفرها لهم تعليم صارم. ومحنتهم هذه هي تذكير يومي ومرئي بوعد المدينة الكاذب: أن الشهادة الجامعية هي تذكرة لحياة أفضل. ففي أيثيلبيرغ، أصبحت لآلاف الأشخاص تذكرة للعمل في أسطول سيارات الأجرة.
حكاية فيها عبرة لعالم مهووس بالشهادات:
إن قصة أيثيلبيرغ هي مأساة تشكلت من خمسة فصول. بدأت بإرث نبيل من التميز الأكاديمي تم تفكيكه بشكل منهجي بسبب الجشع والغرور والتباهي المجتمعي. والعلة الأساسية التي تعاني منها المدينة هي فصل الشهادة عن الكفاءة. العشق الثقافي للشهادة كرمز للمكانة خلق السوق. وقام رواد الأعمال الانتهازيون والجهلة، بتمكين من التنظيمات المتراخية، بإغراق السوق بمنتج متدني الجودة. أما المؤسسات التي بنوها فقد أُفرغت من جوهرها بسبب الإدارة غير المؤهلة، والمحسوبية، والفساد؛ حيث عومل البحث العلمي كصندوق لتمويل الإجازات، وتعيين رؤساء صوريين، وأفراد من العائلة بدلاً من الأكاديميين المؤهلين.
أما الفصل الأخير في هذه المأساة هو الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المدينة الآن. أيثيلبيرغ غارقة في فيض من الشهادات منزوعة القيمة. شوارعها مليئة بالأطباء الذين يتنافسون كالباعة المتجولين، والمهندسين الذين يقودون سيارات الأجرة. لقد خُدِعَ جيلٌ بأكمله، استثمر آماله وثرواته في نظام لم يُصمم لتعليمه، بل للتربح من طموحاته. وتعاني المدينة من فجوة عميقة في المهارات؛ لديها وفرة من حاملي الشهادات ولكنها تعاني من نقص في المهنيين المهرة والأكفاء القادرين على الابتكار وبناء اقتصاد تنافسي.
والسؤال المهم هو: هل يمكن إنقاذ أيثيلبيرغ؟ والإجابة هي إن طريق التعافي سيكون شاقاً ومحفوفاً بالمخاطر السياسية. وسيتطلب ذلك:
- إصلاحات تنظيمية جذرية: التنفيذ الفوري لهيئة اعتماد قوية ومستقلة تتمتع بصلاحية إغلاق المؤسسات الفاشلة. ويجب على هذه الهيئة تقييم الجامعات بناءً على نتائج ملموسة، مثل معدلات توظيف الخريجين في مجال دراستهم، والنتاج البحثي، ومؤهلات قيادتها وأعضاء هيئة تدريسها.
- تحول ثقافي: إعادة تقييم مجتمعية لمعنى النجاح. وهذا يشمل تعزيز التدريب المهني والتقني كمسارات وظيفية محترمة وقيمة، وتوعية أصحاب العمل للتوظيف بناءً على المهارات المثبتة بدلاً من وجاهة قطعة من الورق.
- المساءلة والمحاسبة: اتخاذ إجراءات قانونية ضد مالكي الجامعات الذين ثبت أنهم أساءوا استخدام الأموال وانخرطوا في ممارسات احتيالية.
بدون هذه التغييرات الجذرية، فإن مستقبل أيثيلبيرغ قاتم. ستظل حبيسة في قفصها المذهب، مدينة ضحت بروحها الفكرية من أجل مظهر من مظاهر التقدم. فقصتها هي مثابة تحذير قوي وعاجل: عندما يسمح مجتمع ما بأن يصبح التعليم سلعة، فإنه يبيع مستقبله لمن يدفع أعلى سعر، والثمن الذي يدفعه هو طاقات أبنائه وإمكاناتهم. تقف أيثيلبيرغ اليوم كنصب تذكاري شاهد على التكلفة الباهظة للمعايير المتدنية.
** إهداء إلى المفكر الكبير أ.د. عبدالحكيم الحُسبان