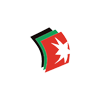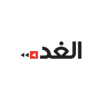اخبار الاردن
موقع كل يوم -صحيفة السوسنة الأردنية
نشر بتاريخ: ١٧ تموز ٢٠٢٥
أنشرُ كتاباتي الأدبية في الصحف منذ 50 عاماً، وكتبي منذ 45 عاماً، أما بداية الكتابة فهي منذ 60 عاماً تقريباً. لم أتوقف عن الكتابة قط منذ الصف التاسع، أي منذ الخامسة عشرة من عمري، زمن طويل يمكن أن يتحدث فيه المرء عن تفاصيل كثيرة اعترضت طريقه، جرى تناول بعضها في «السِّيرة الطائرة» وفي «طفولتي حتى الآن»، وفي حوارات الصحف والمجلات والمحاضرات في أماكن كثيرة، ولعل هذه الهموم الكتابية تسرَّبت أحياناً إلى الروايات، كما لو أنها آراء الشخصيات، وهذا أمر يحدث معنا جميعاً كتاباً، كما تتسرب أجزاء من سِيَرنا الذاتية إلى نصوصنا، اعتمادًا على قاعدة:
في الكتابة نعترف وتظلّ أسرارنا لنا!
لكن المرء خلال هذه المسيرة الحلوة -المرّة، يجد نفسه مع وجوه أخرى وتحديات لا تنتهي، فدائماً هناك الخوف أمام البداية، بداية الكتابة، كما لو أنه لا يملك تجربة، لا كتابية ولا حياتية.
ستظل الكتابة مُفزعة.
لكن الفزع موجود خارجها أيضاً، ويحدّق إلينا بعينين قادرتين على ابتلاعنا ونحن نعبر هذا الطريق الطويل الذي لم يُخطط الإنسان أن يسير فيه، ليكون كاتبًا، فكل ما حدث أنه وجد نفسه كاتباً، وانتبه بعد فوات الوقت، فواصل الكتابة بحاجةِ الروح إليها، هو الذي لا يكف عن المراوغة والتأجيل على أمل الإفلات منها.
بعض أشكال الفزع يتعلق بالآخرين، وبعضها يتعلق بالذات الكاتبة، وبينهما يجد الإنسان، حقّاً، نفسه محاصرًا، بل ومرتبكاً بين ما يراه لا وعيه، وما يشير له وعيه أن يلتزم به وهو يدعوه أن يطيع عقله متخلياً عن هواجس قلبه، مع أننا يمكن أن نعتبر هواجس القلب أفكاراً للقلب، وقد تكون أكثر وعياً من عقلٍ كل ما حوله يعمل على تشويشه، بل واحتلاله، ليس بقوة غاشمة فحسب، بل بقوة الثقة بأناس تحبهم وتعتبر أن عقولهم لا غبار عليها؛ فهم يعرفون أكثر منك، لأنهم أكبر منك، استناداً للمثل الشعبي، وهم وطنيون مخلصون أيضاً.
كتبت روايتي الأولى «براري الحُمّى» حينما كنت مشغولاً بكتابة قصائد ديواني الشعري الأول، لكن ما حدث أن الديوان نُشر قبلها، وقوبل بمحبة نادرة، في زمن كان للصحف الورقية فيه حضورها، وللنقاد مساحات وفيرة للنشر، وكان الشعراء والروائيون أقل عدداً من النقاد بكثير، ليس مثل اليوم. تأخر صدور الرواية التي أنهاها ابن السادسة والعشرين، عام 1980، لكن نجاح الديوان ساهم في تأخير نشرها.
حملتُها ذات يوم، وهذا أول الفزع، إلى شخصية أدبية أثق بها وأحترمها وطنيّاً، وانتظرت رأيه فيها على أحر من جمر الحُمَّى التي كابدت أهوالها، حمّى الملاريا أثناء عملي مدرِّساً في الصحراء السعودية.
بعد أسبوع قابلته، فلمحت مخطوط روايتي في يده، صافحني بودٍّ أقلّ من المعتاد فأدركت أنني خيّبت ظنّه فيّ، وحين سألته عن رأيه، رفع يده ثم هوى بالمخطوط على سطح الطاولة أمامه، وقال بصوت مرتفع: هذا أدب أسود، عليك أن تحرقها فورًا، أن تحرقها أنت بيديك، مع أنني فكرت أن أفعل ذلك ورأيت أنك أنت الذي عليك القيام بهذا.
أرعبتني فكرة حرق الرواية، وقد كنت قرأت عن حرق الكُتب هنا وهناك، قديماً وحديثاً.
خرجت من مبنى رابطة الكتاب الأردنيين وأنا أشعر بأنني السبب المباشر في هزيمة حزيران 1967، التي كانت نتيجتها ضياع ما تبقى من فلسطين وفوقها الجولان وسيناء وقبلها كرامتنا التي تلطخت بأنتن الوحول.
بعد يومين، أحسست بأن عقل قلبي يقول لي لا تيأس، فحملت الرواية إلى الناقد الدكتور كمال أبو ديب، أحد أهم منظِّري الحداثة العربية، الذي كان يدرِّس في جامعة اليرموك، وكنت التقيته في أمسية شعرية كتبَ فيها بمحبة عن قصيدتي التي قرأتها خلالها.
لم يُبْدِ الكثير من الحماسة لقراءة الرواية، مع أنه أبدى الكثير من المحبة، بدماثته ولطفه النادرين، وهما صفتان لم يتخلَّ عنهما قط في كل مكان التقينا فيه على مدى عشرات السنوات.
بعد يومين اتصل بي في عمّان وقال، أريدك الآن. قُدْتُ سيارتي الصغيرة وانطلقت إلى مدينة إربد وكلي رعب من أن مشهد الرابطة سيتكرر.
لم يحدث هذا قط لحسن الحظ، (لن أكتب عن حجم محبته للرواية التي فاجأته، فقد كتب مقدمة طبعتها الأولى التي أعتبرها من أجمل ما كتب عن هذه الرواية).
بعد ستة عشر عاماً، كتبتُ رواية مختلفة تمامًا عن روايتي الأولى، اسمها «حارس المدينة الضائعة» وتدور أحداثها في يوم واحد، حيث يختفي كل سكان عمان، ولا يبقى فيها غير مُدقِّق لغوي في إحدى الصحف، لا شيء يفرحه في وظيفته مثل اسمها لأنه على وزن كلمة مُحقق!
لم تكن معركة هذه الرواية مع من هم خارجها، بل معي أولاً، فكيف ستكون مقنِعَة و»تنطلي» فكرتها على قرائها من سكان عمان بشكل خاص، وحين أصبحت على يقين بشأن اختفاء سكانها، ويقين (بطلها) باختفاء سكان عواصم عربية أخرى وسكان عواصم عالمية أيضًا، سارت الرواية نحو نهاياتها بيسر.
في صبيحة اليوم التالي للاختفاء، ينهض المدقق اللغوي للذهاب إلى عمله (كالمعتاد)، فيجد أمامه أطول طابور رآه في حياته، فيأخذ مكانه فيه. أمامه وخلفه رجال ونساء وشباب وعجائز وأطفال، وعمال ووزراء وموظفون مسحوقون، وباعة خضار وطلبة وأساتذة ووو… وكما في كثير من الأماكن، يتجاوز بعضهم من أمامه ليكون في المقدمة.
قبل أن يصل إلى بوابة المبنى الغامض الذي لم يره من قبل، يكتشف أن على كلّ شخص أن يتلقى صفعة قبل أن يخرج من الباب الخلفي قاصدًا عمله أو مدرسته أو جامعته، أو…
لم يكن عقلي راضياً عن هذا، وقد رأى فيه قسوة بالغة في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، لكن قلبي المشاغب أصرّ على التمسك بما يحسه، وانتصر في النهاية، لكن عقلي كان يطل بين لحظة وأخرى، وعلى مدى سنوات، ويقول لي: لقد كنت قاسياً ومتشائماً للغاية يا إبراهيم، إلى أن وصلنا إلى هذه الإبادة، فتغيّر الأمر!
وبعــــد:
اليوم، حين أرى صمت شوارعنا العربية وصمت جامعاتنا وبيوتنا وعقولنا وقلوبنا وأرواحنا، وكرامتنا إن كانت موجودة، وصمت إنسانيتنا وإيماننا إن كانا حقَّا موجودين، وصمت الكثير جداً من مثقفينا وفنانينا، وأرى مدناً وقرى وعواصم كثيرة في هذا العالم ترفض الوقوف في الطابور لتتلقى الصفعة رافضة ما يحدث في غزة من إبادة، أعتذر لهذه المدن وهؤلاء البشر، إن كان في الرواية ما يشير إلى طوابير عندهم (مثل طوابيرنا)، رغم أن الرواية لم تُشر، وأقول إن هذه الرواية كانت تتحدث عن عواصم العرب وعواصم المسلمين، إلا مَن مَلك قلبًا وكرامةً فيها.