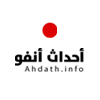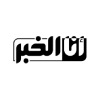اخبار المغرب
موقع كل يوم -اندبندنت عربية
نشر بتاريخ: ٧ تشرين الأول ٢٠٢٥
الوضع مغاير حالياً بسبب اختلاف تكوين 'جيل زد' في تكوينه عن الأجيال التي سبقته
يشهد المغرب حالياً تظاهرات 'جيل زد' التي اندلعت احتجاجاً على تردي الخدمات في مجالي الصحة والتعليم، إلى أن تطورت مطالبهم إلى القضاء على الفساد وإقالة الحكومة، وهي جانب من دعوات الإصلاح التي اعتمدتها تظاهرات 'حركة 20 فبراير'، المنبثقة عن موجة 'الربيع العربي' خلال عام 2011، والتي تشكل بدورها جانباً من مطالب التظاهرات التي اندلعت منذ ستينيات القرن الماضي، فما هي أوجه التشابه والاختلاف بين الاحتجاجات التي شهدها المغرب خلال تاريخه الحديث.
شكل تردي الأوضاع الاجتماعية أساس اندلاع التظاهرات داخل المغرب منذ فترة ما بعد الاستقلال، وأسهمت بعض السياسات العامة في تزايد نسب الفقر وارتفاع حجم الدين العام، في حين كان الطلبة وراء الشرارة الأولى لاندلاع تلك الاحتجاجات.
انطلق مسلسل الاحتجاجات الشعبية داخل المغرب منذ ستينيات القرن الماضي، إذ عمل الملك الراحل الحسن الثاني إثر توليه مقاليد الحكم خلال عام 1962 على تقوية وتثبيت نظامه، عقب الاستقلال عام 1965، حين شهدت البلاد تجاذباً على السلطة مع جانب من 'الحركة الوطنية' (منبثقة عن حركات التحرر ضد الاستعمار الإسباني والفرنسي في بداية القرن الـ20، وكانت النواة الأساس لتشكيل أول الأحزاب في المغرب)، إذ كان يدعو جانب منها إلى قلب نظام الحكم. ومن ثم اعتمدت السلطة القائمة على القمع والتضييق على الحريات، إلى أن اندلعت تظاهرات مارس (آذار) 1965، رداً على قرار وزير التعليم الصادر خلال الـ19 من فبراير (شباط) من العام ذاته، والذي منع التلاميذ في سن الـ17 من الالتحاق بمستوى السلك الثاني من التعليم الثانوي. وانطلقت الاحتجاجات من الثانويات، ثم التحق بها جانب من المواطنين، معلنين امتعاضهم من التوجه المعتمَد في تدبير السياسات العامة للبلد. ومع توسع دائرة الاحتجاج استُدعي الجيش الذي استخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل المئات واعتقال آلاف المتظاهرين.
إثر قرار الزيادة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساس من طرف الحكومة خلال الـ28 مايو (أيار) 1981، قامت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل (نقابة عمالية) بإعلان إضراب عام خلال الـ20 من يونيو (حزيران) من العام ذاته، احتجاجاً على القرار. وإثر نجاح الخطوة العمالية وخصوصاً بمدينة الدار البيضاء (العاصمة الاقتصادية للبلاد)، توجهت قوات الأمن والجيش لمحاولة إفشال الإضراب. ونتج من المناوشات بين القوات الحكومية والمحتجين سقوط عدد من الضحايا، وأعلنت وزارة الداخلية سقوط 66 قتيلاً، و110 جرحى من بينهم 73 من رجال الأمن و37 من المتظاهرين. ومن جانبها، قدرت 'منظمة العفو الدولية' أن عدد الضحايا تجاوز الألف شخص، فيما أسفرت تحريات 'هيئة الإنصاف والمصالحة' عن الوصول إلى رفات بعض هؤلاء ممن كانوا دُفنوا داخل مقابر جماعية سرية.
وكان وزير الداخلية، حينها، إدريس البصري استهزأ من مطالب المحتجين المرتبطة بالمواد الاستهلاكية الأساس مثل الخبز، واصفاً قتلى تلك التظاهرات بـ'شهداء الكوميرا' (نوع من الخبز الفرنسي المنتشر في المغرب).
تبنت المملكة المغربية في بداية ثمانينيات القرن الماضي سياسة التقويم الهيكلي بإيعاز من البنك الدولي، والتي فرضت عليها انتهاج سياسة تقشفية نتج منها ارتفاع كبير في بعض المواد الاستهلاكية، ومع بلوغ مظاهر القمع أوجها خلال تلك المرحلة، شهد المغرب موجة وعي ثقافي، كانت عاملاً أساساً في تأطير تظاهرات يناير (كانون الثاني) 1984، وكالعادة انطلقت شرارة الاحتجاجات من الثانويات، إلى أن انضم إليها جانب من المواطنين الذين سئموا من زيادة نسبة الفقر في صفوفهم.
وبحسب دراسة نشرتها 'جماعة العدل والإحسان' (الإسلامية المحظورة) خلال وقت سابق، فإن 'عدد السكان قدر حينها بنحو 21 مليون نسمة، منهم 3 ملايين و300 ألف نسمة (16 في المئة) يعيشون في المدن، والباقون أي 17 مليوناً و700 ألف نسمة (84 في المئة) يعيشون في البوادي، حيث لا يتوافر لديهم الحد الأدنى من الخدمات الصحية والتعليمية، فيما النسبة الباقية الموجودة في المدن فغارقة في البطالة، إذ سجل آنذاك 120 ألف طالب جامعي باحث عن العمل. ومن ضمن هذا العدد الإجمالي للسكان فإن 9 ملايين و400 ألف نسمة (45 في المئة) يعيشون في فقر مدقع، فيما مليونان من المغاربة يعيشون في دور الصفيح.
وتضيف الدراسة أن 'المديونية الخارجية تجاوزت في حينه 15 مليار دولار، ووصل عجز الميزان التجاري إلى 11 مليار دولار، واتسمت المرحلة بتجميد ما سمي آنذاك بمشاريع الخطة الخماسية، وانطلاق مسلسل التفويت لمرافق القطاع الخاص، والإجهاز على الخدمات الأساس للشعب المغربي في التعليم والصحة والشغل بما يعنيه من تقليص الاعتمادات المخصصة لهذه القطاعات الحيوية'، إضافة إلى 'حذف مناصب الشغل في القطاع العمومي وشبه العمومي، والتسريح الجماعي للعمال وإغلاق المعامل وتشريد الفلاحين، وطرد آلاف الطلبة والتلاميذ، وإثقال كاهل الشعب بالضرائب المباشرة وغير المباشرة وزيادة أسعار المواد الأساس'. وشهدت تلك التظاهرات، التي اندلعت بالأساس في بعض مدن الشمال المغربي إضافة إلى مدينتي مراكش ووجدة، تدخلاً أمنياً وعمليات إطلاق نار.
إذا كان الخيط الرابط بين مختلف الاحتجاجات التي شهدها المغرب يتمثل في الاحتقان المرتبط بالوضع الاجتماعي الذي يشهد تراجعاً خلال مراحل معينة، فإن مظاهر تلك الاحتجاجات اختلفت بحسب الظرفية، وفق ما يشير إليه الباحث السياسي المغربي عصام لعروسي، معتبراً أن 'الاحتجاجات في المغرب شهدت تموجات كثيرة، ويجب التمييز ما بين الاحتجاج والتمرد والثورة'، موضحاً أن طبيعة تلك الاحتجاجات اختلفت من مرحلة إلى أخرى ووصل بعضها إلى مستوى التمرد، وحتمت المعالجة الظرفية السياسية التدخل الأمني لحماية أركان الدولة، والحيلولة دون الانزلاق نحو الفوضى والاضطراب'.
من جانب آخر، تبنت تلك الاحتجاجات خلفية فكرية أسهمت في التأثير في توجهاتها، بالتالي تحديد سقف المطالب. ويرى لعروسي أن 'تلك التجارب النضالية عرفت حضوراً مكثفاً للجانب الأيديولوجي، باعتبار أنها كانت مؤطرة من طرف تيارات معينة'، لافتاً إلى أن 'أكثر التوجهات الفكرية التي كانت تدعو للاحتجاج هي اليسار الراديكالي، الذي كان يحاول تغيير الأوضاع، وكانت مطالبه تصل إلى قلب نظام الحكم، وغيرها من المطالب التي كانت تفوق سقف الممكن بكثير'.
ويوضح المحلل السياسي عصام لعروسي أنه 'في مرحلة العهد الجديد، إثر اعتلاء الملك محمد السادس العرش خلال عام 1999، اختلفت الأمور وأصبحت الاحتجاجات منظمة بصورة كبيرة، بفضل زيادة الوعي السياسي لدى جانب مهم من المواطنين، في حين شهدت تلك المرحلة شبه سيطرة للتيارات الإسلامية على الشارع، وبخاصة في ما يتعلق بتنظيم وقفات احتجاجية لمساندة القضية الفلسطينية، إذ اصطف الشارع المغربي في غالب الأحيان وراء هذه التيارات الإسلامية، وخاصة تيار ’العدل والإحسان‘، ووصولاً إلى مرحلة الربيع العربي خلال عام 2011، التي تعاملت معها السلطات من بوابة الإصلاح'. ويضيف المحلل السياسي أن 'المطالب التي كانت ترفع خلال تظاهرات ’حركة 20 فبراير‘ هي مطالب اجتماعية بالأساس، أصبحت سياسية، وصلت إلى المطالبة بالحد من صلاحيات المؤسسة الملكية، وهو ما استجاب له الملك محمد السادس عبر مراجعة الدستور، التي منحت الحكومة صلاحيات واسعة'.
حالياً الوضع يختلف عما سبق من حيث البنية البشرية، باعتبار أن 'جيل زد' الذي يقود الاحتجاجات له ثقافة مختلفة ولا حاجز خوف لديه، كونه لم يشهد فترة انتهاكات حقوق الإنسان (1956 -1999)، وفق عصام لعروسي الذي يعد أن 'طبيعة الاحتجاج خلال الوقت الحالي تكتسي طابعاً خاصاً، كونها بعيدة من التوجهات الأيديولوجية، في حين يتزعمها شباب متشبعون بطفرة التكنولوجيا الرقمية، بالتالي لم يعد المرجع الأساس للتيارات الفكرية الكلاسيكية يجذب هؤلاء الشباب، كونهم من طينة مختلفة وذوي تكوين مختلف، مما جعلهم يتابعون دراستهم في مؤسسات خاصة ويجيدون اللغات الأجنبية، وربما يرتبطون بتيار ’عولمي‘، عوض التيارات الداخلية'.