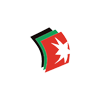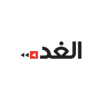اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة رم للأنباء
نشر بتاريخ: ٢٥ نيسان ٢٠٢٥
رم - في لحظة واحدة، يمكن أن تتحطم صورة الأمومة 'المثالية' التي رسمناها في خيالنا، وتنكشف الحقيقة بعمقها، بألمها، وبقوتها أيضاً. سمر الزنانيري، الصحفية وصانعة المحتوى، لم تكتفِ بمواجهة تجربة أمومتها الصعبة في صمت، بل حولت صدمتها بتشخيص ابنها بمرض الصرع إلى نقطة انطلاق نحو مشروع معرفي وإنساني بالغ الأهمية. سعت إلى بناء محتوى عربي علمي مبسط عن التدخل المبكر، في وقت كانت فيه المعلومة شحيحة، والمجتمع مثقل بالوصمات والمقارنات.
من خلف شاشة هاتف أو منصة تواصل، تتحدث سمر اليوم إلى آلاف الأمهات، لا لتمنحهن فقط المعلومة، بل لتمنحهن الأمل أيضاً. في هذا الحوار، تكشف لنا كيف تصنع المعرفة من التجربة، وكيف يتحول القلق إلى وعي، الخوف إلى فعل، والحب إلى خطة إنقاذ مبكرة لطفل قد يحتاج فقط من يقول: 'انتبهي، استعيني، لا تتأخري'.
1. بداية، ما هو التدخل المبكر للأطفال؟ ولماذا يُعتبر خطوة محورية في دعم الطفل منذ سنواته الأولى؟
التدخل المبكر هو بالمجمل أي شكل من أشكال الدعم المتخصص للأطفال من الولادة حتى عمر ٣ سنوات، لأي طفل معرّض لتأخر تطوري، أو لديه مرض أو طفرة جينية قد ينجم عنها تأخر تطوري، وبالطبع لا يقتصر فقط على الأطفال المشخصين، بل أي طفل بحاجة لدعم سواء أكان عن طريق العلاج الطبيعي، الوظيفي، النطق، العلاج السلوكي أم التعليم التخصصي المبكر.
أهمية التدخل المبكر تكمن بالأساس في طبيعة الدماغ البشري، لأن دماغنا يمر بأسرع مراحل تطوره ونموه في أول ثلاث سنوات من الحياة. عند الولادة، يكون حجم دماغ الطفل ٢٥٪ من دماغ الشخص البالغ، ويصل إلى ٨٠٪ من الحجم الكامل بعمر ٣ سنوات، وبحسب الدراسات العلمية، دماغ المولود الجديد يكوّن أكثر من مليون اتصال عصبي جديد كل ثانية خلال السنوات الأولى، وهنا تكمن أهمية التدخل المبكر، حيث طبيعة دماغ الطفل مهيّئة للتطور السريع وبحسب علم الأعصاب، فإن التدخل المبكر يمكن له أن يعيد تشكيل المسارات العصبية المسؤولة عن أي نوع من المهارات والتطور، وهذا بفضل ما يسمّى ب 'المرونة الدماغية' أو neuroplasticity ما يعني أن الدماغ في هذه المراحل الأولية قابل للتشكيل بدرجة كبيرة بفعل التدخلات والخبرات.
2. ما هي العلامات أو المؤشرات التي على الأهل الانتباه لها والتي قد تستدعي تدخلاً مبكراً؟
مؤشرات التأخر التطوري كثيرة وتختلف بحسب الفئة العمرية للأطفال، مثلاً بأول ٣ أشهر لم يبتسم الابتسامة الاجتماعية أو عدم النظر في وجه الأم، عدم رفع الرأس عند الاستلقاء على البطن بعمر ٤ أشهر، عدم إصدار أي أصوات، عدم متابعة الأشياء أو الاستجابة للأصوات، عدم المقدرة على التقاط الأشياء باليد ونقلها من يد إلى أخرى بعد عمر ٦ أشهر، تشنّج أو ارتخاء واضح بعضلات الجسم، ومنها الكثير من المهارات التطورية المرتبطة بالفئة العمرية، سواء أكانت مهارة الجلوس، الزحف، الوقوف، المشي والكلام. مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك فترة زمنية 'طبيعية' قد يصل فيها الطفل إلى المهارة قد تتراوح بين شهر إلى شهرين وأحيانا ٣ أشهر، لكن الأفضل دائماً استشارة مختص سواء أكان طبيب أعصاب، معالج طبيعي، معالج نطق، أم حتى طبيب أذن أو عيون، بحسب الحالة، وهذا ما أشدد عليه دائماً: الانتظار ليس خياراً حين يتعلق الأمر بتطور الطفل، الاستشارة هي أفضل شيء ممكن تقديمه لضمان أفضل فرصة لتطور أطفالنا.
3. في أي عمر يُفضل البدء بالتدخل المبكر؟ وهل التأخير في اتخاذ هذا القرار ينعكس على تطور الطفل مستقبلاً؟
التدخل المبكر يمكن أن يبدأ منذ أول أسابيع الولادة، خاصة إذا كان المولود الجديد قد ولد قبل أوانه واستدعى دخوله العناية المركزة لحديثي الولادة أو 'الخداج'، أو في حال ولد بوقته الطبيعي لكن أيضاً استدعى دخوله العناية المركزة بعد الولادة لأي سبب كان. أما بالنسبة لأي تأخر في مهارات أخرى سواء أكانت حركية، أم نطق، أم حتى إطعام، فلا يوجد عمر 'مناسب' للبدء في التدخل المبكر، هذا يعود على المؤشرات التي يظهرها الطفل، والأفضل عدم التردد باستشارة المختصين بأسرع وقت ممكن، لتفادي أي مشكلة جدّية وتفاقمها قبل فوات الأوان. وبالطبع التأخر باتخاذ قرار الاستشارة أو البدء بالجلسات العلاجية سيكون لديه تأثير سلبي أو على الأقل سيزيد من الفترة العلاجية.
4. كيف يمكن التمييز بين تأخر بسيط في التطور الطبيعي للطفل وبين حالة تستدعي تدخلاً متخصصاً؟
هذا الأمر لا يمكن حسمه إلا بزيارة مختصّ، سواء أكان طبيب أعصاب متخصص بالأطفال، أم بمعالج طبيعي، وظيفي ونطق. حتى الحالات البسيطة بحاجة لجلستين أو ثلاث جلسات متابعة، بالنسبة لي حين يتعلق الأمر بالتدخل المبكر، لا يوجد فرق بين تأخر بسيط أو حالة حرجة، لأن التدخل في تأخر بسيط قد يكون سبباً في تفاقم الوضع إلى حالة حرجة.
5. ما مدى أهمية دور الأهل في خطة التدخل المبكر؟ وكيف يمكن تهيئة البيئة المنزلية لدعم خطة العمل؟
دور الأهل في خطة التدخل المبكر هو أكبر وأهم من الجلسة العلاجية بحد ذاتها. والسبب هو أن الجلسة العلاجية تقتصر فقط على ٤٥ دقيقة إلى ساعة، قد تكون يومية أو أسبوعية، وهذا غير كافي لأي طفل. إضافة إلى أن الجلسة تكون غالباً في مركز مختص أو مستشفى، أي ليست في مساحته الآمنة وهي المنزل. الالتزام بالتمارين والتقنيات بطريقة سليمة وتطبيقها في المنزل الذي يقضي فيه الطفل معظم وقته، محاطاً بأهله واخوته ودعمهم، هنا فعلياً سنرى فرقاً واضحاً وتطوراً كبيراً في القدرات والمهارات. ولا داعي لأن تكون البيئة المنزلية مهيئة بأدوات وآلات باهظة الثمن كما في المراكز التأهيلية، يمكن الاستعانة بأدوات منزلية بسيطة ومتوفرة في كل بيت، وطبعاً الأمر يختلف من حالة إلى أخرى، لكن غالباً ما ينصح المعالج الطبيعي أو الوظيفي أو معالج النطق بتدريبات وأدوات متاحة في المنزل. والأهم من الأدوات المتاحة هو دائرة الدعم من الأسرة ككل، وهنا لا أتحدث فقط عن الأم والأب أو الإخوة، وإنما عن الدائرة الأسرية الأوسع، لأن الحب غير المشروط للطفل والدعم هو مجاني ولا يحتاج لأي جهد من أي أحد. كذلك الأمر بالنسبة للدعم للأهل نفسهم من الأقارب والأصدقاء.
6. ما هو دور العلاج الوظيفي، النفسي والتربوي في هذا الإطار؟ وهل يمكن القول إن التدخل المبكر يشمل كل هذه الجوانب؟
التدخل المبكر هو بمثابة مظلة لكافة العلاجات بحسب الحالة والتشخيص، وهناك خطط للتدخل المبكر قد تحتاج كافة هذه العلاجات، وهناك خطط قد تقتصر فقط على العلاج الطبيعي أو السلوكي، بحسب حاجة الطفل.
7. كيف يجب التعامل مع المقارنات المجتمعية التي قد تؤثر على الأهل سلباً عند مقارنة طفلهم بغيره؟
بالنسبة لي، المقارنة هي حكم بالإعدام النفسي على الطفل وأهله. لا يوجد إنسان مثل إنسان آخر، فما بالك بطفل رضيع أو بعمر السنة أو السنتين. داخل الأسرة الواحدة دائماً ما نرى اختلاف بالقدرات أو حتى بالتفضيلات بين الإخوة، فكيف لنا المقارنة بين طفلين من عائلات مختلفة؟ التعليقات البشعة من محيط الأهل حين يقارنون الطفل بطفل آخر أو حتى بذويهم عندما كانوا بعمرهم قبل ٣٠ أو ٤٠ عاما، هذا بحد نفسه أعتبره جهلاً وحكمًا بالإعدام النفسي على الأهل. دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذا الطفل، فترة الحمل، الولادة، الملف الطبي، العوامل الوراثية، الطفرات الجينية، الأمراض النادرة وغيرها الكثير.
حتى في علم النفس وعلم الاجتماع النفسي، نظرية المقارنة المجتمعية التي طرحها العالم ليون فستينغر تنص على أن المقارنة تكون منصفة وعادلة فقط عند المقارنة بين أمرين متقاربين بالقدرات، وشبه مستحيل مقارنة الأشخاص بقدرات متباينة ومتفاوتة.
8. برأيك، ما مدى وعي المجتمع اليوم بأهمية مراحل تطور الطفل والتدخل المبكر؟ وهل هناك فجوات يجب العمل عليها؟
للأسف نسبة الوعي المجتمعي بأهمية التدخل المبكر ومراحل تطور الطفل متدنية، خاصة مع انتشار المقارنات بين الأطفال، ووجود ثقافة ال'عيب'، وأقصد بها هنا التستّر على أي مشكلة مرضية أو تأخر تطوري للطفل من مبدأ الخوف من أحكام المجتمع المحيط بالأهل، وأنا شخصياً في بداية الأمر واجهت بعض الأشخاص المحيطين بي يرددون جملة 'لا تخبري أحد بمرض ابنك، خلّي الموضوع بينك وبين زوجك' أو 'لا تخبري أحد، أعطيه وقت مع الأيام سيصبح أفضل لا داعي أن تقولي لأحد عن مرضه' وكأن التشخيص 'عيب' أو بلاء أو فضيحة. ومن هنا جاءت الفكرة لي ببدء مشروع مختص فقط في التدخل المبكر وتوعية الأهل، وأعمل حالياً على دورات إرشادية وتوعوية لسدّ هذه الفجوة، خاصة وأن المحتوى المتوفر باللغة العربية في موضوع التدخل المبكر والمراحل التطورية قليل جداً.
9. ما هي رسالتك للأمهات الجدد اللواتي يشعرن بالقلق حيال تطور أطفالهن ولكنهن مترددات في طلب المساعدة؟
قلبك وإحساسك هما بوصلة لا تستهيني بهما، لا تكترثي لمن حولك، أنت لست لوحدك، وأرجوك سارعي باستشارة المختصين، والتردد بالاستشارة قد يكون ثمنه مستقبل تطور طفلك. التدخل المبكر لن يخسرك شيئاً لكن الخوف من الأصوات المحيطة بك ستخسرك وطفلك الكثير. قلقك وخوفك ليس وهماً أو 'دراما' لأنه غالباً ما يكون حدس الأم بطفلها بمحلّه، وانت أم عظيمة وجبارة باهتمامك ومتابعتك الواعية لطفلك.
10. شاركتِ مؤخراً تجربتك المؤثرة بعد تشخيص ابنك بالصرع، كيف استقبلتِ الخبر كأم؟ وكيف انعكس ذلك على قراراتك؟
خبر التشخيص كان أشبه بتحطيم مرآة كان فيها صورة 'مثالية' عن تجربة الأمومة لأول مرة، هذه الصورة كانت نتاج ما رأيته حولي من خبرات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورة مزيّفة عن واقعنا. كأم لطفلي الأول أن أقف في رواق العناية المركزة لحديثي الولادة، أنظر لطفلي من بعيد ولا استطيع أن ألمسه لأنه داخل الحضانة محاطاً بأسلاك وأنابيب وجهاز تخطيط للدماغ، فيأتي طبيب أعصاب يخبرني بأن التشخيص هو كهرباء في الدماغ، أو 'ألصرع' مع تحفظي الكبير على هذا المصطلح لما يحمله من وصمات مجتمعية مغلوطة. كان صدمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لكن إيماني أنا وزوجي بمشيئة الله ورحمته وثقتنا بأطباء طفلنا كانت كافية لأن نأخذ الخطوات الصحيحة لنضمن أفضل فرصة لابننا بالتطور السليم.
11. ما هو أول إجراء اتخذته بعد التشخيص؟ وهل كان هناك تدخل مبكر واضح في الخطة العلاجية أو التعليمية؟
تم تشخيص ابني عندما كان عمره لا يتجاوز ال٤٨ ساعة، فعلياً حينها الإجراء الأول كان البدء بدواء خاص للتحكم بالنوبات الكهربائية، وطبعاً مع استشارة طبيب الأعصاب المختص، الذي بدوره فسّر لنا عن إمكانية وجود تأخر تطوري بجوانب مختلفة، اتخذنا قرار البدء بالتدخل المبكر بعمر ٤ أشهر، وباشرنا بالعلاج الطبيعي، ثم لاحظت تأخراً بالمهارات الحركية الدقيقة والنطق، فلجأنا إلى العلاج الوظيفي وعلاج النطق والإطعام بعمر ٧ أشهر. الخطة لم تكن واضحة منذ بداية التشخيص لكن مع المتابعة القريبة مع طبيب الأطفال وطبيب الأعصاب، وبحوثي الشخصية في التدخل المبكر، استطعنا أن نؤسس خطة علاجية شاملة بدعم من المعالِجات الطبيعية والوظيفية والنطقية.
12. رغم صعوبة الموقف، إلا أنكِ ظهرتِ قوية وداعمة، ما الذي أعطاكِ هذه القوة؟ وما الدروس التي خرجتِ بها من هذه المرحل؟
لا استطيع أن أفسّر مصدر قوتي إلّا أنها قوة إلهية، الله سبحانه وتعالى رحمني وعزّاني بقوة لأن احتمل ما لم استطع يوماً أن احتمله. إضافة لدعم زوجي وأهلي وأطباء طفلي. كما إنني أؤمن بأن القوة تولد من العدم، انعدام الحيلة والعجز النفسي لحظة التشخيص والخوف من المجهول، وفكرة أن طفلي ليس لديه أي شيء سوى قوتي وقوة والده ليستطيع أن يتخطى هذه المرحلة، فإن لم أكن بكامل قوتي له، لن يستطيع أن يستمد القوة من أي مكان آخر. التجربة بحد ذاتها علمتني الكثير من الدروس، أولها أن الجهل والخوف هما أكبر عدو ، وطلب المساعدة ويد العون ليست ضعفاً أو 'عيبا'، وأن حدسي كأم تجاه طفلي أقوى من أي تعليق أو رأي 'عابر' من محيطي، وأخيراً أعظم درس خرجت به هو التقبّل، تقبّل أطفالنا الذين هم نعمة من رب العالمين، تقبّل الآخرين بكافة مشاعرهم وتحدياتهم، تقبّل نفسي بكافة انكساراتها وتقلّباتها، وتقبّل مشيئة الله وحكمته التي هي فوق كل شيء.