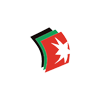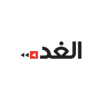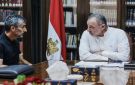اخبار الاردن
موقع كل يوم -جو٢٤
نشر بتاريخ: ٢ أيلول ٢٠٢٥
جامعة اليرموك: بين هاجس الاستقرار ومعركة الرئاسة
د. محمد تركي بني سلامة
٢_٢
إذا انتقلنا من المستوى النظري إلى المستوى التطبيقي، نجد أن الثقافة السياسية ليست مجرد مفهوم يقتصر على علاقة المواطن بالدولة أو موقف الأفراد من السلطة، بل هي إطار أشمل يمتد ليغطي كل مؤسسات المجتمع، بما فيها الجامعات. فالجامعات، بما تحمله من دور محوري في صناعة العقول وإنتاج المعرفة وتخريج القيادات، ليست كيانات محايدة إداريًا، بل هي مؤسسات سياسية واجتماعية تعكس طبيعة الثقافة السائدة في المجتمع، وتعكس أيضًا حالة الاستقرار أو الاضطراب التي يعيشها المحيط العام. ومن هذا المنطلق، فإن قضية رئاسة جامعة اليرموك لا تمثل شأنًا داخليًا محدودًا، بل هي نموذج حي يمكن قراءته بعمق من زاوية الثقافة السياسية والاستقرار المؤسسي.
منذ تأسيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في ثمانينيات القرن الماضي حيث ولدت من رحم جامعة اليرموك وكان كادر المؤسسين من أكاديميين وإداريين من أبناء اليرموك، تمكّنت هذه الجامعة من تحقيق استقرار إداري لافت للنظر. فجميع رؤسائها كانوا من أبنائها، وغالبية هؤلاء استمروا لدورتين كاملتين أي ما يعادل ثماني سنوات، وهو ما أتاح لها وضع خطط استراتيجية طويلة المدى، وتراكمًا في الخبرات والإنجازات انعكس على مكانتها المحلية والإقليمية والدولية. لم يكن هذا الاستقرار وليد الصدفة، بل كان أحد العوامل الجوهرية التي أسهمت في ترسيخ سمعة الجامعة، ومنحها موقعًا متقدمًا بين الجامعات الأردنية والعربية. ولأنها حصدت ثمرة الاستقرار، غدت قادرة على التوسع في الإنجاز والتأثير، وحققت وفرة مادية ،لكنّ ما يحزن أن هذه الوفرة لم تنعكس بمد يد العون لشقيقتها الأولى جامعة اليرموك، بل بقيت الأخيرة تعاني، وكانها تركت وحيدة في معركة المصير ، ناهيك عن القضايا العالقة بين الجامعتين حول المركز الصحي وقبولات أبناء العاملين والمدرسة النموذجية وغيرها .
في المقابل، نجد أن جامعة اليرموك عانت طويلًا من غياب هذا الاستقرار. فمنذ نشأتها في سبعينيات القرن الماضي وحتى اليوم، لم يُكمل أي رئيس فيها مدة ثماني سنوات متصلة باستثناء المؤسس الأستاذ الدكتور عدنان بدران. بل إن بعض الرؤساء لم يكملوا دورة واحدة مدتها أربع سنوات، في حين غادر آخرون بعد عام واحد فقط. هذه الحالة من التذبذب الإداري لم تكن مجرد تفاصيل شكلية، بل تركت أثرًا عميقًا في مسيرة الجامعة، فأضعفت قدرتها على رسم رؤية استراتيجية طويلة الأمد، وأثّرت على تصنيفها الأكاديمي ومكانتها البحثية، وزعزعت ثقة العاملين والطلبة بمؤسستهم.
يزداد المشهد تعقيدًا حين نعلم أن عددًا من القيادات التي تولت رئاسة الجامعة أو مواقع نواب الرئيس والعمداء جاءوا من خارج الجامعة، فأربعة جاءوا من الجامعة الأردنية، وثلاثة جاؤوا من جامعة العلوم والتكنولوجيا، بينما لم يشغل أي أكاديمي من جامعة اليرموك منصبًا قياديًا مماثلًا لا في الجامعة الأردنية ولا في 'التكنولوجيا' ، ومحظوظ ان استطاع الحصول على اجازة تفرغ علمي في اي منهما . واليوم، نجد أن رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك ونائبه كلاهما من جامعة العلوم والتكنولوجيا، ويا للصدفة لا يوجد من جامعة اليرموك أي عضو في مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا، وأن اثنين من أصل خمسة مرشحين لرئاسة الجامعة ينتمون إليها أيضًا. هذا الاختلال في التوازن يدفعنا للتساؤل: هل الأمر طبيعي ويعكس تكاملًا صحيًا بين المؤسسات التعليمية في البلاد؟ أم أنه حالة غير متوازنة ومقصودة وبفعل فاعل حتى وإن كانت تضر بمبدأ العدالة المؤسسية وتكافؤ الفرص؟
من الخطأ الاعتقاد أن جامعة اليرموك تفتقر إلى الكفاءات القيادية. فالواقع يثبت أن هذه الجامعة خرّجت عبر تاريخها رؤساء جامعات وأكاديميين بارزين أثبتوا كفاءتهم ونجاحهم في مواقع قيادية أخرى داخل الأردن وخارجه. المشكلة الحقيقية ليست في غياب الكفاءات، بل في استمرار تهميشها داخل جامعتها نفسها، وهو ما أدى إلى إضعاف انتماء أبنائها المؤسسي، وإفقاد الجامعة جزءًا من هويتها المتجذرة. ومن هنا، تصبح مسألة اختيار رئيس جامعة اليرموك قضية وطنية بامتياز، لأنها تمس العدالة المؤسسية، وترتبط مباشرة بمشروع التحديث السياسي الذي يقوده الأردن.
فالجامعات، في نهاية المطاف، ليست مجرد قاعات دراسية أو مختبرات بحثية، بل هي مؤسسات اجتماعية وسياسية تحمل على عاتقها صناعة وعي الأجيال. أي خلل في إدارتها ينعكس مباشرة على الثقافة السياسية للمجتمع. وحين يتم تهميش أبناء الجامعة في مواقع القيادة، فإن الرسالة التي يتلقاها الطلبة والأساتذة معًا هي أن الانتماء والعمل الجاد داخل المؤسسة لا يكفي، بل لا بد من عوامل خارجية لتحصيل القيادة. وهذه الرسالة السلبية تتعارض مع قيم المشاركة والشفافية وتكافؤ الفرص التي أكدت عليها الأوراق النقاشية الملكية، والتي تمثل جوهر رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لبناء الدولة الحديثة.
إذا أردنا لجامعة اليرموك أن تستعيد مكانتها المرموقة، فلا بد من وضع شروط أساسية واضحة. أول هذه الشروط هو الاستقرار الإداري، الذي يضمن استمرار القيادة لفترة كافية تسمح برسم السياسات وتنفيذ الخطط وتقييم النتائج. وثانيها هو تعزيز الثقة بالكفاءات المحلية من أبناء الجامعة، وإعطاؤهم الأولوية في قيادة مؤسستهم، انطلاقًا من القاعدة البديهية القائلة إن 'أهل مكة أدرى بشعابها'. أما الشرط الثالث فهو تحويل العلاقة بين جامعتي اليرموك والعلوم والتكنولوجيا من منافسة غير صحية إلى شراكة استراتيجية قائمة على التعاون في البحث والتدريس والمشاريع المشتركة.
إن استقرار رئاسة جامعة اليرموك ليس مجرد مطلب أكاديمي داخلي، بل هو ضرورة وطنية تمس مستقبل التعليم العالي في الأردن، وتنعكس على قدرة الدولة على إنتاج المعرفة وصناعة القيادات. فغياب الاستقرار يعني غياب القدرة على التخطيط والتقدم، أما الاستقرار المبني على العدالة والكفاءة فيمنح الجامعة فرصة لتستعيد دورها الريادي كمصنع للعقول وركيزة للتنمية الوطنية. ومن ثم، فإن الدرس الذي نستخلصه من قراءة تجربة اليرموك ليس بعيدًا عن جوهر النظرية السلوكية التي أعادت تعريف السياسة: لا يمكن لأي مؤسسة أن تنجح إذا تجاهلت الثقافة السياسية التي تحيط بها، ولا يمكن لأي جامعة أن تتقدم إذا لم تستقر قيادتها وتُمنح الثقة بكفاءاتها الداخلية.
إن مستقبل جامعة اليرموك ليس شأنًا إداريًا محضًا، بل هو قضية وطنية بامتياز، ورسالة مفادها أن بناء الدولة الحديثة يبدأ من احترام العدالة المؤسسية وتكافؤ الفرص، وإدراك أن النهضة الحقيقية تقوم على الاستقرار والكفاءة والهوية الجامعة.
وخاتمة القول: إن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه اليوم هو: أي ثقافة نريد أن تسود في جامعاتنا؟ هل هي ثقافة الخضوع والانعزال واللامبالاة، أم ثقافة المشاركة الفاعلة والإيجابية المسؤولة؟ إن أبسط درجات الضمير، وأدنى مظاهر الفكر الإصلاحي، تقتضي أن ندرك أن أساتذة الجامعات هم عقل الأمة وضميرها الحي. فإذا كان المطلوب أن يلوذ هؤلاء بالصمت، ويُدفعوا دفعًا إلى الهامش، فإننا لا نكون قد أعلنا وفاة الإصلاح فحسب، بل دفنا معه آخر ما تبقى من كرامة وطنية. فحين يُقمع صوت النخبة، وتُهمّش العقول، يصبح الحديث عن تحديث سياسي أو مشروع وطني ضربًا من العبث، ويغدو المشهد تجسيدًا للإفلاس الفكري والانحطاط الأخلاقي والفساد السياسي. وحينها، لن يكون أمامنا إلا أن نفتح بيت عزاء كبير للإصلاح، ونقرأ الفاتحة على روح وطنية تُغتال كل يوم بصمت وإصرار، وكأننا نشيّع مستقبلًا أُعدم قبل أن يولد.