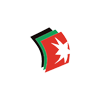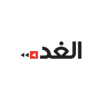اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة مدار الساعة الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٧ أيار ٢٠٢٥
البوصلة مفقودة، لا لأنها ضاعت، بل لأن أحدًا لم يعد يبحث عنها.تسري في شرايين الواقع العربي دولة غير مرئية من التضليل، دولة لا ترفع راية، لكنها تغرس أفكارًا. تتغلغل في الخطاب، وتتسلل إلى التعليم، وتُزخرف الإعلام، حتى صار الكذب طلاءً يوميًا، لا نكاد نراه من كثرة ما اعتدناه. ولسنا في ذلك ندّعي كمال الحكومات العربية، فهذا ضربٌ من التهويم، ولكننا ندعو لوحدة الصف، ولحماية الهوية، ولصياغة تحالفات تحفظ استقرار المنطقة بعيدًا عن التدخل في شؤون الدول، سواء أكان سياسيًا أم أيديولوجيًا أم إعلاميًا.وفي هذا السياق، يُثير الاستغراب كيف يتعامى كثيرون عن الدور المحوري الذي قامت به دول كالأردن ومصر والسعودية، في خدمة قضايا الأمة، وفي منع انهيارها التام. لقد قدّمت هذه الدول للأمة العربية والإسلامية أكثر بكثير مما قدّمه من يرفع الشعارات ويستثمر في الجراح. ومع التقدير لكل من ساهم في مشروع النهوض، فإن ما نراه اليوم في سوريا من مسار أكثر اتزانًا هو خطوة على الطريق الصحيح، بعد أن دفع الشعب السوري ثمناً باهظًا لتجارب الخارج ولحسابات الغير.ومع ذلك، لا يزال بيننا من يُريد، بكل سذاجة، أن يراهن على العدو ذاته — العدو الفارسي — الذي دمّر سوريا، وأغرق العراق في الطائفية، ومزّق اليمن، وخنق لبنان، كل ذلك تحت أوهام الفتوحات المزعومة، وشعارات المقاومة المفرغة من مضمونها. عدو لا يُخفي عداءه للعرب، ولا يرى في التاريخ الإسلامي المجيد إلا سلسلة من 'مصائبه'، ويمعن في تشويهه لأنه يُذكّره بانكساراته القديمة. فكيف يُعقل أن نعيد صياغة وعينا لنصطف خلف من يرى في انتصارات الإسلام أيام الفاروق وعلي والأمويين والعباسيين إرثًا يجب محوه؟ كيف نمنح ثقتنا لمن لم يبنِ وطنًا، بل بنى مشروعًا مذهبيًا عابرًا للحدود، يقتات على الشقاق، ويتنفس من صراعات الأمة؟هذا العدو ليس بديلاً، ولا نصيرًا، بل هو طرف آخر من منظومة التضليل التي تسلب وعينا وتدّعي حمايته.نحن لا نعترف بالواقع، لا نحاكمه، ولا حتى نقرأه. لا نقرأ التاريخ، لا الإسلامي ولا الحديث، لا نُدرك ما حدث في بدايات الجهر بالدعوة، وإن قرأناه لم نفهمه. لم نُمعن النظر في تاريخ ألمانيا ما بعد الهزيمة، ولا في تجربة اليابان ما بعد الرماد. لم نسأل أنفسنا كيف تنهض أمة، ولا ما الذي يحوّل الهزيمة إلى بناءٍ شامخ.لقد أصبحنا نسير ضمن فرق صُمّمت لنا، لا نعي متى دخلناها، ولا كيف صارت تتحكم بطريقة رؤيتنا لكل شيء. فرق سياسية، وأخرى اقتصادية، وحتى ثقافية، تملأ عقولنا بالشعارات وتُخدّر وعينا بلغة تلامس آمالنا، لكنها تُبعدنا عن جوهر الحقيقة.نختار من يخبرنا ما نحب أن نسمعه. فلو جاءنا بائع وقال: 'هذه البضاعة ممتازة، لا مثيل لها'، رفع السعر ولبس ثوب الثقة، صدّقناه وقلنا: هذا صادق!أما إذا جاءنا من قال الحقيقة، وقلّل السعر لأنه يعرف القيمة الحقيقية، شككنا به، وقلنا: هذا مخادع!نحن نحب من يُحسن الكذب إذا جاء على هوى النفس. نُحب أن يُقال لنا إننا الأفضل، وإن المستقبل لنا، وإن العدو منهزم، وإننا على صواب، حتى ولو كانت الحقيقة تقول غير ذلك.وهكذا يُخدع الإنسان، لا لأنه جاهل، بل لأنه يستسلم لراحة الوهم، ويهاب وجع الحقيقة.نعيش في زمنٍ صارت فيه الشعارات بديلاً عن الفهم، والمظاهر غلافًا للحقيقة، و'الإيمان بالقوة' أسلوب تسويق للخداع. تُصاغ الخطابات بلغة الثقة، لكنها تُسلب جوهرها من المعنى. وما أن يُكتشف الخداع، حتى نلجأ إلى التبرير، أو نلوذ بصمتٍ ثقيل، كأنّ في الصمت عزاء، وكأنّ في الخيبة سكينة.إن تضليل الوعي لا يحدث دائمًا بالقمع، بل كثيرًا ما يتم بالترغيب، وبأنصاف الحقائق، وبصناعة رموز من ورق تُلَبّى بها الحاجات النفسية العميقة لجماهير متعبة.لا بد من استذكار مواقف القادة العرب الذين سطروا تاريخًا من الوحدة والتضامن، كالحسين حين دعا إلى الفيلق العربي، والملك عبد الله بن عبد العزيز الذي سعى لرأب الصف الفلسطيني، ومصر التي قدّمت رؤيتها لإعادة بناء غزة، واليوم يُرفع لهم القبعات. كما لا يمكن تجاهل الدور الفاعل لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي وضع ثقله لإنقاذ سوريا، ودعم الأردن لاستقرار المنطقة وتنسيق جهوده مع دمشق، إضافة إلى الدعم المصري المستمر لهذه التوجهات. ولا ننسى الكويت الحبيبة وكافة الدول العربية والإسلامية التي كان لها دور مشهود في دعم قضايا الأمة، مواقف توّجت بروح التضامن والتآزر التي لا بد أن تُستعاد لتكون أساسًا لانطلاق نهضة عربية حقيقية، تقوم على الوحدة والتكامل بين الأشقاء، بعيدًا عن الفرقة والتفكيك. لماذا يطلب من سوريا اليوم شن حرب على الكيان ولم يطلب منها ذلك خلال نصف قرن من خطابات الرد الذي سيكون في أجل غير مسمى...لقد آن الأوان أن نعيد البوصلة إلى يد العقل، وأن نمارس نقد الذات كأول خطوة في استرداد وعينا من قبضة التضليل.فالأمم لا تنهض بالكلمات، بل بالوعي، ولا تُخدع إلا حين تقرر أن لا تفكّر ومن هنا يعاد تعريف المعركة بوعي واردة جمعية .
البوصلة مفقودة، لا لأنها ضاعت، بل لأن أحدًا لم يعد يبحث عنها.
تسري في شرايين الواقع العربي دولة غير مرئية من التضليل، دولة لا ترفع راية، لكنها تغرس أفكارًا. تتغلغل في الخطاب، وتتسلل إلى التعليم، وتُزخرف الإعلام، حتى صار الكذب طلاءً يوميًا، لا نكاد نراه من كثرة ما اعتدناه. ولسنا في ذلك ندّعي كمال الحكومات العربية، فهذا ضربٌ من التهويم، ولكننا ندعو لوحدة الصف، ولحماية الهوية، ولصياغة تحالفات تحفظ استقرار المنطقة بعيدًا عن التدخل في شؤون الدول، سواء أكان سياسيًا أم أيديولوجيًا أم إعلاميًا.
وفي هذا السياق، يُثير الاستغراب كيف يتعامى كثيرون عن الدور المحوري الذي قامت به دول كالأردن ومصر والسعودية، في خدمة قضايا الأمة، وفي منع انهيارها التام. لقد قدّمت هذه الدول للأمة العربية والإسلامية أكثر بكثير مما قدّمه من يرفع الشعارات ويستثمر في الجراح. ومع التقدير لكل من ساهم في مشروع النهوض، فإن ما نراه اليوم في سوريا من مسار أكثر اتزانًا هو خطوة على الطريق الصحيح، بعد أن دفع الشعب السوري ثمناً باهظًا لتجارب الخارج ولحسابات الغير.
ومع ذلك، لا يزال بيننا من يُريد، بكل سذاجة، أن يراهن على العدو ذاته — العدو الفارسي — الذي دمّر سوريا، وأغرق العراق في الطائفية، ومزّق اليمن، وخنق لبنان، كل ذلك تحت أوهام الفتوحات المزعومة، وشعارات المقاومة المفرغة من مضمونها. عدو لا يُخفي عداءه للعرب، ولا يرى في التاريخ الإسلامي المجيد إلا سلسلة من 'مصائبه'، ويمعن في تشويهه لأنه يُذكّره بانكساراته القديمة. فكيف يُعقل أن نعيد صياغة وعينا لنصطف خلف من يرى في انتصارات الإسلام أيام الفاروق وعلي والأمويين والعباسيين إرثًا يجب محوه؟ كيف نمنح ثقتنا لمن لم يبنِ وطنًا، بل بنى مشروعًا مذهبيًا عابرًا للحدود، يقتات على الشقاق، ويتنفس من صراعات الأمة؟
هذا العدو ليس بديلاً، ولا نصيرًا، بل هو طرف آخر من منظومة التضليل التي تسلب وعينا وتدّعي حمايته.
نحن لا نعترف بالواقع، لا نحاكمه، ولا حتى نقرأه. لا نقرأ التاريخ، لا الإسلامي ولا الحديث، لا نُدرك ما حدث في بدايات الجهر بالدعوة، وإن قرأناه لم نفهمه. لم نُمعن النظر في تاريخ ألمانيا ما بعد الهزيمة، ولا في تجربة اليابان ما بعد الرماد. لم نسأل أنفسنا كيف تنهض أمة، ولا ما الذي يحوّل الهزيمة إلى بناءٍ شامخ.
لقد أصبحنا نسير ضمن فرق صُمّمت لنا، لا نعي متى دخلناها، ولا كيف صارت تتحكم بطريقة رؤيتنا لكل شيء. فرق سياسية، وأخرى اقتصادية، وحتى ثقافية، تملأ عقولنا بالشعارات وتُخدّر وعينا بلغة تلامس آمالنا، لكنها تُبعدنا عن جوهر الحقيقة.
نختار من يخبرنا ما نحب أن نسمعه. فلو جاءنا بائع وقال: 'هذه البضاعة ممتازة، لا مثيل لها'، رفع السعر ولبس ثوب الثقة، صدّقناه وقلنا: هذا صادق!
أما إذا جاءنا من قال الحقيقة، وقلّل السعر لأنه يعرف القيمة الحقيقية، شككنا به، وقلنا: هذا مخادع!
نحن نحب من يُحسن الكذب إذا جاء على هوى النفس. نُحب أن يُقال لنا إننا الأفضل، وإن المستقبل لنا، وإن العدو منهزم، وإننا على صواب، حتى ولو كانت الحقيقة تقول غير ذلك.
وهكذا يُخدع الإنسان، لا لأنه جاهل، بل لأنه يستسلم لراحة الوهم، ويهاب وجع الحقيقة.
نعيش في زمنٍ صارت فيه الشعارات بديلاً عن الفهم، والمظاهر غلافًا للحقيقة، و'الإيمان بالقوة' أسلوب تسويق للخداع. تُصاغ الخطابات بلغة الثقة، لكنها تُسلب جوهرها من المعنى. وما أن يُكتشف الخداع، حتى نلجأ إلى التبرير، أو نلوذ بصمتٍ ثقيل، كأنّ في الصمت عزاء، وكأنّ في الخيبة سكينة.
إن تضليل الوعي لا يحدث دائمًا بالقمع، بل كثيرًا ما يتم بالترغيب، وبأنصاف الحقائق، وبصناعة رموز من ورق تُلَبّى بها الحاجات النفسية العميقة لجماهير متعبة.
لا بد من استذكار مواقف القادة العرب الذين سطروا تاريخًا من الوحدة والتضامن، كالحسين حين دعا إلى الفيلق العربي، والملك عبد الله بن عبد العزيز الذي سعى لرأب الصف الفلسطيني، ومصر التي قدّمت رؤيتها لإعادة بناء غزة، واليوم يُرفع لهم القبعات. كما لا يمكن تجاهل الدور الفاعل لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي وضع ثقله لإنقاذ سوريا، ودعم الأردن لاستقرار المنطقة وتنسيق جهوده مع دمشق، إضافة إلى الدعم المصري المستمر لهذه التوجهات. ولا ننسى الكويت الحبيبة وكافة الدول العربية والإسلامية التي كان لها دور مشهود في دعم قضايا الأمة، مواقف توّجت بروح التضامن والتآزر التي لا بد أن تُستعاد لتكون أساسًا لانطلاق نهضة عربية حقيقية، تقوم على الوحدة والتكامل بين الأشقاء، بعيدًا عن الفرقة والتفكيك. لماذا يطلب من سوريا اليوم شن حرب على الكيان ولم يطلب منها ذلك خلال نصف قرن من خطابات الرد الذي سيكون في أجل غير مسمى...
لقد آن الأوان أن نعيد البوصلة إلى يد العقل، وأن نمارس نقد الذات كأول خطوة في استرداد وعينا من قبضة التضليل.
فالأمم لا تنهض بالكلمات، بل بالوعي، ولا تُخدع إلا حين تقرر أن لا تفكّر ومن هنا يعاد تعريف المعركة بوعي واردة جمعية .