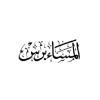اخبار اليمن
موقع كل يوم -شبكة الأمة برس
نشر بتاريخ: ٣٠ أيلول ٢٠٢٥
توفيق قريرة*
حين كنا صغارا، ولا أحد يعلم منّا كم ظللنا صغارا، كان الكبار يقولون للواحد منّا حين يشتكي من شخص أو من شيء: ستنسى حين تكبرǃ كبرنا ونسينا أشياء ولم ننْسَ أخرى.. كانوا يقصدون أشياء غير التي يقصدها المختصون من النسيان.. كانوا يقصدون أنّ الوقت كفيل بأن يُنسي المرء ما يحدث له من الحادثات التي تجعله مهموما أو مهتما. كانوا يقصدون حتما أنّك وأنت صغير لا تحدث لك إلاّ الصغائر من الأشياء، وحين تكبر ستحدث لك الحوادث الكبار، هي مخبّأة لك حين تصبح انت المسؤول تماما عن أفعالك. النسيان رحمة هكذا كانوا يقولون لنا في صياغة أخلاقية تشجعنا على أن نرمي بعيدا أثقالنا عن ذاكرتنا ذات المدى الطويل والتي سمّاها بعض المتفلسفين منّا بالذاكرة الحافظة.
علمتنا الخبرة في الحياة أنّ الكتابة تخزّن ما نخاف أن ننساه.. كنّا نكتب على قطع الأوراق ما توصينا به أمّهاتنا من اللوازم اليومية، حين ترسلنا لاشترائها، التي كنّا نخشى أن تحتفظ به ذاكرتنا أشياء مثل الملح والسكر والطماطم والمعجنات والخبز والشاي، بالمقادير القليلة المفصّلة للوحدة الكبرى: الكيلوغرام.
تعلمنا من المدرسة أنّ الكتابة تحفظ الدرس، علينا أن نكتب كتب نسخ أو كتب إملاء، فبتنا تابعين لمدرسينا لا نكتب إلاّ ما كتبوه لنا. فلم نتعلم إلاّ نادرا أن نكتب من تلقاء أنفسنا ما نسمعه من المدرّسين، وحتى إن اخترنا أن نفعل ذلك كان الجواب على السؤال: ماذا نكتب ممّا يقال؟ صعبا محيّرا. هل ندوّن رؤوس المسائل وتكون أوراقنا مذكّرات للأفكار التي تعلق بأذهاننا؟ أم علينا أن نكتب كلّ شيء. وحين نكتب هل علينا أن نصوغ بأنفسنا أفكارنا؟ أم تكون صياغتها عالة على مدرّسنا فترانا نستوقفه ونترجاه أن يعيد العبارات والتعابير حتى ندوّن.. كنّا نصنّف الأساتذة حسب سرعة الإملاء. وحين أصبحت بدوري مدرّسا كنت أقول في مرّات كثيرة في المحاضرات إنّي لا أملّي.. عبارة ينزعج لها الطلاب الذين لا يحسن أغلبهم صياغة ما يسمع بنفسه.. لذلك كانت تأخذني بهم رأفة الأب الساكنة فيّ فأعيد الفكرة بأن أثنّي بشرحها وتفصيلها والتوقف عندها والإكثار من الأمثلة التي تبسّطها، وكلّ ذلك حتى أمكّن المسافرين في قافلة الدرس والممتطين للدّواب البطيئة أن يلحقوا بالقافلة. سينسى الدرس إن لم يُكتب هذا أمر مسلّم به بين الطلاب إلى يوم الناس هذا.
لكنّ حلقات الشيوخ في عصور سابقة كانت تُحفظ عن ظهر قلب، لأنّ الكتابة كانت قليلة، وأخذ العلم سماعا كان هو القاعدة. في الثقافات الشفوية لم يكن من مهرب للمتعلمين من أن يعتمدوا على الذاكرة الحافظة، لكنّ الإشكال كان في النصوص الطوال، التي لا تقبل التحريف مثل الشعر والقرآن. لذلك كان التدوين هو الحلّ. التدوين بمعنى أن تُكتب نصوص كانت موجودة حفظا في الذاكرة، تكتبها الذوات الحافظة لها أو ذوات كاتبة لا حافظة. من الصعب أن نقارن بين قدرة البشر قديما على الحفظ وسرعته، وعجزهم حديثا عن ذلك. لم يتغيّر البشر بين عصر وعصر، فالذاكرة لديهم إمّا قصيرة لا تحتفظ بالمعلومات إلاّ لثوان، أو دقائق معدودة، أو طويلة يمكن أن تخزّن وتحفظ لوقت طويل. والمحفوظ لا يحفظ باستمرار إلاّ بالمداومة والاستذكار والإعادة، لذلك نرى اليوم حفَظَةَ القرآن يراجعون ما حفظوه في كلّ مرّة حتى لا ينسى. كذلك كل شيء محفوظ لا يثبت بمرّ الزمان، إن لم يداوم الحافظون على إنعاشه وإعادة حفظه بشكل جديد.
الكتابة والتدوين إذن فكرة رائعة، لكنّ كثيرا منها علقت به أسطورية جميلة لا بدّ منها مثل الأسطورية التي تروى لنا عن القصائد الطوال الجاهليّات، التي سمّيت «معلّقات». فأجمل ما قيل لنا فيها ولسنا مضطرين أن نصدّقه، أنّها نصوص كتبت بماء الذهب وعلّقت على جدران الكعبة. وهذا يفترض منّا أن نسلّم بأنّ هناك ديوانَ كتابة تعهد إليه بتدوين هذه النصوص، وعلينا ألاّ نصدّق بأنّ الشعراء هم من كانوا يدوّنون نصوصهم بأنفسهم، إذ إنّ أغلبهم كان أمّيا لا يعرف الخط ولا الكتابة، وحتى لو افترضنا أنّ منهم من يعرف فمن أين لشاعر كَسّاب أو صعلوك مفرد إفراد البعير المعبّد، أن يمتلك دواةً من الذهب وقلما من سحر الخيميائيّين يستخرج الحبر من التبر؟ وعلينا أنّ نصدّق بأنّ جدار الكعبة يحمي هذه النصوص من اللصوص. وأنت تصدّق كلّ ذلك ستصدّق أيضا أنّ هذه النصوص كانت خارج تقاليد الحجّ وأعراف العبادة. هي ربما كوشي ثوب الكعبة، أو كباب مزدان من أبوابها قيمته ليس في ذاته، بل في رمزية البيت المعلّقة عليه أبيات القصيدة. أفضل ما في الأساطير أنّها لا تقاس بالعقل ولا تعقل بالقياس تؤخذ كما هي حتّى وإن كنت تعلم أنّها أحلام جميلة.
اليوم بعد عشرات القرون باتت الكتابة متاحة والجدران في الفضاء الافتراضي ممكنة، ونصوصنا تعلّق على جدران لم نشترها، ولا نحن اكتريناها هي جدران لنا بلا وثائق ملكية عليها نكتب ما لذّ وطاب ولا نسمّيه معلقة بل نسمّيه تدوينة. التدوين هنا ليس ذلك الحدث التاريخي الذي قرّر فيه الإنسان أن يجعل كلامها رهين المحبس الزمني، هو عبارات عابرة في لحظة تفاعل سطحي أو عميق.
من شأن الكلام أن يقال ويضيع، وهكذا كان كل كلام يخرج أصواتا تموت لحظة إنتاجها إن لم تجد ذاكرة تحفظها. الذاكرة ذات المدى القصير هي آلية تخزين وقتية، بعض الدارسين يعتقدون أنّ سعتها المحدودة لا يمكن أن تتجاوز سبع معلومات ضرورية للمعالجة الآنية للأفعال أو للأقوال. لكنّ الذاكرة ذات المدى الطويل تشكل الذاكرة طويلة الأمد مساحة تخزين شبه دائمة للمعلومات والخبرات التي تم تعلمها. الكتابة ذاكرة طويلة المدى لا يمكن محوها إلاّ بحرق ما دونت عليه وكذا فعل الجبّارون كارهو الذاكرة في التاريخ. لم تحتفظ المعلقات بذاكرتها لدينا على مدى قرون، إلا بعد أن كتبت كتابة بالحبر. ومن العجيب أنّ شيئا ظلّ حيّا من عهد المعلقات هو البيت والتعليق والحائط أو الجدار.
البيت الشعري في الشعر قد لا يكون استقى اسمه من الكعبة، ولا نريد أن ندخل إلى بحث تأصيلي ليس لنا فيه أيّ حجة؛ لكنّ البيت بالمعنى القديم كان اسما غير محايد، عدم حياده يصل درجة القداسة. سحر البيت أنّه مستغلق على هوية ما فيه لا يمكن أن يبوح بها. أن يبنى بيت للعبادة فذلك سرّ معناه، أنّه محلّ يمكن أن يبوح به العابد لمعبوده ما يريد ويظلّ بَوْحُه فيه سرّا لا يعلمه غير العابد ومعبوده. كذلك سحر ما في البيت الشعريّ أنّه وحدة إيقاع موسيقي منغلق دلاليا على ذاته، سحره أنّه كلام ليس كالكلام العاديّ، وقيل بنظم هندسيّ البناء لا ينفتح لأيّ كان؛ والشاعر فيه يصلّي في هيكل الحبّ كما كان الشابي يقول. أمّا التعليق فهو عبارة ظلّت حيّة حتى يومنا في حياة كتابتنا الإلكترونية. ما زلنا نكتب على الحيطان مثلما كان يفعل الإنسان الأوّل في العصور الأولى، حين كانت الكتابة رسما. كانت رسوم الكتابة الهيروغليفية تعجبنا، ولكنّ اتضح لنا أنّها لم تكون رسوما، بل كتابة فكرية كلّ رسم فيها يحيل على فكرة. وكانت ورقة الإنسان منذ عهوده الأولى طينية، أو حجرية قبل أن يصبح بالرفاه كاتبا على البرديّ. نكتب اليوم على حيطان إلكترونية وحين يكتب لك صديق شيئا يسمّى ذلك تعليقا. لست أنت من يعلق النص على الحائط أنت كاتب، وإن شئت قلت مدوّن أمّا هو فمعلق كأنّما وجد لكي يثبّت لك نصّك الذي قلته. قد نتبادل الأدوار في التاريخ ولكنّا لم نغير كثيرا من مسرحية الكتابة لم ننس أدوارنا، رغم أنّا كبرنا فالكتابة لا تنسى حين نعطيها أمانة حفظ فكرنا فتحفظ نفسها قبل أن تحفظه وتحفظنا.
*أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية.