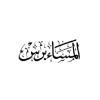اخبار اليمن
موقع كل يوم -شبكة الأمة برس
نشر بتاريخ: ٣٠ حزيران ٢٠٢٥
أوات محمد أمين*
يحاول محمد خضير سلطان من خلال روايته «شبح نصفي» أن يقدم للقارئ شكلاً جديداً غير مألوف للنص الروائي، أو أن يعرفّه على الزاوية التي من خلالها يمكن رؤية المشهد السردي وظهور معالم الرواية بالصورة التي رسمها، فهل يريد أن يقدم شكلاً روائياً جديداً، أم يبغي أن يعرّف القارئ إلى محاولة جادة باتجاه نوع من التحديث يتعلق بإنشائية وتطورية صنعة الرواية في مجتمعاتنا؟
في الواقع، أن المؤلف سلطان، كما يؤكد في كتاباته السوسيونقدية، قد جمع بين الحالين إذ يرى أن صنعة الرواية لما تزّل مبكرة عندنا، فلم تشهد مجتمعاتنا تحولاً حقيقياً، تستطيع معه الكتابة الروائية أن ترقى إلى استنبات التربة الفنية والتقنية الخصبة، التي تعبر عن تغيير حقيقي في الحياة ويُعقّب عليه في الفن، والذاكرة العميقة الرافدينية والفرعونية، ليست سوى أثر مندرس تحت رمال آشور وطيبة، تحاول الكتابة أن تستعيده باستمرار، في الوقت الذي تَحرتّه لصالحها منظومة الاستشراق.
يبدأ الكاتب بتقديم ما يمكن تسميته بمقدمة توضيحية او تعريفية عن روايته، بدءاً بـ»نبذة تقنية» ومن ثم «المتن الحكائي» وأخيراً «إشارات أخر» وكأنه يقصد بذلك جلب انتباه القارئ إلى المعالم غير المألوفة لعمله الفني، فنحن (أقصد الجيل الذي أنتمي إليه) قد تعلمنا وتعودّنا على تعريفات عتيدة وراسخة عن الرواية، من حيث البناء الفني واللغة والسرد والشخصيات والملامح المشتركة للرواية بشكل عام، لكن مع المضي قدما بقراءة هذه الرواية، نكتشف أنها تتجاوز الأطر النمطية للبناء الروائي، خاصة في ما يتعلق بالسرد والخيط الدرامي لينقلنا إلى آفاق متوازية للأحداث والمرويات لكن باختلاف الألوان.
وكاتب الرواية يتمتع برؤية نقدية وتحليلية واسعة، كما يتضح ذلك من خلال مقالاته النقدية الأدبية والفنية، ولكن عندما نقف أمام نتاج أدبي له من صنف الرواية فمن الطبيعي أن تتبادر إلى أذهاننا أسئلة مختلفة تتصل بمقارنة ولو ضمنية بين محمد خضير سلطان، ناقداً وروائياً من حيث القدرة على إنتاج نص متقن وجميل من الجوانب المختلفة. هنا أود أن ألخص آرائي وملاحظاتي حول الرواية الصادرة عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق بطبعتها الأولى عام 2018، في ما يتعلق ببعض الجوانب التي أجدها جديرة بالتوقف عندها.
تجاوز المألوف في تقنية الكتابة
رغم أن الكاتب أشار في المقدمة التعريفية للرواية إلى أن المتن الحكائي يقوم على هجرات عائلة في تنوع الجغرافيا الثابتة وعمق التاريخ شبه المتحوّل، لكن لا نجد خطاً درامياً واحداً، أو متصلاً للأحداث في الرواية ضمن إطار زمني محدد، ما يوحي بغياب الحبكة بمعناها المألوف، بل نجد أنفسنا أمام مرويات، أو بالأحرى مرويتين تمثلان مستويين مختلفين من الحدث، الأولى تمثل فصولا من تاريخ العائلة (عائلة آل فالح) التي تمثل الشخصية الجمعية الرئيسة في الرواية، وفصولا من التاريخ السياسي للعراق خلال مئة عام (أي منذ تكوين الدولة العراقية الحديثة بداية العقد الثاني من القرن العشرين إلى بعد سقوط سلطة البعث عام 2003). إذن.. منذ البداية يتعرف القارئ على سردية مستحدثة وغير مألوفة من حيث البناء الحكائي في غياب الحدث الرئيس، حيث هناك خطان دراميان يتماشيان بالتوازي مع فصول الرواية. كذلك في انتقال صيغة السرد من المتكلم إلى المخاطب والراوي.
أعتقد أن الكاتب اعتمد على تبني تقنية غير مألوفة في كتابة الرواية، وأراد قبل كل شيء أن يختبر أو يبرهن على قدرته على بناء جديد خارج الأطر المعروفة، وذلك يبدأ من تحطيم وحدة المكان والزمان والحدث، أو التمحور حول الحبكة أو الثيمة الرئيسية، كذلك نجد النهاية المفتوحة للرواية، «ربما يتنازل أحد عن إدارة تركات الموتى، ولكن لا يجرؤ على تسجيلها باسم الأحياء ويُقتّل الناصر وزيدان لكي تنتقل مواقع أشباحهما إلى آخرين».
اللجوء إلى لغة الرمز والتشابه الحدثي
إذا كانت عائلة آل فالح ترمز إلى العائلة العراقية بأبعادها الاجتماعية والتاريخية والسياسية (مع الاخذ بعين الاعتبار الدلالة الزراعية للاسم لوجود تقارب اشتقاقي مع كلمة فلاح) فإن المروية الثانية ترمز إلى التاريخ السياسي للطبقات، أو الأحزاب التي توالت على الحكم والسلطة في العراق خلال قرن من الزمن، كما لم يتردد الكاتب في الاستعارة الإسمية لبعض الشخصيات السياسية التي لعبت دورا محوريا في صناعة الأحداث المهمة خلال تلك المدة مثل (يوسف سلمان، الناصر الكبير، عبد الله العامر، حسن سريدح، ريحان ضيول وغيرهم).
كذلك نجد التماثل بين دفاتر الأب (مذكراته) و(الخزانة النحاسية) حيث ترمز إلى التاريخ المضطرب أو الميراث السياسي لبلد لم يشهد الاستقرار كحال آل فالح في ترحالهم، كما في نزاعاتهم الداخلية على الملكية، التي تماثل الصراعات المستمرة على السلطة وغياب السمة الأساسية الجامعة في الحالتين (أي غياب عائلة متماسكة رصينة ترمز إلى الشعب وقوى وطنية مسؤولة ترمز إلى سلطة وحكم وطني) رغم تذكر البعد الأسطوري لنشوء العائلة (أبناء حورية البحر) كما ترويها الجدة.
لغة الرواية بين السردية والوصفية
اللغة تشكل العنصر الأساس في صناعة الرواية ومنها تنطلق الأحكام الأولية على قوة الرواية أو ضعفها باعتبارها صنفاً ادبياً مميزاً، كما أن القارئ اعتاد أن يتفاعل مع اللغة حسياً حتى قبل التعرف على الملامح الرئيسية للعمل الأدبي. أستطيع القول إن السمتين الأساسيتين اللتين تميزان كاتباً عن غيره هما اللغة والأسلوب.
اعتمد الكاتب سلطان في روايته على لغة سردية دقيقة في الصياغة والتعبير، كما نجدها في اختيار المفردات والصفات التي يوظفها لغرض إكمال ملامح الشخصيات والمحافظة على النسق العام للرواية، وليس لغرض التوصيف والتأثير على مزاج القارئ، كما نجده في بعض الروايات التي تلجأ إلى لغة شعرية إلى حد ما.
أخيراً يمكنني القول إننا أمام رواية قد تكون سياسية وتاريخية في آن واحد من حيث الزمان ومساحة الأحداث التي تتناولها، التي تمتد من عشرينيات القرن المنصرم إلى يومنا الحاضر. إنها دوامة مستمرة وحكاية أزمان حبلى باللامتوقع وأجيال تنتظر دورها في مسرحية مجهولة التأليف والإخراج.
*كاتب عراقي