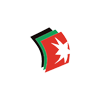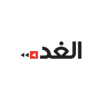اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة رم للأنباء
نشر بتاريخ: ٣ تموز ٢٠٢٥
رم - ترى، ما الذي يدفع راشدًا إلى أن يسرع نحو الشعر، ليكتب إليه رسالته التي عنونها بـ(العاجلة إليه)؟
أهو يلاحقه، كأن الشعر هارب منه؟ أم يبلغه أخيرًا، وهو في ضيق الوقت، لا يجد فسحة إلا للكلام؟
وهل يكون الشعر، يا راشد، كائنًا يبصر الشعر، بل ويقرؤه أيضًا، بعد سنين طوال من المعايشة والنظم، لا بل من إمضاء الحيوات معه وفيه.
يقدّم راشد هذه القصيدة بوصفها سيرة حب مكتملة، نشأت بينه وبين الشعر، ولم تفتر. في هذه القصيدة، يقدم راشد كنهه و فقهه و سيرته الذاتية للشعر، نعم، قل أوراق اعتماد، أو قل تجديد ثقة، أو قل عقدا وثيقا يمكّن بأيمان مغلظة فلا شاردة ولا واردة في حياة الشاعر، إلا و يتخللها الشعر، وأجزم أن لا خلية في جسده الممتدة به، إلا وهو متغلغل فيها، تكاد تتحول جيناته إلى قوافٍ، ودماؤه إلى أهازيج شعرية، وقلبه إلى بحور عارمة بالوصف والغزل و المدح والغواية.
إي راشد لقد وثقت علائقك بهذا الساحر، وأنشبت أظافرك في كينونته، فاستحلتما واحدا، لا شريك لكما إلا الحب، الذي لا يخان ولا يخون.
بلغت لغة راشد الشعرية ذروة سنام نتاجه الشعري، إذ أمسك ناصية لغته مطواعة له، تنقاد بين يديه دون ممانعة، أو مقاومة، يجتاح عالم الشعر معلنا نفيرا عاما استدعيَ له التاريخ والجغرافيا، في جدارية جامعة مانعة لكنه الشعر، ومعنى الشعر، وسحر الشعر. شخصنه، حاوره، أسبغ عليه صفاتا ظاهرة وباطنة، وكأنهما خلقا واحدا منذ الأزل، ينبعثان واحدا بعد سباتهما، لا فرق بينهما ولا يعتروهما خلل.
استدعاء للتاريخ الجاهلي في امرئ القيس، والشنفري، وعباسي في البحتري، ابن زيدون الأندلسي وولادة، ويرى ما لا يراه المعري، في ظلمة دجاه ومنفاه. استشراف أزلي لهذا المخلوق السحر، الصحراء، البراري، الزهر، النجوم، الشجر. جغرافيا الكلمة، تنساح في ثغرات العمر، فتملأ عليه كيانه، وتنظم فيه فوضاه.
هذا الأثيري الذي يفضي إليه ويفضي إليه هو الآخر، في بوح متماه لا يعوزه الصدق والرتق، فالصدق تيمة الكبار الأجلاء، وينجده من كل نكبة وورطة، فيشعل تارة سراجه في ظلامه، وهو ملاذه من أوجاعه المختزلة في عمره يتوسل إليه ألا يخيب أمانيه وألا يقطع له رجاء، هو الوحيد من يصدقه، إذا ما خون، يبذؤه بالسلام ومنتهى وصفه له فيه كل السلام
يستسلم لهذا الغوي، ويتوسل إليه، يرجوه، يشكره، يعلي شأوه ينساح بكليته معه يمزج بين تفاصيله والشعر، يربت على نفسه فيه، ويتوسل كي يعطيه
لكن السؤال؟
هل هذه العلاقة الظاهرية في الشعر متماهية بينهما حتى النهاية؟ وهل بادل الساحر شاعرنا تلك المشاعر و الإخلاص المتتالي، وهل تفانى كما تفانى الشاعر في حبه ووجده؟
الجواب نستخلصه بداية من العتبة، التي عنونها برسالة عاجلة إلى الشعر
يحمل عنوان القصيدة 'رسالة عاجلة إلى الشعر' توترًا دلاليًا منفتحًا على تأويلات متضادة، تبدأ بالتساؤل البنيوي حول إمكانية الجمع بين مفهوم 'الرسالة' بوصفها شكلًا منتظمًا، هادئًا، ذا اتجاه محدد، وبين صفة 'العاجلة' التي تشتمل على استعجال، قلق، واستنفار زمني. فكأننا أمام تعبير متنافر – وفق اصطلاحات بول ريكور – بين 'الانتظام والاندفاع'، أو بين 'العقلنة والهلع' بما يحيل إلى أولى الإشارات التوترية للنص.
تقتضي الرسالة – من حيث بنيتها التواصلية – وجود ثلاثية: مرسِل، مرسَل إليه، ورسالة. غير أن هذه المعادلة تنقلب داخل القصيدة؛ إذ يُطرح التساؤل التفكيكي: من الذي أرسل الرسالة؟ هل هو الشاعر؟ أم اللغة؟ أم النص نفسه بوصفه 'كتابة' مستقلة عن النيات؟
تبلغ هذه الجدلية ذروتها حين يتحول الشعر – الذي يفترض أن يكون مفعولًا به إبداعيًا – إلى فاعل يتلقى الرسائل، أو يُرسلها، أو حتى يتحكم في بنيتها وتكوينها. وهنا نجد أن الشاعر لم يعد ذاتًا مهيمنة – كما في التصورات الكلاسيكية – بل أصبح 'تابعًا' لخطاب يُملى عليه من خارج الذات، وهو ما يوازي أطروحة دريدا في 'هدم مركزية المؤلف' و'تفكيك سلطة النية
وبهذا، يتحول الشعر من كونه منتوجًا للذات إلى سلطة عائمة، تتبادل المواقع مع منتجها، فتُبطل الفاعلية الأحادية وتدخل في دائرة من التشظي والتبادل والتناوب. وكما يذهب دريدا، فإن 'النص لا يملك مركزًا، بل هو شبكة متداخلة من العلامات التي تحيل إلى علامات أخرى بلا انتهاء'
في ضوء ذلك، فإن عنوان القصيدة لا يمثل فقط عتبة نصية، بل هو مدخل لتقويض بنية المعنى، خاصة وأن الرسالة تبدو مشحونة بـ “تيمة الخبر العاجل'، في استعارة من الخطاب السياسي والإعلامي، مما يضفي على العنوان طابعًا دراميًا فيه قلق إنذاري وتحذيري، وهو ما يُخالف الصورة النمطية عن الشعر بوصفه حقلًا للتأمل الجمالي والتجريد الرمزي.
ومن هنا، فإن الانتقال من دلالة الرسالة الواقعية إلى الشعر، بوصفه مجالًا رمزيًا، يحدث قطيعة أبستمولوجية ظاهرية في المعنى، ويخلق انزياحًا عن البنية التقليدية للفهم.
هذا الانزياح يؤسس، وفق دريدا، لتحول النص من مركز دلالي إلى حالة من الانفجار التأويلي، 'حيث لا يعود النص قادرًا على تقديم معنى واحدا، بل هو دائم الترحال بين معانٍ تتجدد وتتكاثر كلما أعيدت قراءته'
وبذلك يصبح العنوان – لا القصيدة فحسب – حقلًا لتفكيك الثنائيات المركزية التي تقوم عليها بنية الفهم التقليدي:
الشاعر / الشعر
المرسل / المتلقي
الخطاب / المعنى
اللغة / الفكرة
النص / الذات
إن تحليل هذه الثنائيات وفك تشابكها، لا يؤدي إلى معنى ثابت، بل إلى معانٍ متجددة، لا نهائية، وهذا هو جوهر القراءة التفكيكية.
'لا توجد نقطة انطلاق بريئة للنص، فكل نص هو دائمًا تكرار أو صدى، '
والآن يحق لنا أن نسأل بصوت مدو هل يخاطب الشاعر الشعر حقا؟ أم شيئًا آخر؟ أم أشياء أخرى؟
أولًا: ظاهر النص كما ذكرنا في المقدمة تقدمه القصيدة ككائن حي:
ففي ظاهرها تخاطبه مباشرة ككائن حي، مفعم بالقداسة، والإلهام، والقوة، والصداقة، والخذلان أحيانًا. يتجلى ذلك في:
النداء المباشر المتكرر: 'يا شعر'، 'أشعل سراجك'، 'خذني إليك'، 'فبأيّ كيفَ سَهَوْتَ عني'.
نسب الصفات الحية للشعر: مثل العتاب، الحب، الغضب، العشق، الجفاء، الغياب، الحضور، وحتى 'شرب القهوة'.
هذه العلاقة تُماثل ما فعله نزار قباني عندما جعل من القصيدة حبيبة، أو محمود درويش عندما خاطب الوطن كما لو كان أنثى، أو أدونيس عندما خاطب الزمن كما لو كان طفلاً.
ثانيًا: الباطن، ما وراء المعنى، أو معنى المعنى – الشعر كرمز للذات/الأنثى/الكتابة/الوجود:
رغم أن ظاهر القصيدة يخاطب 'الشعر'، فإن المتلقي الحاذق يدرك أن هذا الخطاب فيه طبقات متعددة من الرمزية، فالشعر هنا قد يكون:
1. رمزًا للذات العليا (الهوية الشعرية – الأنا الشاعرة):
'لم أنْتبهْ يا شِعْرُ أنّي واحدٌ.. ما أكْثَرَنّي!!'
تركيب متفرد بإضافة النون الثقيلة، التي توحي بثقل الهموم و تكدسها في عوالمه الروحية و النفسية، فلا ىيكاد معها يلتقط أنفاسه، في لإشارة إلى انشطار الذات وتعددها في مرآة الشعر. فكأن الشاعر يخاطب نفسه التي يسكنها الشعر.
2. رمزًا للحب المفقود / الأنثى / الحبيبة:
تتقاطع القصيدة مع لغة العشق الصوفي والوجداني، كما في:
'أنتَ الذي عَشّمْتَني بحبيبتي، وقصيدتي، وصَدَدْتَ عني.' 'فَلَكَمْ أحَبَّكَ زنْجبيلي!! كمْ أَجَلَّكَ زعْفراني!!'
هنا يشفّ الخطاب ليشير إلى علاقة عشق خائبة أو حب غائب تم إسقاطه على 'الشعر' كقناعٍ بلاغي. ولا شيء قادر على استبطان كمائن الحب كالخيبة فيه؟؟
3. رمز للكتابة والإبداع والهوية الثقافية:
الشعر هو خلاص الشاعر من أوجاعه، وصاحبه في الاغتراب:
'ما زِلْتُني في ذِمَّةِ الريحِ التي هَدَمَتْ خِيامي...' 'فأنا الحنينُ، أنا الهنيين، أنا الأنينْ.
كأن الشعر قارب نجاةٍ روحيّ في محيط من الانكسارات الذاتية والوجودية
خلاصة تأويلية:
ربما يكون فعل الكتابة خلاصا وجوديا، يتماهى مع مراد الشاعر من انبعاث كل تلك الرسائل العاجلة إلى الشعر
وفي أحايين كثيرة يمثل الشعر خلاصا وجوديا ويمكن اعتبار الشعر في هذا النص مجازًا مركزيًا يشفّ عن خيبة وإخفاق في الحب، واغتراب وجودي رغم كل المؤنَسات في حياته، وحنين إلى النقاء في ظل فوضى التلوث النفسي ، ورفض للخذلان الذي يتعرض له بعد تضحيات و بذل، وحلم بالاحتراق الجمالي .
التفكيك: تفكيك الثنائيات الضدية في القصيدة
1. الشاعر / الشعر
في المقطع الأول، يتوجه الشاعر إلى الشعر ككائن حي:
'أرْجوكَ سَلِّمْ لي عليْكْ،
وَلْتَطْمَئِنّْ.
إنّي بخيْرٍ يا صديقَ العُمْرِ...'
هنا، ينقلب دور الشاعر من منشئ للشعر إلى تابع له ومخاطِب له وكأنه قوة وجودية أعلى. وهنا نرى انزياحًا عن مركزية الذات المبدعة نحو مركزية 'الشعر' نفسه، الذي يبدو أنه يمتلك حضورًا مستقلاً وسلطة رمزية.
تحليل تفكيكي:
دريدا يفكك سلطة 'الكاتب' و'النية'، ويؤكد أن النص لا يملكه أحد، بل 'يتكلم من تلقاء ذاته'. القصيدة تجسد هذا حين يظهر الشاعر خاضعًا لقوة الشعر، لا موجهًا لها.في هتك واضح للعلاقة الطبيعية بين الشاعر و الشعر بين المبدع و المبدع
2. الرسالة / الاستعجال
'رسالة عاجلة إلى الشعر'
تبدو الرسالة فعلًا منظمًا، بينما 'العجلة' تمثل اضطرابًا. كيف يجتمع النظام مع الفوضى؟
تفكيك المفارقة:
هذه الثنائية تنهار حين ندرك أن الشعر نفسه هو فوضى منظمة، أو نظام منفتح على اللايقين. فالشاعر يحاول أن يضبط الشعر، لكنه يُسلم بأنه لا يسيطر على مجازه ولا على تأويله. لذلك تراه ينشده، ويرتجيه، ويطلب منه.
3. الحضور / الغياب
'أَنَا لا أنا يا شِعْرُ – لو تدْري– أنا
نيرانُ ماءْ.'
هنا يذوب المعنى في تناقض وجودي: 'أنا لا أنا'، 'نيران ماء'. هذا التفكك في الهوية يعكس المفهوم الدريدي لـ اختفاء الحضور وغياب الجوهر الثابت. تنهار في النص الثنائيات التقليدية التي تقوم عليها المعاني، فيصبح الحاضر غائبًا، والذات آخرًا، والمعنى لا معنى. فالشاعر يتحدث إلى الشعر وكأنه يخاطب ذاته، أو بالأحرى ظل ذاته المبعثر فالضمير في القصيدة يتحرك بين 'أنا' و'أنت'، مما يُظهر تهشم الحدود بين الأنا والآخر:
أشعل سراجك كي أضيء
هذه التبادلية تقوّض مركزية 'الأنا' وتفتح النص على فضاء من التعدد الداخلي فالشعر ليس 'آخرًا' بالمطلق، بل هو قناع لغوي من أقنعة الذات.
تأويل:
الشاعر هنا في 'لعب تأويلي'، حيث الذات تتشظى، والمعنى لا يُمسك به. وهذا يتماهى مع أطروحة دريدا أن 'الحضور دائمًا مؤجل ومؤطر بعلامات الغياب'.
4. المعنى / المجاز
'ويذوبُ بين مفاتنِ الإيهامِ
رمزًا أو قِناعا'
يصف الشاعر الشعر كمجال للإيهام، لا للحقيقة؛ وبالتالي، ينفي عن الشعر كونه حاملًا لمعنى نهائي، بل هو مساحة لعب رمزي.
تفكيك:
المعنى هنا لا يُقصد لذاته، بل يُستعاض عنه بالمجاز، الذي هو أصلًا نقيض للثبات والدلالة القطعية. وهذا يعزز القول الدريدي: 'المعنى لا يتحقق أبدًا، بل يؤجل في سلسلة لا تنتهي من
الإحالات.'
5. الشعر / الوطن
'لي في مرابيعِ الجزيرةِ نخْلةٌ
تُؤْوي أمومَتُها عصافيرَ الخليجْ.'
هنا يتماهى الشعر مع الجغرافيا، الوطن، والهوية. يتحول الشعر إلى هوية متحركة تعبر الحدود. لكن هذا التماهي لا يستقر، لأن الشاعر لاحقًا يشكو:
'فبأيّ كيفَ سَهَوْتَ عني يا مُهنْدسَ غُرْبتي؟'
الوطن/المنفى لم يعودا ضدين. بل الشعر ذاته أصبح منفى ومعًا ملاذًا، أي أنه ثابت/متحول، حميم/خائن.
2- تفكك الزمن والمرجعية
النص لا يتحرك في خطّ زمني مستقيم، بل يتشظى إلى ومضات من النداء، والعتاب، والتذكر، مما يُسقط البنية الزمنية التقليدية. فمثلًا يقول الشاعر:
'مرّت عليَّ دهورٌ وأنا أبحث عنك'
'كلّما اقتربتَ، تلاشى صوتك'
الزمن هنا ليس تطورًا أو تتابعًا، بل هو استعادة مستحيلة، زمن التأجيل المستمر الذي لا يتحقق. وهذا يعكس انزياحًا تفكيكيًا عن زمن القصّ أو الاعتراف، نحو زمن 'اللا اكتمال'.
3- لعب اللغة وتوليد اللاقين
تحضر اللغة في القصيدة بوصفها أداة للانزياح، لا للتثبيت؛ للتشظي، لا للتحديد. حين تقول:
'أشعل سراجك كي أضيء'
فهي تخلق من 'الإضاءة' فعلًا مؤجلاً ومشروطًا، لا يتحقق إلا بمشاركة الآخر الذي يتوارى في كل مرة.
' يا شعر ساعدني على فلم يزل
في البال متسع لحلم باسل عذب
بهيج'
ينشد الشعر، ليعينه على تحقيق حلم لما يتحقق بعد، يغيب يقينه تحقق الحلم، مع استمرارية نداء الشعر لتحقيقه.
' سرب حفيفك في عظامي'
يرجو الشعر لينساب فيه بكليته، يتخلل جسده وعظامه، ليحقق له الوصول بعد التعب، واليقين بعد الخذلان
'أطلق صهيلك في حصاني'
ويقال على هذا التركيب كما في غيره من التراكيب السابقة، فهو يؤجل إطلاق صوته المتمثل بالصهيل، حتى يقرضه هذا الصهيل، فيكون في حصانه، وفي ذلك استجداء للقوة، و النبرة العالية، التي لا يجدها إلا في الشعر
كما أن تكرار الجمل الندائية، والأسئلة، والجمل المعلقة، يجعل من النص بنية قلق لا تقطع بيقين. وهذا ينسجم مع التفكيك الذي يرى أن اللغة لا تُنتج الحضور، بل الغياب
4 الذات بوصفها أثرًا لغويًا
من خلال مقاربة تفكيكية لقصيدة 'رسالة عاجلة إلى الشعر'، يتبيّن أن الذات الشاعرة لا تظهر بوصفها كيانًا متماسكًا، بل كأثر لغوي يتشكل في لحظة الكتابة ويتفكك فيها فكل محاولة لتثبيت 'أنا' تُقابل بتقويض لها. لا تقول القصيدة 'أنا'، بل تقول: 'أنا لا أنا'.
هكذا تنقلب 'الرسالة العاجلة' إلى كتابة مؤجلة، لا تفضي إلى خلاص، بل إلى لا يقين مفتوح، يُفكك ولا يُركّب، يهدم ولا يُشيّد، تمامًا كما أراد دريدا للنصوص أن تكون
أنا لا أنا، وهي أنا: الشعر بين تفكك الذات ورمز الغياب في 'رسالة عاجلة إلى الشعر
خلاصة ......في ضوء نظرية دريدا
وفق نظرية التفكيك، فإن هذه القصيدة تقدم نموذجًا لما يسميه دريدا 'الاختلاف difference': المعنى لا يتحقق، بل يتولد من الفروقات والانزياحات، وهو دائم التأجيل. القصيدة مليئة بما يسميه دريدا 'أثر المعنى trace'، أي أن كل بيت يشير إلى ما قبله وما بعده دون أن يستقر.
القصيدة 'رسالة عاجلة إلى الشعر' هي نص غني بالشحن الوجداني والرمزي، ينهل من منابع الشعر الصوفي والرومانسي والرمزي، ويتقاطع مع نَفَس درويشي وأدونيسي في مخاطبة المفاهيم المجردة بلغة حية نابضة.
الموسيقى الشعرية في 'رسالة عاجلة إلى الشعر'
1. الموسيقى الخارجية:
القصيدة مكتوبة على هيئة شعر حر (تفعيلة)، ما يمنح الشاعرة مساحة واسعة من الانزياح الإيقاعي والتعبيري. الموسيقى الخارجية لا تتقيد بوزن أو قافية موحدة، لكنها تستند غالبًا إلى إيقاع داخلي متكرر يمنح النص توترًا وتوازنًا.
تظهر جمالية الموسيقى في التكرار البنيوي لعبارات مثل:
'وَعَلَيْكَ يا شِعْرُ التحايا والسّلامْ…'
'يا دانةً دانتْ لسلطتها اللآلئ…'
هذا التكرار يولّد موسيقى نفسية توازي وقع الإنشاد، وهو ما يُطلق عليه الإيقاع الدلالي عند 'جان كوهين' في كتابه البنية اللغوية للشعر
2. الموسيقى الداخلية:
تعتمد على:
التوازي التركيبي (مثل: 'يا من لسحرك …'، 'يا من لوهجك …') وهو يخلق تردادًا موسيقيًا خفيًا.
التجانس الصوتي عبر توظيف الجناس والاستبطان الصوتي، كاستخدام صوت 'السين' و'الشين' و'اللام' لخلق سلاسة:
'سلطتها، أصداف، الكلام، اللآلئ…'
كما أن التكرار الصوتي يذكّرنا بما ذهب إليه عبد الملك مرتاض في حديثه عن التكرار البنائي في الشعر المعاصر بوصفه 'موسيقى خفية تنوب عن الوزن حين يتفلت' (في نظرية القراءة والتأويل
توالي الكلمات المتماثلة في النهايات المدية من مثل:
'أنا الحنين، أنا الهنين، أنا الأنين
يؤنس السمع هذا التوالي ويطمئن الأذن إلى وجود متتالية منسجمة تذكي الذوق وتعلي الانسجام مع الملفوظات المتشابهة في موسيقاها، في طريقة الطرب والشدو التي تثير المتلقي ليتمايل مع هذه المتواليات طربا وإعجابا
في الرغيف
وفي الخريف
وفي النعيم
وفي السديم
توالي الحروف الصفيرية ممن مثل حرف السين في
وساوسها
وهسهسها
توحي إلى معنى الهمس، والانزلاق، والخفة والارتياح في توالي النفس، ليغدق على السامع، التفاتا لهذا الصوت الذي يدل على الحركات النفسية الخبيئة، المراوغة، واللاإرادية.
وجوانحي
وجوارحي
الجوانح متعلقة بالموسيقى الباطنية والجانب النفسي التي تصلح للقلب، والاضطراب، والعاطفة
أما الجوارح فهي موسيقى جسدية عملية، تصلح للفعل، والاضطراب، والاستجابة الحسية.
ثانيًا: المعجم اللغوي
المعجم في القصيدة يتسم بسمتين متقابلتين: الفخامة والرقة، وهو ما يضفي على الخطاب الشعري توازنًا شعوريًا بين الهيبة والحنين.
1. الحقول الدلالية:
نلاحظ حضورًا لافتًا لعدة حقول:
أ. المعجم الوجداني (الحنين، الحب، العتب، القداسة):
كلمات مثل: 'التحايا'، 'السلام'، 'أصداف'، 'دانَت'، 'اللآلئ' تنتمي لحقل شعوري رقيق، يحمل نبرة توق إلى زمن شعري نقي. متلفع بصفاء المشاعر الفطرية التي تشي بالبراءة والتجرد عن الهوى فهالة القداسة تحيطها، وتربت على منكبيها لتصوخ إلى أمر الإبداع فيها.
هذا التوظيف يدعم المعنى الكلي للقصيدة بوصف الشعر كائناً ساميًا يستحق خطابًا وجدانيًا.
ب. المعجم المقدّس / المهيب:
الشاعر عليه السلام، يلتقط أنفاسه الطاهرة على أعتاب وجدانه المذهب بالقداسة، يحشد لذلك تلك التعابير المؤنسة للنساك في معابدهم، فتراه ينتقي الاوسمة السماوية، ليتوج بها لغته التي اجترحها من قداسة شعره من مثل:
استدعاء الأفعال بصيغة الخطاب المباشر (وَعَلَيْكَ يا شِعْرُ)، يوحي بأن الشعر ذاتٌ تستحق المقام الرسولي. فيسرع إلى الألفاظ التي تدل على التقديس: 'دانَتْ'، 'سلطتها'، 'اللآلئ'، التي تضفي على الشعر هالة شبه ميتافيزيقية، وهذا يتوافق مع مقاربة بول ريكور في تحليل الخطاب الشعري الرمزي
جـ - عزف منفرد:
يملك راشد خاصية الاشتقاق الشعري، ممازحا اللغة في تراكيب لم يصغها غيره بطريقة تؤكد سبره عوالم اللغة يلوي عنقها لتحقق له غايته في الاستثمار المعجمي الراشدي، حيث تطرق الأسماع تعابيرُ لم تطف على غير قصائده، ولم تدر إلا في فلك وحيه الشعري المتفرد
ما أكثرني
أرجوك سلم لي عليك
الناي دوزنني
أنساح في ميماي
من كوكبك؟
أثثتني
هذا التفرد المتمايز في اجتراح معجم حدائقي، أو بستاني، أو جمالي، في إحالة أطوار النبت فيه، وتمثله تلك الحالات النموية للنبات، بطريقة التشخيص الذي لا الإنساني بل النباتي لنقل نبتنة الشاعر، فها هو ينعنع، ويتسوسن، و يتبستن
نعنعت شوك المفردات، و سوسنت رؤياك آلام المكان
بستنتني
استغراق لا محدود في اللغة، تشبع لا نهائي بها، فاللغة تسكنه، وتجري منه مجرى الدم، الذي يتدفق في أوردته دون توقف
د مي خالد بكليزي