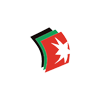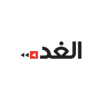اخبار الاردن
موقع كل يوم -صحيفة السوسنة الأردنية
نشر بتاريخ: ٥ تموز ٢٠٢٥
في نقاشات السياسة الدولية، يتردد رأي مفاده أن 'الصين لم تنشر لغتها كما فعلت بريطانيا وأمريكا، ولن تتمكن من مواجهتهما'. يبدو هذا الرأي مبنيًا على فرضية تربط بين انتشار اللغة وبين قدرة الدولة على التأثير العالمي، لكنه يُغفل تعقيدات التاريخ وتحولات موازين القوة الحديثة.
اللغة الإنجليزية انتشرت عبر العالم، ليس فقط لقيمتها الثقافية أو سهولتها، بل لأن بريطانيا ثم الولايات المتحدة ارتبطتا في أزمنتهما الصاعدة بحركات استعمارية، اقتصادية وإعلامية، فرضت اللغة بوصفها أداة للتواصل والتبعية في آنٍ واحد. انتصار الإنجليزية كان، إلى حد بعيد، جزءًا من تمدد النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي الغربي.
في المقابل، لم تتبع الصين نفس المسار. لم تكن لها إمبراطورية استعمارية بالمعنى الكلاسيكي، ولم تسعَ لفرض لغتها في المستعمرات أو عبر شبكات النفوذ الثقافي. عوامل متعددة ساهمت في ذلك، منها طبيعة الكتابة الصينية المعقدة، والانكفاء التاريخي، وفترات من العزلة السياسية والثقافية، خاصة في القرنين التاسع عشر والعشرين.
لكن هذا لا يعني أن الصين بلا نفوذ. على العكس، تنتهج الصين اليوم مسارات مختلفة لبسط تأثيرها، من خلال الاقتصاد، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، لا عبر اللغة أو القوة العسكرية المباشرة. مبادرة 'الحزام والطريق'، والشركات التكنولوجية الكبرى، وتوسيع النفوذ في أفريقيا وآسيا، أمثلة واضحة على أدوات التأثير غير التقليدية.
الرأي القائل إن 'الصين لم تغزُ في تاريخها ولن تستطيع مواجهة أميركا' يُبسّط الواقع ويغفل الكثير من المعطيات. تاريخيًا، خاضت الصين حروبًا عديدة، وسيطرت على مناطق مثل التبت ومنغوليا الداخلية، وشاركت في صراعات مع كوريا وفيتنام. صحيح أن فلسفة الدولة الصينية كانت تميل إلى المركزية والانكفاء، مقارنة بالقوى الاستعمارية الغربية، لكنها ليست خالية من السوابق التوسعية. كما أن بعض الباحثين، مثل جون كينغ فيربانك، يشيرون إلى أن “النظام الإمبراطوري الصيني قام على تصدير النفوذ من دون احتلال مباشر، لكنه حافظ على علاقات مركز-هامش مع الأطراف المحيطة'.
أما في الحاضر، فالقول بعجز الصين عن مواجهة أمريكا يبدو مبالغًا فيه. تمتلك الصين اليوم ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم، وتملك قدرات نووية، وجيشًا بحريًا متطورًا، ونفوذًا متزايدًا في الفضاء السيبراني. لكنها، رغم ذلك، لا تميل إلى المواجهة المباشرة، بل تعتمد على ما يسميه بعض المحللين بـ'الحرب الرمادية' — وهي مقاربة لا تعتمد على الصراع التقليدي، بل على التغلغل الاقتصادي والتكنولوجي والضغط السياسي غير المعلن. هنا، تبرز مقاربة وولرشتاين (Immanuel Wallerstein) حول 'الهيمنة بدون استعمار'، حيث تُمارس السيطرة عبر آليات السوق والمؤسسات لا عبر البنادق.
هذا التحول في أدوات التأثير يُعيد تعريف مفهوم الهيمنة الحضارية. الحضارات لا تُقاس بعدد المتكلمين بلغتها، بل بقدرتها على أن تُصبح مرجعية في نمط العيش والتفكير والإنتاج. الصين لا تسعى لأن تُدرَّس لغتها في المدارس الأجنبية، لكنها تسعى لأن يعتمد الآخرون على تقنياتها وسلاسل إنتاجها ونظامها المالي تدريجيًا.
كما أشار المفكر الجزائري مالك بن نبي، فإن 'الاستعمار يبدأ حين يُصبح الاستهلاك بديلاً عن الإنتاج'، وفي هذا السياق، يظهر أن الصين تسعى إلى أن تجعل من الآخرين مستهلكين داخل دائرتها الاقتصادية، حتى دون أن يتبنوا ثقافتها أو لغتها، وهو نوع جديد من التأثير قد لا يكون صاخبًا، لكنه فعّال.
مع ذلك، ثمة تحديات تقابل المشروع الصيني. من أبرزها محدودية البعد القيمي أو الرسالي. فبينما ارتبط النفوذ الغربي بخطابات مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، تتقدم الصين بمشروع أقرب إلى البراغماتية التقنية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول قدرتها على إقناع الشعوب بنموذجها الحضاري على المدى الطويل.
وأمام هذه اللوحة المركبة، تظل الأسئلة مفتوحة: هل نحن بصدد صعود نموذج صيني عالمي بديل عن النموذج الليبرالي الغربي؟ أم أننا أمام توازن جديد بين نماذج متعددة، كل منها يسعى لإثبات جدارته بوسائله المختلفة؟ ربما لن تُحسم الإجابة قريبًا، لكن من المؤكد أن معايير النفوذ العالمي لم تعد مرتبطة فقط بعدد الدول التي تتحدث لغتك، بل بمدى حاجتها إليك، واعتمادها عليك.
بالنسبة للعالم العربي، فإن متابعة الصعود الصيني لا يجب أن تكون فقط من باب الإعجاب أو التحذير، بل من زاوية استخلاص الدروس الاستراتيجية. لقد أثبتت الصين أن التمكين لا يشترط الهيمنة العسكرية أو فرض اللغة، بل يمكن أن يتم عبر التحكم في أدوات الإنتاج، والتكنولوجيا، وسلاسل القيمة العالمية. والعرب، الذين يمتلكون موقعًا جغرافيًا حاسمًا وثروات بشرية وطبيعية معتبرة، يستطيعون — إذا ما توفرت الإرادة السياسية والتكامل الإقليمي — أن يصوغوا نموذجًا خاصًا يجمع بين الخصوصية الثقافية والكفاءة الاقتصادية. لا أحد يمنع العرب من أن يكونوا 'مركز إنتاج' أو عقدة لوجستية عالمية، إذا نجحوا في تجاوز الخلافات الداخلية، واستثمروا في التقنية والمعرفة كما فعلت الصين بهدوء وتخطيط بعيد المدى.
وأمام هذه اللوحة المركبة، تتجلى فرصة نادرة: أن ندرك أن الهيمنة لم تعد محصورة في من يرفع رايته على الأرض، بل في من يجعل الآخرين يمرّون طوعًا تحت مظلته الاقتصادية والتقنية. فهل نكتفي نحن العرب بالمشاهدة والتعليق، أم نبدأ ببناء نموذجنا المتدرج، بعيدًا عن التقليد الأعمى للغرب أو الشرق؟ لعل ما نحتاجه ليس أن نُجيد لغة الآخر، بل أن نُجيد مخاطبة حاجاته بلغتنا نحن. ربما آن الأوان لأن يكون لنا مشروع لا يدور في فلك أحد، بل يرسم دوائره بهدوء واستقلال، كما فعلت الصين، وكما حاول الغرب أن يمنعه طويلًا.