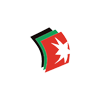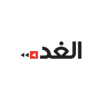اخبار الاردن
موقع كل يوم -صحيفة السوسنة الأردنية
نشر بتاريخ: ١٤ تموز ٢٠٢٥
في عالمٍ يزدحم بالأوراق، وتتكاثر فيه المؤتمرات والرسائل، تغيب الحقيقة الكبرى: كم بحثًا غيّر حياة؟ وكم نظريةً وصلت إلى الواقع؟
صرنا نكتب لنجتاز، لا لنبني. نُنجز لنُقيَّم، لا لنسأل أنفسنا: هل للعلم أثر، أم أنه أصبح حائطًا نُعلّق عليه الشهادات فقط؟
ليست الأزمة في غزارة البحث، بل في غربته. كأن العقل الأكاديمي انفصل عن نبض الناس، وراح يسبح في سماء المجلات والتصنيفات، بينما المدن تبحث عن فكرة تُضيء، أو حلّ يُخفف، أو رأيٍ يُنقذ. ما قيمة بحث لا يُقرأ خارج لجنة، ولا يُذكر خارج قاعة؟ وما الفائدة من أطروحة لا يشعر بها الناس في عيادة أو مدرسة أو مسجد؟
حين نربط الأوراق بالحياة، نردّ للعلم رسالته الأولى: أن يكون جسرًا لا متحفًا. لا بد أن يتحوّل كل مشروع تخرّج أو رسالة علمية إلى أثرٍ ملموس يُخاطب حاجة حقيقية في المجتمع. لا شيء يُعيد للبحث هيبته مثل أن يرى الناس ثماره أمام أعينهم: في خدمةٍ طبية أفضل، أو عدالة مصرفية، أو توعية دينية ناضجة.
لا يمكن لجامعة أن تنمو في عزلة. لا بد من ربط الكليات بالقطاعات الواقعية التي تعاني وتنتظر: أن تنزل مشاريع الهندسة إلى المصانع، وتُولد دراسات الطب في أروقة المستشفيات، وأن تُستعاد رسائل الشريعة في خطب المساجد، وتشارك كليات التخطيط في رسم ملامح المدن والقرى. حين تلتقي النظرية بالاحتياج، يصبح الباحث شريكًا لا مراقبًا.
الأمثلة ليست نظرية. في كل منطقة، ينبغي أن يتواصل إمام المسجد مع دكتور في الشريعة، ومدير البنك مع أستاذ في علوم المال، والطبيب مع أستاذ في الطب. وفي كل مصنع، يجب أن تُفتح جلسات مع خبراء المحاسبة في الجامعة، لا لأجل التدقيق فحسب، بل لأجل الشفافية والمساءلة والحوكمة. بهذه الجلسات الحوارية المنتظمة، تُؤخذ المشاكل من الواقع وتُبنى عليها الحلول العلمية.
كذلك، لا بد من منصة وطنية للأبحاث التطبيقية، تُحمّل فيها الأبحاث التي اجتازت معايير الجودة، لكن تُعرض بلغة إنسانية مبسّطة، يفهمها المسؤول والمواطن. بهذا فقط، تنكسر العزلة، ويتحول الباحث من ناطق بلغة النخبة إلى صانع أثر يُفهم في الشارع والبيت والوزارة.
ولِمَ لا يكون للصحف الرسمية الأردنية منبرٌ علمي؟ صفحة واحدة بعد كل إصدار علمي، نعرض فيها بحثًا تم تبسيطه وتلخيصه للناس، كما تُبسط القوانين والتشريعات. إذا لم يكن للبحث ملامح في الحياة اليومية، فما الذي يميّزه عن النثر العابر؟
ويجب أيضًا إعادة تعريف تصنيف الجامعات، لا على مبدأ الكثرة، بل على مبدأ الأثر: كم بحثًا أثّر في سياسة؟ كم تعاونًا نشأ مع مؤسسة أو حيّ؟ كم فكرة خرجت من الجامعة لتصير مشروعًا واقعيًا؟ هكذا فقط نُبدّل ثقافة 'نحن الأعلى في النشر'، إلى 'نحن الأصدق في التغيير'.
ولا يكتمل الطريق دون إلزام الوزارات والمؤسسات بأن تفتح أبوابها للعقل الجامعي، أن تُنشأ وحدات تنسيق تنقل مشكلات الميدان إلى الباحثين، وتحمل اقتراحات الباحثين إلى متخذي القرار. إذا لم تكن الدولة نفسها 'زبونًا' دائمًا للبحث، فلمن نكتب؟
ثمّة توصية بسيطة لكنها حاسمة:أن يُعرض كل بحث علمي، أكان تخرجًا أو ماجستير أو دكتوراه، في يوم مخصص في الكلية، بحضور الأساتذة والطلاب وممثلين عن المجتمع والقطاعات المهنية. هنا فقط، تتحرر المعرفة من سجن الأوراق، وتدخل امتحان الواقع. حينها، يصبح العلم صادقًا لا صامتًا، وشاهدًا لا صوريًا.
وليس البحث مجرّد متطلب أكاديمي يُسلَّم وينتهي، بل يجب أن يُولد من ضمير الباحث، من إحساسه بأن العلم أمانة، وأن كل فكرة لم تُترجم إلى أثرٍ في الحياة، تبقى ناقصة. إننا بحاجة إلى أن يُغيّر الطلاب وأعضاء هيئة التدريس نظرتهم إلى البحث، لا كمهمة تخرّج، بل كرسالة إصلاحٍ ووعي ومسؤولية. فالأوراق لا تخلّد صاحبها، إنما يخلّده ما أحدثه فكره في الناس من تغيير ونفع وبصيرة.
ولن يتحقق التجسير الحقيقي بين الجامعة والمجتمع ما لم يُمنح طلاب الماجستير المتفوقون دورًا حيويًا داخل المؤسسة الأكاديمية. ينبغي تشغيلهم وفق نظام 'الجرايات الجامعية'، بحيث يصبح الطالب المتميّز مرافقًا علميًا لأستاذه، يتعلّم منه بالممارسة، لا بالمحاضرة فقط. يتولى هذا الطالب مهامًا مساندة في البحث والتصحيح وتنظيم الأنشطة الأكاديمية، لكنه في الوقت نفسه يُكلّف بالتواصل مع فئات من المجتمع المحلي: المستشفيات، البلديات، المراكز المجتمعية، والمدارس، ليكون حلقة وصل حقيقية بين الجامعة واحتياجات الناس.
بهذه المنظومة، لا نمنح الطالب خبرة عملية فحسب، بل نُعيد إليه شعوره بالجدوى والانخراط، ونُنشئ كوادر مؤهلة لتكون نواة لأعضاء هيئة تدريس في المستقبل، كما نُخفف من نسب البطالة بين الخريجين، ونُعزز جسور الثقة بين الجامعة وبيئتها الحاضنة، فلا تبقى المعرفة في القاعات، بل تمشي في الأسواق والمصانع والمستشفيات.
لقد شهدنا في الأردن نماذج مشرّفة لهذا الربط بين الجامعة والواقع، منها مبادرة في إحدى كليات التمريض، حين قامت طالبات الماجستير بإعداد دراسات تطبيقية في مستشفيات المحافظات حول تحسين رعاية كبار السن، وتم اعتماد نتائج هذه الدراسات لتعديل بروتوكولات الرعاية في بعض الأقسام. لم تُنشر الأبحاث فقط، بل غيّرت أسلوب العمل، وحَسّنت حياة الناس. هذا هو البحث حين ينزل من برجه العاجي إلى سرير المريض، أو إلى منبر المسجد، أو إلى طاولة صانع القرار.
إننا لا نطالب بالانسلاخ من المعايير الأكاديمية، ولا بالتقليل من شأن النشر العلمي، ولكننا نطالب بأن يُعاد للبحث معناه الإنساني، وأن تعود الجامعة إلى صورتها الأولى: مرآة تعكس حاجات المجتمع، لا مرصدًا يُحصي أوراقه.
حين يتصل العقل الجامعي بالشارع، والمصنع، والمستشفى، والمسجد، تبدأ دورة الحياة من جديد. فالعلم إذا لم يُشعل نورًا في حياة الناس، لم يكن علمًا، بل صدى بلا أثر.