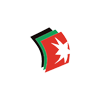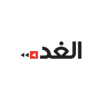اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة مدار الساعة الإخبارية
نشر بتاريخ: ٤ أيار ٢٠٢٥
في قلب المشرق العربي، يقف الأردن كدولة ذات خصوصية جغرافية وسياسية مميزة، محاطة بتحديات إقليمية حادة، ومجتمع متعدد المشارب الدينية والثقافية. في هذا السياق، تبرز الإيديولوجيات الدينية كقوة فاعلة في تشكيل الخطاب الاجتماعي والسياسي. والسؤال المحوري هنا: كيف يمكن التعامل مع هذه الإيديولوجيات بما يحفظ الاستقرار ويضمن التعددية دون الوقوع في براثن التطرف أو الإقصاء؟الإيديولوجيا الدينية في جوهرها ليست مجرد تعبير عن المعتقد، بل هي منظومة فكرية تُسقط النصوص المقدسة على الواقع السياسي والاجتماعي. في الأردن، تندرج تحت هذا المفهوم تيارات متعددة، من الحركات السلفية إلى الإخوان المسلمين، مرورًا بجماعات صوفية وشعبية. هذه التيارات تتنوع في موقفها من الدولة الحديثة، من الانخراط السياسي إلى الرفض الصريح لمفهوم 'الدولة القُطرية'.من المنظور الفلسفي، يمكن النظر إلى هذه الإيديولوجيات كامتداد لـ'سؤال المعنى' الذي يطرحه الإنسان في مواجهة العالم الحديث: ما الذي يمنح الحياة قيمتها؟ كيف يمكن العيش بنزاهة وسط عالم مادي متحول؟ الدين هنا ليس فقط إجابة روحانية، بل مشروع اجتماعي يُراد به إعادة ترتيب العالم وفق 'رؤية أخلاقية كلية'.الدولة الأردنية وجدت نفسها أمام خيارين متناقضين:- الأول، العلمنة الكاملة للحياة السياسية، كما شهدته تجارب غربية، وهو خيار محفوف بالمخاطر في مجتمع محافظ.- الثاني، الانفتاح الكامل على التيارات الدينية، ما قد يؤدي إلى زعزعة التوازنات المدنية وتكريس الاستقطاب.لكن الأردن – كما تظهر التجربة – اختار طريق 'التوفيق'، عبر اعتماد الدين كمرجعية أخلاقية عامة، دون السماح له بأن يتحول إلى أداة سياسية كاملة. يظهر هذا في ضبط منابر المساجد، وتحجيم الخطاب المتطرف، وفي ذات الوقت، فتح المجال للهوية الإسلامية المعتدلة ضمن إطار الدولة.مع صعود تيارات متطرفة في الإقليم، كان لا بد من مواجهة خطر تسرب تلك الإيديولوجيات إلى الداخل. لكن المفارقة أن مواجهة التطرف لا تتم فقط عبر الأمن، بل عبر الفلسفة. نعم، الفلسفة. لأن ما يغري الشباب بالخطابات المتطرفة هو بالضبط غياب سرديات بديلة للمعنى والكرامة والعدالة.وهنا تبرز الحاجة إلى 'فلسفة دينية حديثة'، تقدم فهمًا جديدًا للدين، لا ينفي الإيمان، ولا يؤسسه على الخوف، بل على العقل والحوار والحرية. لا بد من أن تتبنى الدولة مشروعًا ثقافيًا نقديًا، يتيح للناس أن يفهموا دينهم كوسيلة للتحرر لا كأداة للهيمنة.ربما تكون الفلسفة السياسية الأنسب لوصف الحالة الأردنية هي 'الواقعية الأخلاقية'، حيث تسعى الدولة للحفاظ على التوازن بين ضرورات الأمن ومتطلبات الروح. لكن المستقبل يتطلب أكثر من توازن هش. إنه يتطلب صياغة عقد اجتماعي جديد، تعاد فيه صياغة العلاقة بين المواطن والدين والدولة.هذا العقد لا يعني إقصاء الدين، بل إخراجه من قبضة الأيديولوجيا، ورده إلى مجاله الأصيل: الوجدان، الضمير، الأخلاق. وهذا يقتضي دعم خطاب ديني تنويري، يقرأ النصوص في سياقها، ويعيد الاعتبار للعقل والحرية كقيم جوهرية في الدين.التعامل مع الإيديولوجيات الدينية في الأردن لا يجب أن يكون فقط مسألة سياسية، بل فلسفية أيضًا. فالصراع ليس فقط بين الدولة والمتطرفين، بل بين رؤيتين للإنسان: إنسان يُقاد بالخوف، وإنسان يُقاد بالمعنى. وما يحتاجه الأردن اليوم هو إعادة فتح هذا النقاش، وإبقاء الأردن عصي عن الهيمنات الأيدولوجية.
في قلب المشرق العربي، يقف الأردن كدولة ذات خصوصية جغرافية وسياسية مميزة، محاطة بتحديات إقليمية حادة، ومجتمع متعدد المشارب الدينية والثقافية. في هذا السياق، تبرز الإيديولوجيات الدينية كقوة فاعلة في تشكيل الخطاب الاجتماعي والسياسي. والسؤال المحوري هنا: كيف يمكن التعامل مع هذه الإيديولوجيات بما يحفظ الاستقرار ويضمن التعددية دون الوقوع في براثن التطرف أو الإقصاء؟
الإيديولوجيا الدينية في جوهرها ليست مجرد تعبير عن المعتقد، بل هي منظومة فكرية تُسقط النصوص المقدسة على الواقع السياسي والاجتماعي. في الأردن، تندرج تحت هذا المفهوم تيارات متعددة، من الحركات السلفية إلى الإخوان المسلمين، مرورًا بجماعات صوفية وشعبية. هذه التيارات تتنوع في موقفها من الدولة الحديثة، من الانخراط السياسي إلى الرفض الصريح لمفهوم 'الدولة القُطرية'.
من المنظور الفلسفي، يمكن النظر إلى هذه الإيديولوجيات كامتداد لـ'سؤال المعنى' الذي يطرحه الإنسان في مواجهة العالم الحديث: ما الذي يمنح الحياة قيمتها؟ كيف يمكن العيش بنزاهة وسط عالم مادي متحول؟ الدين هنا ليس فقط إجابة روحانية، بل مشروع اجتماعي يُراد به إعادة ترتيب العالم وفق 'رؤية أخلاقية كلية'.
الدولة الأردنية وجدت نفسها أمام خيارين متناقضين:
- الأول، العلمنة الكاملة للحياة السياسية، كما شهدته تجارب غربية، وهو خيار محفوف بالمخاطر في مجتمع محافظ.
- الثاني، الانفتاح الكامل على التيارات الدينية، ما قد يؤدي إلى زعزعة التوازنات المدنية وتكريس الاستقطاب.
لكن الأردن – كما تظهر التجربة – اختار طريق 'التوفيق'، عبر اعتماد الدين كمرجعية أخلاقية عامة، دون السماح له بأن يتحول إلى أداة سياسية كاملة. يظهر هذا في ضبط منابر المساجد، وتحجيم الخطاب المتطرف، وفي ذات الوقت، فتح المجال للهوية الإسلامية المعتدلة ضمن إطار الدولة.
مع صعود تيارات متطرفة في الإقليم، كان لا بد من مواجهة خطر تسرب تلك الإيديولوجيات إلى الداخل. لكن المفارقة أن مواجهة التطرف لا تتم فقط عبر الأمن، بل عبر الفلسفة. نعم، الفلسفة. لأن ما يغري الشباب بالخطابات المتطرفة هو بالضبط غياب سرديات بديلة للمعنى والكرامة والعدالة.
وهنا تبرز الحاجة إلى 'فلسفة دينية حديثة'، تقدم فهمًا جديدًا للدين، لا ينفي الإيمان، ولا يؤسسه على الخوف، بل على العقل والحوار والحرية. لا بد من أن تتبنى الدولة مشروعًا ثقافيًا نقديًا، يتيح للناس أن يفهموا دينهم كوسيلة للتحرر لا كأداة للهيمنة.
ربما تكون الفلسفة السياسية الأنسب لوصف الحالة الأردنية هي 'الواقعية الأخلاقية'، حيث تسعى الدولة للحفاظ على التوازن بين ضرورات الأمن ومتطلبات الروح. لكن المستقبل يتطلب أكثر من توازن هش. إنه يتطلب صياغة عقد اجتماعي جديد، تعاد فيه صياغة العلاقة بين المواطن والدين والدولة.
هذا العقد لا يعني إقصاء الدين، بل إخراجه من قبضة الأيديولوجيا، ورده إلى مجاله الأصيل: الوجدان، الضمير، الأخلاق. وهذا يقتضي دعم خطاب ديني تنويري، يقرأ النصوص في سياقها، ويعيد الاعتبار للعقل والحرية كقيم جوهرية في الدين.
التعامل مع الإيديولوجيات الدينية في الأردن لا يجب أن يكون فقط مسألة سياسية، بل فلسفية أيضًا. فالصراع ليس فقط بين الدولة والمتطرفين، بل بين رؤيتين للإنسان: إنسان يُقاد بالخوف، وإنسان يُقاد بالمعنى. وما يحتاجه الأردن اليوم هو إعادة فتح هذا النقاش، وإبقاء الأردن عصي عن الهيمنات الأيدولوجية.